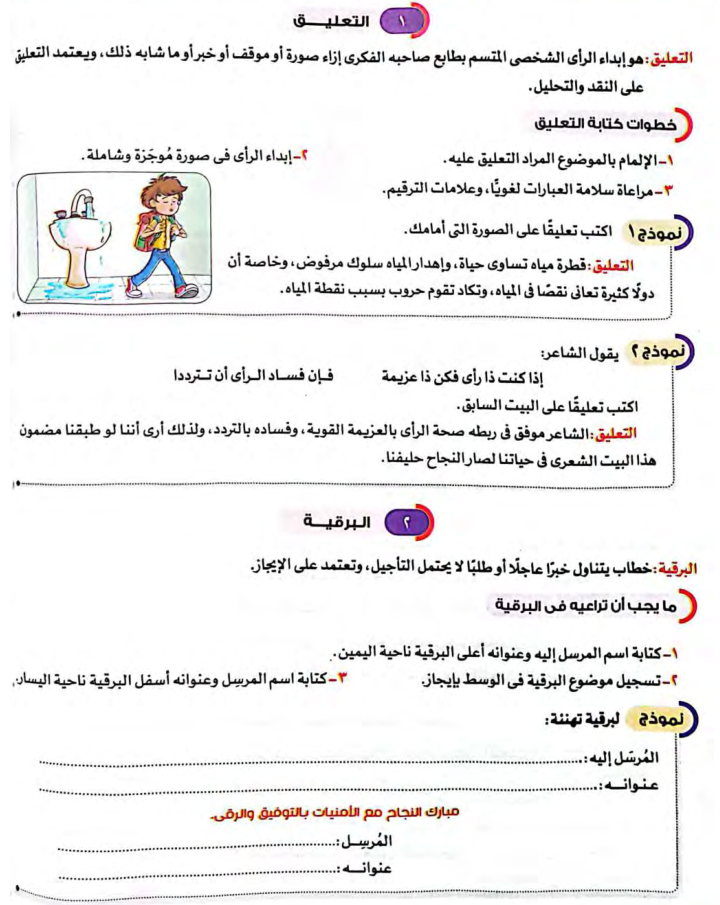علم الإنشاء فن الكتابة وصنعة الكتبة ولغة الدواوين وفن إخراج الأدبيات
علم الإنشاء هو فرع من فروع اللغة العربية، يختص بدراسة قواعد كتابة الجمل والفصول والمقالات بطريقة صحيحة وواضحة.
يشمل علم الإنشاء عدة مجالات، منها:
المجالات الرئيسية
1. *التركيب*: دراسة كيفية تركيب الجمل من الكلمات.
2. *السياق*: دراسة العلاقة بين الجمل في الفقرة أو المقالة.
3. *النحو*: دراسة قواعد اللغة العربية.
4. *الصرف*: دراسة أشكال الكلمات وتصريفها.
القواعد الأساسية
1. *الجملة*: تتكون من مبتدأ وخبر.
2. *الفقرة*: تتكون من جمل متصلة بالسياق.
3. *المقالة*: تتكون من فقرات متصلة بالسياق.
4. *الجمل الأساسية*: جمل اسمية، جمل فعلية، جمل حرفية.
5. *العلاقات بين الجمل*: العلاقة الزمنية، العلاقة السببية، العلاقة الإيجابية.
أنواع الإنشاء
1. *الإنشاء اللفظي*: يتعلق بالحوار والكلام.
2. *الإنشاء الكتابي*: يتعلق بالكتابة.
3. *الإنشاء العلمي*: يتعلق بالكتابة العلمية.
4. *الإنشاء الأدبي*: يتعلق بالكتابة الأدبية.
الأهمية
1. *تحسين الكتابة*: يساعد على تحسين مهارات الكتابة.
2. *التعبير الصحيح*: يساعد على التعبير عن الأفكار بشكل صحيح.
3. *التواصل الفعال*: يساعد على التواصل الفعال.
4. *التعلم*: يساعد على تعلم المواد الأخرى.
علم الإنشاء الوظيفي_التعبير الوظيفي_
1. *التركيب الوظيفي*: دراسة كيفية تركيب الجمل والنصوص الوظيفية.
2. *السياق الوظيفي*: دراسة العلاقة بين الجمل والنصوص في الوثائق الرسمية.
3. *النحو الوظيفي*: دراسة قواعد اللغة العربية في النصوص الوظيفية.
4. *الصرف الوظيفي*: دراسة أشكال الكلمات وتصريفها في النصوص الوظيفية.
القواعد الأساسية
1. *الوضوح*: كتابة النصوص بوضوح ودقة.
2. *الترتيب*: ترتيب الجمل والنصوص بطريقة منطقية.
3. *التسلسل*: استخدام التسلسل الزمني والسببي.
4. *التوجيه*: توجيه النصوص إلى الجمهور المستهدف.
5. *الاحترام*: استخدام الأسلوب الاحترامي في النصوص الرسمية.
أنواع الإنشاء الوظيفي
1. *الإنشاء الرسمي*: الرسائل الرسمية، التقارير، والمستندات.
2. *الإنشاء التجاري*: الرسائل التجارية، العروض، والاتفاقيات.
3. *الإنشاء الإداري*: الرسائل الإدارية، التوجيهات، والقرارات.
4. *الإنشاء القانوني*: الصكوك القانونية، العقود، والاتفاقيات.
الأهمية
2. *التعبير الصحيح*: يساعد على التعبير عن الأفكار بشكل صحيح.
3. *التواصل الفعال*: يساعد على التواصل الفعال في العمل.
4. *الاحتراف*: يساعد على تحقيق الاحتراف في الكتابة الوظيفية.
كالإنشاء الصحافي والإنشاء المدرسي والإنشاء الموسوعي والإنشاء الإلكتروني والرقمي _الأوفيس😃_ والإنشاء الإعلامي والإنشاء الفني "سيناريو والحوار😍" والإنشاء الموسيقي "النوتة🎸🎶🎵🎼🎤"
والإنشاء البرمجي _أكواد السكريبتات كالفيجول ⌨🖱💻"_
والإنشاء العسكري _كالبيان والإحداثيات أوسيناريو التكتيكات أو سجلات ومحرارات _ ... والإنشاء المخابراتي "شكراً لحسن تعاونكم معنا😆😁😋😁😉" تقنيات التشفير اللغوي والغير لغوي_🔇🎹
وكل ما شابه من قوالب وسياقات ومخطوطات مثل:
الفورم "تصميم نمطي":البرقية/الرسالة/التقرير/دعوة/سيرة/الإقرار/الوصية....
البطاقات: التقييم /التشخيص/الإتقان/ التوصيف....
الجداول: المناظرة/المقارنات/ الموازنات/الكشوفات/الإعراب.....
التشجير:التوضيحي/انساب/ذهنية/منطق/خط سير......
رسوم وأشكال:تعبيرية/ساخرة/كاريكاتور /اشارات/رموز.....
متنوع التسطير:محاضر/دعاوي/مذكرات/شكاوي....
وعلم الإنشاء الإبداعي _التعبير الإبداعي😎😆_
الإنشاء الإبداعي :هو عملية إنشاء وتحرير أعمال فكرية مبدعة أو أجناس أدبية"شعرية كانت أو نثرية" وفق المعايير الفنية والأصول العلمية وقواعد العلوم العربية الآلية وخصائص المذاهب الأدبية البنَّاءة👌😍.
أو بمعنى آخر هو عملية إنتاج وتصدير جنس أدبي بطريقة فنية وعلمية وبأسلوب راقي وشيق ويحترم الذوق الأدبي مع مراعاة قاعدة الإنشاء في الوضوح واللباقة وجلاء الفكرة وتنوير العقول وتعزيز الأخلاقية الحميدة.
يمكن أن نقول هو فن إخراج جنس أدبي إحترافي رائع👌🖒.
*****
شعرية مثل: القصائد /الدواوين/ الأغاني/ الموشحات..إلخ
أونثرية مثل:المقال/الرواية/القصة القصيرة/ المسرحية....إلخ
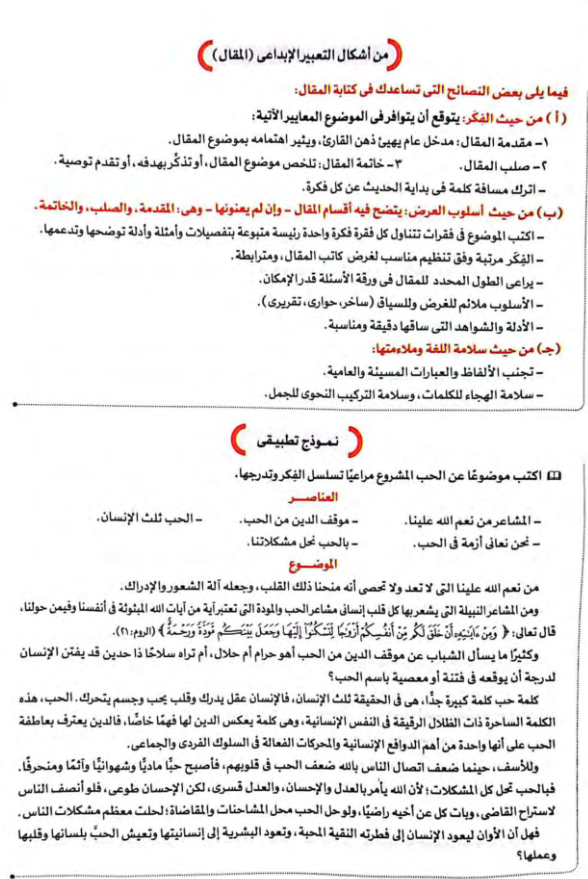 |
- اللغة والإنشاء في عصر صدر الإسلام
وكان لظهور الإسلام تأثير كبير في اللغة العربية وأساليبها وألفاظها لتشرب قرائح المسلمين روح القرآن، وحفظهم كلامه وإعجابهم به، وطبيعي أن الكاتب تتكيف ملكة اللغة فيه على مقتضى محفوظه من أشعارها وأمثالها وأساليبها، فلا غرو إذا ظهرت أساليب القرآن وألفاظه في لغة المسلمين: شعرًا ونثرًا، كتابة وخطابة، ويرجع ذلك التغيير إلى قسمين: تغيير في الأسلوب، وتغيير في الألفاظ.
(١) التغيير في الأسلوب
أما الأسلوب الإنشائي فلا يمكننا تعيين مقدار التغيير الذي أصابه إلا بالرجوع إلى ما وصلنا من إنشاء الجاهليين، والفرق بينه وبين أسلوب القرآن كالفرق بين الثريا والثرى … أين قول طريفة كاهنة اليمن حين خاف أهل مأرب سيل العرم وعليهم مزيقياء عمرو بن عامر، فإنها قالت لهم: «لا تؤموا مكة حتى أقول وما علمني ما أقول إلا الحكم المحكم رب جميع الأمم من عرب وعجم إلخ» من أساليب القرآن؟
وتولد في صدر الإسلام ضرب من الإنشاء من أبلغ ما يكون، وأحسن الأمثلة عليه مخاطبات الخلفاء والقواد، وكلها من السهل الممتنع … ككتاب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص لما بعث به إلى فتح مصر، ثم تخوف فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من الخليفة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركاته، أما بعد فإن أدركك كتابي هذا وأنت لم تدخل مصر فارجع عنها، وأما إذا أدركك وقد دخلتها أو شيئًا من أرضها … فامض واعلم أني ممدك».
وكتب ابن الخطاب إلى ابن العاص يستنجده في مجاعة بقوله: «من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاص سلام، أما بعد فلعمري يا عمرو ما تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن أهلك أنا ومن معي فيا غوثاه ثم يا غوثاه» فكتب إليه عمرو: «إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص، أما بعد فيا لبيك ثم يا لبيك، قد بعثت إليك بِعيرٍ أولها عندك وآخرها عندي والسلام».
ذلك أسلوبهم فيما يكتبونه أو يقولونه من المخابرات السياسية أو الخطب الحماسية أو العهود أو العقود … حتى إنك إذا قرأت لهم رسالة تبينت أسلوب صدر الإسلام فيها، فيهون عليك التفريق بين الصحيح والموضوع منها …
وتجد أمثلة من المخابرات السياسية والخطب ونحوها على أسلوب صدر الإسلام في كتب الفتوح والغزوات، كفتوح الشام للواقدي، وفتوح البلدان للبلاذري، ومنها جانب كبير في خطط المقريزي عن فتوح مصر، وتجد معظمها مجموعًا في كتاب فتوح الشام للشيخ أبي إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي البصري من أهل أواسط القرن الثاني للهجرة طُبع في كلكته سنة ١٨٥٤، وقد شاهدنا فيه ما لم نشاهده في غيره مما وصل إلينا من كتب الفتح … فإنه عبارة عن مجموع المخابرات السياسية أو الأوامر الرسمية التي جرت بين الخلفاء الراشدين وقوادهم أو ما تكاتب به القواد أو ما كتبوه إلى كبراء الروم وغيرهم، أو ما عقدوه من العهود في أثناء حروبهم في الشام إلى فتحها وفتح أجنادها … كأنها الأصول التي أخذت أخبار الفتح عنها.
(٢) التأثير في الألفاظ
أما تأثير القرآن الكريم في ألفاظ اللغة فضلًا عن الأسلوب، فظاهر فيما دخلها من الألفاظ الإسلامية مما اقتضاه الإصلاح الديني أو الشرعي، وأكثر هذه الألفاظ كانت موجودة في اللغة قبل الإسلام، لكنها كانت تدل على معانٍ أخرى فتحولت للدلالة على ما يقاربها من المعاني الجديدة، فلفظ «مؤمن» مثلًا كان معروفًا في الجاهلية، ولكنه كان يدل عندهم على الأمان أو الإيمان وهو التصديق … فأصبح بعد الإسلام يدل على المؤمن وهو غير الكافر، وله في الشريعة شروط معينة لم تكن من قبل، وكذلك المسلم والكافر والفاسق ونحوها، ومما حدث من المصطلحات الشرعية الصلاة وأصلها في العربية الدعاء، وكذلك الركوع والسجود والحج والزكاة … فقد كان لهذه الألفاظ وأشباهها معانٍ تبدلت بالإسلام وتنوعت.
وقس على ذلك المصطلحات الفقهية، كالإيلاء والظهار والعدة والحضانة والنفقة والإعتاق والاستيلاد والتعزير واللقيط والآبق والوديعة والعارية والشفعة والفرائض والقسامة وغيرها.
وفي كتابنا «تاريخ اللغة العربية» بحث ضاف فيما دخل اللغة من الألفاظ والأساليب قبل الإسلام وبعد
الإنشاء والترسل
تمكَّنت الحضارة من أسلوب الترسل في هذا العصر — ونعني بالترسل إنشاء المراسلات على الخصوص. «ويريدون به معرفة أحوال الكاتب والمكتوب إليه من حيث الأدب والمصطلحات الخاصة الملائمة لكل طائفة.» وهو الذي يتغيَّر مع الأعصر كما بيَّنَّا ذلك في كلامنا عن الإنشاء في العصر الماضي، ويشتمل على المراسلات والخطب ومقدمات الكتب؛ لأن أساليبها متشابهة، أما إنشاء الكتب، أي عبارة المؤلفات التاريخية والعلمية التي يراد بها تقرير الحقائق بغير إرهاب أو تهديد أو تنبيه أو تحريض فهذه قلَّمَا يعتوِرُها تغيير؛ لأن تقرير الحقائق العلمية أو التاريخية قلَّمَا تؤثِّر فيه الانفعالات النفسية؛ فهو أقل مجاراة للأحوال الاجتماعية؛ ولذلك رأيت عبارة البلغاء من المؤلِّفين متشابهة يندر الاختلاف فيها — إلا في ما يختص بنفس الكاتب وأسلوب تفكيره وموضوع كتابه؛ إذ إن لكل كاتب طريقة يعبرون عنها بالذوق، ولكل فن مصطلحات خاصة تجعل للكتابة فيه نسقًا خاصًّا. فعبارة الفقيه تختلف عن عبارة المؤرخ، وهذه تختلف عن عبارة الحكيم أو الرياضي، وقد يختلف أسلوب المؤلف الواحد باختلاف الموضوع الذي يكتب فيه، ولكنها ترجع كلها إلى أسلوب خاص يختلف عن أسلوب الترسل.
والكاتب في المواضيع العلمية لا يزال على أسلوب المؤلفين المتناسق المرسل، حتى يقتضي الموضوع مخاطبة القارئ فينتقل إلى أسلوب الترسل بالتسجيع أو نحوه حسب العصور، فإذا فرغ من الخطاب عاد إلى الإنشاء المرسل البسيط — إلا طائفة من المؤلفين أرادوا زيادة التأنُّق في مؤلفاتهم، فجعلوا عباراتها كلها مسجعة، وذلك نادر، وسنعود إلى الكلام فيه.
(١) أسلوب الترسل
لما كان المراد بالمراسلات والخطب التعبير عن العواطف والأميال وسائر الأحوال، وهذه تختلف في الناس باختلاف آدابهم الاجتماعية وأحوالهم الأدبية، وهي تتغير بتغيُّر الأحوال. كان الترسل أكثر تعرضًا للتغيير في أسلوبه وعبارته، وهو ما نريد بيانه هنا.
يغلب أن يكون لكل عصر إمام في إنشاء المراسلات يتحدَّاه معاصروه، كذلك كان عبد الحميد وابن المقفع في العصر العباسي الأول، والجاحظ في العصر الثاني، وأما إمام الإنشاء في هذا العصر، فهو ابن العميد لأسباب سنبيِّنها في ترجمة حاله. وقد رأيت ما أصاب هذا الإنشاء في العصر الماضي على يد الجاحظ وأصحابه من تقطيع العبارة، وإدخال الدعاء فيها بصيغة المخاطب بغير اشتراط السجع أو التقفية، وعلمت ما يمتاز به هذا العصر من التوسُّع بأسباب الحضارة والترف، نعني ما صار إليه الأدباء والمنشئون من التبسُّط في العيش عن سعة ورخاء، لا يخافون مزاحمةً أو فقرًا لتعدد مصادر الارتزاق في دور الأمراء والوزراء والخلفاء، فإذا خافوا سبقًا في بلاط نزحوا إلى سواه، والرخاء يدعو إلى التأنُّق، فتطرَّق ذلك إلى إنشائهم، فصاروا يتأنَّقون فيه كما يتأنَّقون بلباسهم وطعامهم وأثاثهم، فأطالوا العبارة وتوسعوا في التنميق، ونبغ جماعة من أصحاب القرائح تساعدوا على ذلك حتى صار للإنشاء في هذا العصر طريقة اتخذها أهل العصور التالية نموذجًا نسجوا على منواله، وهي الطريقة المدرسية في اصطلاح الإفرنج (كلاسيك)، وبعبارة أخرى إن الطريقة المدرسية للترسل العربي نضجت في هذا العصر كما نضج الإنشاء الروماني في عصر شيشرون ثم أخذ في التقهقر، وهكذا أصاب الإنشاء العربي بعد هذا العصر كما ستراه في مكانه. وللطريقة المدرسية في الإنشاء العربي شروط هاك أهمها:
(١-١) شروط الطريقة المدرسية في الإنشاء العربي
- (١)
السجع: أصبح التسجيع شرطًا من شروط الترسل، وهو من ثمار التأنُّق لما يقتضيه من العناية في إتقانه، فالرسالة المسجعة يظهر التأنق فيها أكثر من غير المسجَّعة، وتدل من جهة أخرى على تفرُّع صاحبها للتنميق، ولا يكون ذلك إلا في الرخاء. والسجع إذا أُتقنت صياغته أكسب المعنى قوة، وقد أتقنه بلغاء العصر الثالث فرغب الناس فيه وتسابقوا إليه، لكن بعض معاصريهم من أدعياء هذا الفن كلفوا به عن غير مقدرة عليه فجاء باردًا، ومما يروى من هذا القبيل وفيه فكاهة أن الخاقاني الوزير كان يحب السجع حتى استخدمه في التوقيع على كتب العمال، فوقَّع مرة: «الزم — وفقك الله — المنهاج، واحذر عواقب الاعوجاج، واحمل ما أمكن من الدجاج إن شاء الله.» فحمل العامل دجاجًا كثيرًا على سبيل الهدية، فقال: «هذا دجاج وفرته بركة السجع.» وأمر أن يباع ويورد ثمنه في الحساب فأورد منسوبًا إلى ثمن دجاج السجع.
- (٢)
الجناس والبديع: وأكثروا من الجناس وهو من قبيل الترصيع للآنية أو الوشي للثوب. لا يزيد الوشي الثوب نفعًا للابسه من حيث الغرض المراد منه كالدفء والستر، ولكنه يزيده جمالًا، والجناس أو البديع لا يزيد العبارة معنًى لكنه يكسبها رونقًا، ولا سيما مع السجع، فقول أبي بكر الخوارزمي في كتابه إلى نائب الوزير ابن عباد: «كتبت إلى الأستاذ معاتبًا مرة، ومستعتبًا كرة، فما وجدت للعتاب أعتابًا، ولا قرأت من الكتاب جوابًا، وليت شعري ما الذي منعه عن صلة لا تضره وتنفعني، وعن تواضع لا يضعه ويرفعني؟» لو جعله مرسلًا بسيطًا لم يكن له ذلك الوقع في النفس.
- (٣)
كثر فيه الخيال الشعري حتى أصبح سجعهم كالشعر المنثور، لكنه مقفًّى فلا يعوزه غير الوزن ليصير شعرًا.
- (٤)كثر تضمين مراسلاتهم الأمثال أو النكت الأدبية أو العبارات التاريخية أو العلمية التي تحتاج إلى شرح، كقول ابن العميد في رسالة إلى أبي العلاء السروي:
وأحمد الله على كل حال، وأساله أن يعرِّفني فضل بركته، ويلقيني الخير في باقي أيامه وخاتمته، وأرغب إليه في أن يقرب على القمر دوره ويقصر سيره، ويخفف حركته، ويعجل نهضته، وينقص مسافة فلكه ودائرته، ويزيل بركة الطول من ساعاته، ويرد عليَّ غرة شوال فهي أسرُّ الغرر عندي وأقرُّها لعيني، ويسمعني النعرة في قفا شهر رمضان، ويعرض عليَّ هلاله أخفى من السر، وأظلم من الكفر، وأنحف من مجنون بني عامر، وأضنى من قيس بن ذريح، وأبلى من أسير الهجر، ويسلط عليه الحور بعد الكور، ويرسل علي رقاقته التي يغشى العيون ضوءُها، ويحط من الأجسام نوءُها كلفًا يغمرها وكسوفًا يسترها … إلخ.
- (٥)
أكثروا فيه من الاستشهاد بالأشعار في أثناء مراسلاتهم، وهو ترصيع جميل يزيد المعنى طلاوة ووضوحًا، ويكسبه قوة على إبداء ما في خاطر الكاتب. وقد بالغ بعضهم في ذلك الترصيع حتى أصبح الشعر فيه أكثر من النثر، كقول الصاحب بن عباد يصف فصلًا من كتب ابن العميد قال: «فصل رأيته فصيح الإشارة لطيف العبارة:
إذا اختصر المعنى فشربة حائمٍوإن رام إسهابًا أتى الفيض بالمدفصل قد نظرته فرأيته جسمًا معتدلًا وفهمًا مشتعلًا:
ونفسًا تفيض كفيض الغمامِوظرفًا يناسب صفو المذامِفصل قد عمهم بنعمه وغمرهم بشيمه:
وغزاهمُ بسوابغٍ من فضلهجعلت جماجمهم بطائن نعله.» إلخ.وتفنن آخرون بجعل الترصيع شطرًا شطرًا كقول الهمذاني من رسالة إلى الخوارزمي:
أنا لقرب دار الأستاذكما طرب النشوان مالت به الخمرومن الارتياح للقائهكما انتفض العصفور بلله القطرُومن الامتزاج بولائهكما التقت الصهباء والبارد العذبُومن الابتهاج بمزارهكما اهتز البارح الغصن الرطبُ - (٦)
صار للرسائل نمط خاص تراه ممثلًا في رسائل أبي بكر الخوارزمي وأبي منصور الثعالبي وأمثالهما من كُتَّاب ذلك العصر، فالرسالة تبدأ غالبًا بمخاطبة المرسل إليه بلقبه أو نعته بعد الإشارة إلى كتابه، ويتلو ذلك مخاطبته بصيغة الغائب كقولهم: «ورد كتاب الأمير يأمرني فيه بكذا وكذا … إلخ.» وقولهم: «قد حملت إلى حضرة الشيخ أبياتًا عاتبته بها.» وهو يريد الشيخ المخاطب. وقد يأتي اللقب مشفوعًا بالدعاء بصيغة الغائب أيضًا كقول أبي بكر الخوارزمي في كتاب إلى محمد بن إبراهيم صاحب الجيش، وكان محبوسًا وخرج من الحبس: «كتبت أيد الله صاحب الجيش، وقد خرجت من تلك الأهوال خروج المشرفي من الصقال … إلخ.» وقد يجعلون الخطاب بصيغة المخاطب في بعض الأحوال.
- (٧)
تفرع الترسل إلى أبواب عملًا بسنة النشوء كما تفرَّع الشعر، فصارت الرسائل تقسم إلى رسائل التهنئة والتعزية والمديح والرثاء وإلى الإخوانيات والسلطانيات ونحو ذلك.
- (٨) تمتاز مقدمات الكتب أو خطبها بتقديم الحمدلة والصلاة على النبي، وتختم بآية يحسن الختام بها كقولهم: وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِالله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، أو بالحسبلة ونحوها.
- (٩)
اختصاص كل طبقة من الوجهاء ورجال الدولة بنعوت خاصة بها، فإن تفاوت رجال الدولة بالمنزلة والنفوذ اقتضى أن تتفاوت أساليب مخاطباتهم، واستقر ذلك على وجه معين في العصر العباسي الثالث، فأصبح عندهم لكل طبقة من رجال الدولة نعوت تفتتح بها مخاطباتهم وعبارات تعنون بها كتبهم وأدعية يدعون بها لهم، كقولهم في مخاطبة أولاد الخليفة في زمن المقتدر بالله: «أطال الله بقاء الأمير.» ولمؤنس المظفر: «أطال الله بقاءك وأعزك وأكرمك وأتمَّ نعمته وإحسانه إليك.» والعنوان «لأبي الحسن أطال الله بقاءه.» ولصاحب اليمن ونحوه: «أكرمك الله ومدَّ في عمرك وأتم نعمته عليك وأدامها لك.» وقس عليه.
- (١٠)
صار الإنشاء فنًّا له ألفاظ خاصة سموها الألفاظ الكتابية لا يتجاوزونها إلى سواها، وتولَّدت فيه مصطلحات خاصة لأساليبه وعباراته كالتسجيع والترصيع والتضريس والتبديل والمكافأة والاستعارة والتتميم والتقسيم والإرداف والتمثيل والمعاظلة والتكرير وغيرها، ولكل منها غرض في الإنشاء.
هذه أهم شروط الإنشاء في العصر العباسي الثالث، وقد سميناها الطريقة المدرسية؛ لأنها صارت مثالًا توخَّاه الكتاب في سائر العصور الإسلامية، وقد طرأ عليها تغيير اقتضاه حال الاجتماع سنذكره في مكانه.
ومما لا بد من التنبيه إليه أن ما يجري عليه الكتاب من تحدي القدماء في مذاهبهم وتقليد أساليبهم لاعتقادهم أن ملكة الإنشاء إنما ترسخ بمطالعة كتب القدماء وأشعارهم بعث على تعدد الأساليب في العصر الواحد، فينبغ في العصر الثالث مثلًا كتاب يتحدون أسلوب الجاحظ، وآخرون يقلِّدون أسلوب المقفع أو عبد الحميد أو أسلوب صدر الإسلام، ويصدق ذلك على سائر العصور، ولكن يغلب في أهل العصر الواحد أن يخضعوا لما تقتضيه المجاري الاجتماعية؛ فيكون لإنشائهم صبغة خاصة به.
(٢) المنشئون أو المترسلون
تكاثر المنشئون في هذا العصر مثل تكاثُر الشعراء، واشتهر بعضهم بالصناعتين جميعًا حتى لقد تتولَّاك الحيرة في جعل أحدهم من الكُتَّاب أو من الشعراء، واشتهر من المترسِّلين في العصر طائفة من الوزراء والكبراء ورجال الدولة شرفت بهم الصناعة، وارتفعت قيمتها؛ لأنهم كانوا عمدتها ووجوه كُتَّابها، بل هم أقوى أركان تلك النهضة في النظم والنثر وسائر أسباب العلم والأدب، وإليك أشهرهم حسب سني الوفاة:
(٢-١) ابن العميد (توفي سنة ٣٦٠ﻫ)
هو أبو الفضل محمد بن العميد، والعميد لقب والده على عادة أهل خراسان في إجرائه مجرى التعظيم. وكان ابن العميد وزير ركن الدولة الحسن بن بويه والد عضد الدولة. تولى الوزارة سنة ٣٢٨ﻫ، وكان متوسعًا في الفلسفة والنجوم فضلًا عن الأدب والترسل حتى سموه «الأستاذ»، وكان يلقب لبراعته في الترسل بالجاحظ الثاني. وقيل: بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. وكان الصاحب بن عباد من بعض أتباعه كما سيجيء. وعاد الصاحب مرة من بغداد فسأله ابن العميد عنها فقال: «بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد.» يشير إلى تفرده في العلم، وهو أسبق المنشئين إلى أسلوب ذلك العصر، وقد أجاد فيه فقلدوه ونسجوا على منواله، وساعد على شيوع طريقته رفعة منزلته وعلو كعبه في العلم. وكثيرًا ما رأينا الوجاهة من جملة أسباب الشهرة العلمية، فهي لا تجعل الجاهل مشهورًا بالعلم لكنها تجعل قليل العلم أن يشتهر بكثرته، وأخذ الصاحب بن عباد عن ابن العميد، وكان الصاحب مركزًا يدور حوله أدباء ذلك العصر فساعد ذلك على نشر تلك الطريقة.
ويدل على مناقب ابن العميد ويمثل منزلة الأدباء في ذلك العصر حادثة جرت له من ابن نباتة السعدي، وقد مدحه بقصيدة فتأخَّرت صلته فشفَّعها بأخرى وأتبعها برقعة فلم يزده ابن العميد على الإهمال مع رقة حاله التي ورد عليها إلى بابه، فتوصل إلى أن دخل عليه يومًا وهو في مجلس حفل بأعيان الدولة ومقدمي أرباب الديوان، فوقف بين يديه وأشار إليه بيده وقال: «أيها الرئيس، إني لزمتك لزوم الظل، وذللت لك ذل النعل، وأكلت النوى المحرق انتظارًا لصلتك، والله ما بي من الحرمان ولكن شماتة الأعداء وهم قوم نصحوني فأغششتهم، وصدقوني فاتهمتهم، فبأي وجه ألقاهم وبأي حجة أقاومهم، ولم أحصل من مديح بعد مديح ومن نثر بعد نظم إلا على ندم مؤلم وبأس مسقم، فإن كان للنجاح علامة فأين هي؟ وما هي إلا أن الذين نحسدهم على ما مدحوا به كانوا من طينتك وأن الذين هجوا كانوا مثلك، فزاحم بمنكبك أعظمهم شأنًا وأنورهم شعاعًا وأمدهم باعًا وأشرفهم بقاعًا.»
فحار رشد ابن العميد ولم يدر ما يقول، فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: «هذا وقت يضيق عن الإطالة منك في الاستزادة وعن الإطالة مني في المعذرة، وإذا تواهبنا ما دفعنا إليه استأنفنا ما نتحامد عليه.» فقال ابن نباتة: «أيها الرئيس هذه نفثة مصدور منذ زمان وفضلة لسان قد خرص منذ دهر، والغني إذا مطل لئيم.»
فاستشاط ابن العميد غضبًا وقال: «والله ما استوجب هذا العتب من أحد من خلق الله تعالى، ولست ولي نعمتي فأحتملك ولا صنيعتي فأغضي عليك، وإن بعض ما قررته في مسامعي ينغص مرة الحلم ويبدد شمل الصبر، هذا وما استقدمتك بكتاب ولا استدعيتك برسول ولا سألتك مدحي ولا كلَّفتك تقريضي.» فقال ابن نباتة: «صدقت أيها الرئيس ما استقدمتني بكتاب ولا استدعيتني برسول، ولا سألتني مدحك ولا كلفتني تقريضك، ولكن جلست في صدر ديوانك بأبهتك وقلت: لا يخاطبني أحد إلا بالرئاسة ولا ينازعني خلق في أحكام السياسة، فإني كاتب ركن الدولة وزعيم الأولياء والحضرة والقيِّم بمصالح المملكة، فكأنك دعوتني بلسان الحال ولم تدعني بلسان المقال.»
فثار ابن العميد مغضبًا وأسرع في صحن داره إلى أن دخل حجرته، وتقوض المجلس وماج الناس وسمع ابن نباتة وهو في صحن الدار مارًّا يقول: «والله إن سف التراب والمشي على الجمر أهون من هذا، فلعن الله الأدب إذا كان بائعه مهينًا ومشتريه مماكسًا فيه.»
فلما سكن غيظ ابن العميد وثاب إليه حلمه التمسه من الغد ليعتذر إليه ويزيل آثار ما كان منه، فكأنما غاض في سمع الأرض وبصرها ولم يقف على مكانه، فكانت حسرة في قلب ابن العميد إلى أن مات، ونسب بعضهم هذه الحادثة إلى شاعر آخر غير ابن نباتة.
وكان ابن العميد يقرب أهل الأدب والشعر، فحام حوله طائفة منهم امتدحوه كالمتنبي وابن نباتة والصاحب بن عباد وغيرهم، كانوا يجتمعون في مجلسه فيقترح عليهم النظم والمقارضة؛ وهي أن يقول أحدهم شعرًا أو بيتًا في وصف شيء أو حادثة فيتمه الآخر فالآخر.
وكان ابن العميد شاعرًا رقيقًا من أحسن شعره قصيدة قالها منها:
إلى أن قال وفيه مبالغة:
ومن قوله في الغزل:
ترى أمثلة من ترسله ونظمه في يتيمة الدهر الجزء الثالث، ولم يصلنا منه رسائل مجموعة ولا شعر على حدة.
واشتهر ابنه أبو الفتح ذو الكفايتين بعده بمثل شهرته.
وتجد أخبار ابن العميد في ابن خلكان ٥٧ ج٢، ويتيمة الدهر ٢ ج٣.
(٢-٢) أبو بكر الخوارزمي (توفي سنة ٣٨٣ﻫ)
هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الكاتب الشاعر، ويقال له أيضًا: الطبرخزي؛ لأن أباه من خوارزم وأمه من طبرستان، وهو ابن أخت محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ. وكان الخوارزمي إمامًا في اللغة والنسب، أقام بالشام مدة وسكن نواحي حلب، وكان يشار إليه في عصره، وقصد الصاحب بن عباد وهو في أرجان وجالسه وباسطه، واشتهر بكثرة حفظه للأشعار، ويحكى أنه لما جاء إلى الصاحب استأذن عليه بدون أن يذكر اسمه، فدخل عليه الحاجب وأعلمه فقال الصاحب: «قل له: قد ألزمت نفسي أن لا يدخل علي من الأدباء إلا من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب.» فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك، فقال له أبو بكر: «ارجع وقل له: هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النساء؟» فدخل الحاجب فأعاد عليه، فقال: «هذا يكون أبا بكر الخوارزمي» فأذن له في الدخول.
لم يصل إلينا من آثار أبي بكر الخوارزمي إلا مجموعة رسائل تعرف باسمه، وهي مطبوعة في مصر وفي الآستانة سنة ١٢٩٧، وفي بومباي سنة ١٣٠١ وغيرها، ومنها نسخ خطية في برلين وفينا وليدن وكوبرلي، وفي الجزء الرابع من يتيمة الدهر أمثلة كثيرة من نثره ونظمه، وفيه طائفة حسنة من المدائح والمراثي والأهاجي وطرق مختلفة، وهو غير محمد بن موسى الخوارزمي الفلكي الرياضي المعاصر للمأمون (ترجمته في ابن القفطي ١٨٧، والفهرست ٢٧٤)، وغير أبي عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي صاحب مفاتيح العلوم المتقدم ذكره.
أما أبو بكر هذا فترجمته في ابن خلكان ٥٢٣ ج١، ويتيمة الدهر ١١٤ ج٤.
(٢-٣) أبو إسحاق الصابي (توفي سنة ٣٤٨ﻫ)
هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن زهرون بن حبون الحزاني الصابي جد أبي الحسن هلال الصابي صاحب التاريخ، كان أبو إسحاق كاتب الإنشاء في بغداد عن الخليفة، وعن عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه، وتقلَّد ديوان الرسائل سنة ٣٤٩، وكانت تصدر عنه مكاتبات إلى عضد الدولة بن بويه بما يؤلمه فحقد عليه، فلما قتل عز الدولة وملك عضد الدولة بغداد اعتقله سنة ٣٦٧ﻫ، وعزم على إلقائه تحت أيدي الفيلة فشفعوا فيه، ثم أطلقه سنة ٣٧١، وكان قد أمره أن يصنف كتابًا في أخبار الدولة الديلمية، فعمل كتاب «التاجي» فقيل لعضد الدولة: إن صديقًا للصابي دخل عليه فرآه في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبييض فسأله عما يعمل فقال: «أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفِّقها.» فهاج حقده عليه ولم يزل الصابي مبعدًا في أيامه.
- (١)
منشآت الصابي: في المكاتبة الخديوية نسخة خطية بهذا الاسم تدخل في ٤٥٤ صفحة تشتمل على مراسلات كتبها الصابي على لسان ولاة الأمر في عصره من ملوك آل بويه والخلفاء وغيرهم، وهي كالمخابرات الرسمية في وصف الوقائع الحربية أو غيرها، منها رسالة كتبها إلى ركن الدولة سنة ٣٦٤ﻫ، شرح فيها فتح بغداد وانهزام الأتراك منها ووصف الخلاف، ورسالة على لسان عز الدولة إلى عضد الدولة، جواب كتاب بفتح جبال القفص (بين فارس وكرمان)، وقهر البلوص (جيل من الأكراد)، ورسائل أخرى عن حروب بين البويهيين والحمدانيين وغيرهم، وكلها تشتمل على حقائق تاريخية رسمية تفسر بعض ما التبس من تاريخ ذلك العصر، وفيها صور عهود أو تقليدات رسمية للولاة أو العمال أو القضاة صادرة من الخليفة، كالعهد الذي قلَّده الطائع لله العباسي أبا الحسن علي بن ركن الدولة على الصلاة وأعمال الحرب يدخل في بضع عشرة صفحة، وفيه أمور هامة عن أحوال السياسة والإدارة والاجتماع مما لا يتيسَّر الوقوف عليه في كتب التاريخ، ونسخة عهد إلى قاضي القضاة، وغيرها إلى القواد أو الفقهاء أو أمراء الحج، ومنشورات بعثت إلى الأهلين أو العمال أو القرامطة، فضلًا عن رسائل خصوصية كتبها الصابي إلى أصدقائه. وبالجملة إن هذه المنشآت خزانة أدب وتاريخ وسياسة، وعبارتها بليغة متينة، بل هي من أبلغ ما كتب في ذلك العصر.
- (٢)
رسائل الصابي: تقسم إلى أبواب في المراسلات والشفاعات والمعاتبات، وما أنفذ إلى العمال والمنصرفين والنواحي، وهي غير منشآته المتقدم ذكرها وإن كانت تشبهها في أكثر موادها، فإن فيها كثيرًا من الرسائل الودية، فضلًا عن المخابرات السياسية والتقاليد الرسمية والمناشير ونحوها، وفيها فوائد تاريخية واجتماعية هامة، منها نسخة خطية في ليدن وفي المكتبة الخديوية وجزء في باريس، وطبع بعضها في بيروت.
أما التاجي فلم يصلنا منه شيء.
وتجد ترجمته في ابن خلكان ١٢ ج١، ويتيمة الدهر ٢٣ ج٢، ومعجم الأدباء ٣٢٤ ج١، والفهرست ١٣٤.
(٢-٤) الصاحب بن عباد (توفي سنة ٣٨٥ﻫ)
هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني. وقد تقدمت الإشارة إلى منزلته من الوجاهة وتأثيره في تلك الحركة الأدبية، وكان أديبًا منشئًا وعالمًا في اللغة وغيرها. أخذ عن أحمد بن فارس اللغوي الآتي ذكره وعن ابن العميد، وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء؛ لأنه كان يصحب ابن العميد، فقيل له: صاحب ابن العميد، ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة وبقي علمًا عليه، وسمي به كل من ولي الوزارة بعده، وقد وزر أولًا لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه بعد ابن العميد، فلما توفي مؤيد الدولة تولى مكانه أخوه فخر الدولة، فأقَرَّ الصاحب على وزارته، وكان مبجلًا عنده نافذ الأمر. وكان مجلسه بؤرة الأدباء والشعراء يمدحونه أو يتناقشون أو يتقارضون بين يديه. وذاعت شهرته في ذلك العصر حتى أصبح موضوع إعجاب القوم يتسابقون إلى إطرائه، ونظمت القصائد في مدحه. وكتب إليه نوح بن منصور الساماني يستقدمه إليه فاعتذر، وقد بلغ من رفعة القدر حتى إنه لما توفي سنة ٣٨٥ﻫ أغلقت له مدينة الري أبوابها، واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون جنازته، وحضر مخدومه فخر الدولة المذكور أولًا وسائر القواد وقد غيروا لباسهم، فلما خرج نعشه من الباب صاح الناس بأجمعهم صيحة واحدة وقبلوا الأرض، ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس وقعد للعزاء أيامًا، ورثاه أبو سعيد الرستمي بقوله:
وكان شاعرًا مترسلًا مع ولع شديد بالسجع حتى في الكلام فضلًا عن الكتابة. وقيل فيه: «إنه لو رأى سجعة تنحلُّ بموقعها عروة الملك، ويضطرب بها حبل الدولة لما هان عليه التخلي عنها.» وكان يتثنى ويتلوى ويتهادى. وفي يتيمة الدهر أمثلة من نظمه ونثره فضلًا عن معرفته اللغة؛ فإنه ألَّف معجمًا سماه المحيط سيأتي ذكره مع المعاجم، وألَّف له ابن فارس كتاب الصاحبي الآتي ذكره، وساعده منصبه السياسي على الشهرة العلمية، وله في الرسائل كتاب الكافي منه منتخبات خطية في مكتبة باريس، وقصيدتان من شعره في برلين، وله ديوان في مكتبة أيا صوفيا بالآستانة.
وترجمته في ابن خلكان ٧٥ ج١، وطبقات الأدباء ٣٩٧، ويتيمة الدهر ٣١ ج٣، ومعجم الأدباء ٢٧٣ ج٢، والفهرست ١٣٥، ويتيمة الدهر ١٥٧ ج٤.
(٢-٥) بديع الزمان الهمذاني (توفي سنة ٣٩٨ﻫ)
هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمذاني الحافظ، المعروف ببديع الزمان. كان يقيم في هراة بأفغانستان، وكان شاعرًا وكاتبًا ولغويًّا، واشتهر على الخصوص بقوة الحافظة. كان يسمع القصيدة التي لم يسمعها قط وهي أكثر من خمسين بيتًا فيحفظها كلها ويؤديها من أولها إلى آخرها لا يخرم حرفًا ولا يخل معنى، وينظر في الأربعة والخمسة الأوراق من كتاب لم يعرفه نظرة واحدة خفيفة، ثم يتلوها عن ظهر قلبه.
- (١)
رسائل مجموعة في كتاب يعرف برسائل بديع الزمان، طبعت في الآستانة سنة ١٢٩٨، وفي بيروت سنة ١٨٩٠.
- (٢)
ديوان شعر: منه نسخة خطية في مكتبة باريس، وقد طبع بمصر سنة ١٣٢١ﻫ.
- (٣)
مقامات تعرف باسمه، وهي أقدم كتاب وصل إلينا في هذا الفن عن فنون اللغة، وهو أول من وفَّاه حقه وجعله علمًا، وقد اقتبس نسقه من أستاذه ابن فارس اللغوي الآتي ذكره، وعنه أخذ الحريري نسق مقاماته. والمقامات حكايات قصيرة موضوعة على لسان رجل خيالي تنتهي بعبرة أو موعظة أو نكتة، والمراد بها في الأكثر التفنن بالإنشاء وتضمينه الأمثال والحكم، ولم يكن هذا كل المراد منها في زمن الهمذاني. وقد شبَّهها بعضهم بالدرام في اللغات الإفرنجية. ومقامات الهمذاني تُرْوَى على لسان رجل اسمه عيسى بن هشام. طبعت هذه المقامات في الآستانة سنة ١٢٩٨، ثم في بيروت مشروحة شرحًا مختصرًا للشيخ محمد عبده سنة ١٨٨٩، وهو غير عبد الرحمن الهمذاني صاحب الألفاظ الكتابية المتقدم ذكره.
وترجمة بديع الزمان في ابن خلكان ٣٩ ج١، ومعجم الأدباء ٩٤ ج١، ويتيمة الدهر ١٦٧ ج٤.
(٢-٦) أبو منصور الثعالبي (توفي سنة ٤٢٩ﻫ)
هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري الثعالبي — قيل له ذلك؛ لأنه كان فرَّاءً بجلد الثعالب، وهو خاتمة مترسلي هذا العصر وأهم أدبائه، ونعم الخاتمة؛ لأنه أكثرهم آثارًا وأوسعهم مادة، وهو الذي ترجمهم وذكر أخبارهم وأقوالهم، وكان في العصر المشار إليه راعي تلعات العلم، وجامع أشتات النثر والنظم، ورأس المؤلفين، وإمام المصنِّفين. وهو مع ذلك شاعر مطبوع، ومن نظمه في وصف الفرس قوله:
وله مؤلفات كثيرة أكثرها من قبيل الأدب، فنؤجل ذكرها إلى ذلك الباب، ونكتفي هنا بذكر كتابه في الإنشاء، نعني كتاب رسائل الثعالبي، طبع في الآستانة سنة ١٣٠١، وهو أربع رسائل منتخبة من كتب التمثُّل والمحاضرة والمبهج وسحر البلاغة والنهاية الآتي ذكرها بين كتبه الأخرى.
(٢-٧) منشئون آخرون
(٧) أبو الفتح البستي في يتيمة الدهر ٢٠٤ ج٤.
(٨) أبو الفضل الميكالي في يتيمة الدهر ٢٤٧ ج٤.
(٩) الحاتمي في يتيمة الدهر ٢٧٣ ج٢.
(١٠) الشابشتي ابن خلكان ٣٣٨ ج١.
(١١) التهامي الشاعر ابن خلكان ٣٥٧ ج١.
(١٢) القسطلي في اليتيمة ٤٣٨ ج١.
(٣) الأدب والإنشاء عند الإفرنج
كان الغرض الأول من الأدب العربي في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية خدمة مصلحة ولاة الأمر في تأييد سيادتهم، ونفوذهم أو تسليتهم وتفريحهم، وكان أكثر الشعراء والأدباء من الموالي طلاب الرزق، فلم تتوجه قرائحهم إلى النقد الاجتماعي أو السياسي أو الفلسفي مما يقتضيه النظر في الخليقة أو نظام الاجتماع أو الدولة؛ لأن ذلك لا يلائم أغراض أصحاب السيادة، ولا سيما بعد أن صار هؤلاء يطاردون الأحرار باسم الزندقة أو الاعتزال أو الفلسفة بعد عصر المأمون، فقامت تلك المطاردة سدًّا في سبيل حرية القول واستقلال الفكر، فأصبح الأدباء لا يفكرون إلا كما يشاء أمراؤهم، وإذا فكروا في غيره فلا يجسرون على قوله، وإذا قالوه بادروا إلى إخفائه فرارًا من الأذى أو سوء الأحدوثة أو الاتهام بالمروق من الدين؛ ولذلك لم يصلنا من أقوال أدباء ذلك العصر الحرة الانتقادية إلا النزر اليسير.
ولعل أول من كسر قيود التقليد في هذا الشأن أبو العلاء المعري الشاعر الفيلسوف، فنشر آراءه في انتقاد الهيأة الاجتماعية والتقاليد الدينية والاعتقادات الشائعة نظمًا ونثرًا، فوجَّه سهامه نحو رجال الدين لاحترافهم التقوى في سبيل الاستجداء أو الاستئثار، ونظم في فلسفة الوجود وفلسفة الاجتماع، فنقم عليه كثيرون واتهموه بالكفر ولم يعدوا قوله شعرًا فسموه الحكيم وأنكروا عليه الشاعرية. والحقيقة أن تلك هي الشاعرية بعينها، فسرت روحه في جسم المجتمع، وأخذ الأدباء من العرب وغيرهم يتحدونه كما فعل عمر الخيام برباعياته.
على أن أكثر أدباء العرب اقتصروا في انتقاداتهم الاجتماعية أو الأخلاقية على نظم القصائد الحكمية، يضمِّنونها الحِكَم والمواعظ ومحاسن الأخلاق، وأكثر الكتب المؤلفة في السياسة ونحوها تتضمَّن النصائح للملوك وما ينبغي أن يكونوا عليه من الكمالات. وقد يؤلفون الكتاب باسم ملك ينصحونه به كما فعل الشيخ عبد الرحمن في كتاب السياسة، الذي قدمه لصلاح الدين الأيوبي.
ولكن ذلك غير ما يريده أدباء الإفرنج في عصرنا من النقد الأدبي أو الأدب الانتقادي، فهم يريدون ما فعله شكسبير ودانتي وهوكو وروسو وفولتير وغيرهم ممن ألف القصص للمطالعة أو التمثيل أو القصائد أو المقالات في تصوير الحقائق وانتقادها، واستخراج العبرة منها بأسلوب شعري يؤثِّر في النفس. وقد يؤلف أحدهم الرواية الكبيرة ينتقد بها عادة شائعة أو نكتة توسمها في نظام الاجتماع أو قوانين الحكومة، والعرب قلما فعلوا ذلك في النظم أو في النثر، إلا نحو ما يؤخذ من كتاب كليلة ودمنة وأمثاله، وهو تلميحي وليس هو عربي الأصل، وقد ألفوا قصة عنتر مثلًا صوروا بها حالة الاجتماع في الجاهلية، وصوَّروا في ألف ليلة وليلة حال الاجتماع في عصر الرخاء والحضارة، لكنهم لم يضعوا ذلك في شكل انتقادي، ولا نبَّهوا إلى مكان العبرة فيه، وإن كان القارئ يتأثَّر من المطالعة فيساق من نفسه إلى استحسان بعض ما صور هناك من المناقب فيتحداها، إلا أنه غير مقصود في التأليف.
وهذا النقص ليس خاصًّا بالعرب، بل هو يشمل أكثر الشرقيين، ولعل السبب فيه شدة احترامهم لرؤسائهم مع تأصُّل الحكم الاستبدادي في نفوسهم بتوالي الأجيال واضطرارهم للارتزاق من الرؤساء، وهم أصحاب قرائح انتقادية فحصروها في المناظرات اللغوية والنحوية كما فعل البصريون والكوفيون، أو في المجادلات الدينية، ويراد بها غالبًا خدمة مصلحة ولاة الأمر فيما يرجع إلى تأييد سيادة بعض الرؤساء دون سواه أو تحقير أعدائهم من دعاة الخلافة أو القائمين على الدولة، أو في المهاجاة لنصرة الأحزاب بين السنة والشيعة أو نحوها، أما انتقاد المبادئ الاجتماعية أو السياسية، فإنه قليل في ثمار قرائحهم.
ولكن ليس من الإنصاف أن نقيس حال أدبائنا في تلك الأعصر بحال أدباء الإفرنج في هذا العصر، فإن هؤلاء لم تظهر فيهم القرائح الحرة إلا بعد حل قيود التقليد وقلب النظام الاجتماعي، وتبديل الحال السياسي حتى صار للعامة شأن، وقد سفكت الدماء في سبيل الحرية الشخصية والحقوق الفردية، فنشأت القرائح على حرية الفكر والقول.
على أن تقاعد العرب عن ذلك النقد ليس من عجز في فطرتهم، فإنهم من أصفى الناس أذهانًا وأدقهم نظرًا وأأباهم للضيم، فلما حدث مثل ذلك الانقلاب فيهم عند ظهور الإسلام أظهروا شجاعة أدبية لا مثيل لها حتى كان الراعي يخاطب الخليفة بلا كلفة وينتقده، بلا خوف، ولا يرى الخليفة غرابة في انتقاده.
حتى في إبَّان التمدن الإسلامي، إذا أتيح للشاعر أن يقول فكره عن جرأة في الرأي مع استغنائه عن أموال ولاة الأمور لم يقصر عن مجاراة أَكْتَب الإفرنج اليوم في روح النقد والعبرة والفلسفة. فقول أبي العلاء المَعَرِّي في انتقاد الحكومة ورجالها:
وقد تصور أبو العلاء الحكم الدستوري أو الجمهوري منذ تسعمائة سنة، فوصف الأمة الذليلة بقوله:
وقد ظهر بعد المعري غير واحد من النقَّادين سيأتي ذكرهم في أماكنهم.
الإنشاء
قد رأيت في كلامنا عن الإنشاء في العصر العباسي الثالث أنه نضج في ذلك العصر وتعينت له قواعد تحداها من جاء في العصر الرابع وما بعده، ونبغ في هذا العصر جماعة من المنشئين قَلَّ من تفرغ منهم للإنشاء كما فعل أدباء العصر الثالث، فاشتغل بعضهم في التاريخ أو غيره، فيأتي ذكر كل منهم في مكانه حسب الموضوع الذي اشتهر به، وإنما نقول كلمة في الإنشاء على الإجمال، ونريد إنشاء الرسائل أو الترسل والخطب ومقدمات الكتب.
لما تمكنت السيادة للأعاجم أصبح العرب وغيرهم من أهل الأدب في حاجة إلى التملق، فجرهم ذلك إلى تنميق العبارة والمبالغة في الإطراء والتأنق في الإنشاء مع ما تقتضيه طبيعة العمران من التبسط في الحضارة والاسترسال في تزويق العبارة بأنواع البديع والجناس، شأن المتحضرين في سائر أحوالهم فإنهم يجنحون إلى أسباب الرخاء والتأنق في كل شيء، فتجاوزوا في الإنشاء ما وضعه أدباء العصر الثالث من القواعد التي سميناها مدرسية.
كان التنميق في العصر العباسي الثالث يزيد الإنشاء رونقًا للاكتفاء بالقدر اللازم على ما يقتضيه الذوق السليم من سجع أو جناس أو كناية، فاستحسن أهل العصر الرابع ذلك فاسترسلوا فيه وتجاوزوا حده، فآل إلى عكس المراد، كالثوب أرادوا به في أصل صنعه اتقاء البرد أو ستر العورة ثم رأوا أنهم إذا تفننوا بشكله من إطالة الذيل أو توسيع الأكمام أو زركشة الأطراف ببعض الألوان يزداد رونقًا وجمالًا، ففعلوا، لكن بعضهم يكثر من تلك الزينة ويبالغ في التأنق حتى يتجاوز الحد وينقلب إلى الضد بحيث يصير الثوب كأنه وُضع للزينة فقط وقد يعود بالضرر، ذلك ما أصاب الإنشاء (أو الترسل) لما أراد أصحابه الإكثار من تزيينه، ولم يكتفوا بالقدر اللازم، فأصبح كأن المراد به الزينة دون الفائدة، وانصرفت العناية إلى اللفظ دون المعنى، وتنافس الكتَّاب في ذلك بين جناس وبديع وسجع وإغراب في اللفظ حتى أصبح الترسل مغلقًا على غير المتبحرين. كما فعل عماد الدين الأصفهاني عمدة المنشئين في ذلك العصر، فإنه بالغ في التأنق حتى استخدمه في كتابه التاريخ، فضلًا عن الرسائل والخطب. وتراه ظاهرًا في كتابه الفتح القسي الذي أرخ فيه فتح صلاح الدين بيت المقدس، فإن في عبارته ما لا يحل إلا بالتأمل أو مراجعة المعاجم وهذا مثال منها: «ثم رحل من عسقلان للقدس طالبًا وبالعزم غالبًا، وللنصر مصاحبًا ولذيل العز ساحبًا، قد أصحب ريض مناه، وأخصب روض غناه، وأصبح رائج الرجاء، أرج الإرجاء، سيب العزف، طيب العرف، ظاهر اليد، قاهر الأيد، سنى عسكره قد فاض بالفضاء فضاء، وملأ الملأ فأفاض الآلاء، وقد بسط عثير فيلقه ملاءته على الفلق، وكأنما أعاد العجاج رأد الضحى جنح الغسق، فالأرض شاكية من إجحاف الجحافل، والسماء حاظية بأقساط القساطل … إلخ.» وسيأتي ذكره بين المؤرخين، وقس عليه من عاصره أو نسج على منواله من المتأنقين في الإنشاء، لكن ذلك بحمد الله لم يتناول كتب العلم والتاريخ والأدب في هذا العصر إلا قليلًا.
القاضي الفاضل (توفي سنة ٥٩٦ﻫ)
نقد الإنشاء أو النقد البياني
أقدم من تصدى لهذا الموضوع ابن قتيبة المتوفى سنة ٢٦٧ﻫ في كتابه أدب الكاتب كما تقدم في كلامنا عن الإنشاء في العصر العباسي الثاني من هذا الكتاب (ج٢)، واقتدى به كثيرون ممن جاء بعده من الأدباء والبلغاء كالخوارزمي والثعالبي والعسكري والآمدي والماوردي، لكنهم انتقدوا الإنشاء عرضًا أو في فصل أو مقالة. وربما أفرد بعضهم كتابًا في انتقاد الألفاظ الشائعة على أقلام الكتاب أو ما يشوب إنشاءهم من الركاكة أو الأغلاط، وقد يأتون ذلك في عرض كلامهم عن بلاغة القرآن كما فعل القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣ في كتابه إعجاز القرآن، فإنه أتى في أثنائه بفوائد انتقادية هامة عن الإنشاء والبلاغة، وكان مشهورًا بجودة الاستنباط وهو من كبار علماء الكلام.١
أما نقد الإنشاء من حيث هو فن ذو قواعد فتصدى له الجرجاني الآتي ذكره في كتابه أسرار البلاغة في علم البيان، وهو واضع أساس هذا العلم في العربية على قواعد راسخة، قال في سبب ما بعثه على ذلك: إنه رأى فساد ملكة الإنشاء.
وانصراف الكتَّاب عن المعاني إلى الألفاظ فوضع كتابه المشار إليه في البلاغة، وتوسع فيه من جاء بعده من أئمة اللغة وأرباب البلاغة حتى صار الإنشاء علمًا يبحث فيه عن المنثور من حيث إنه بليغ وفصيح، ويشتمل على الآداب المعتبرة من العبارات المستحسنة واللائقة بالمقام، وموضوع علم البيان كما عرفه أصحابه «إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على المقصود بأن تكون دلالة بعضها أجلى من بعض.»
ويدخل في ذلك أيضًا انتقاد اللغة من حيث صيغ الألفاظ ومعانيها واستعمالها في أماكنها، وهو قديم أدركه أدباء العصر العباسي الأول فألقوا في لحن العامة والخاصة، أشهرهم أو عبيدة والسجستاني والمفضل بن سلمة والزبيدي والعسكري وغيرهم. ومن هذا القبيل درة الغواص في أوهام الخواص للحريري الآتي ذكره، والانتقادات اللغوية كثيرة منذ اشتغل العرب في تدوين لغتهم، وانتشب الجدال بين البصريين والكوفيين، وتصدى جماعة من العلماء لانتقاد المعاجم وغيرها من كتب اللغة مما يطول شرحه وسيأتي ذكره في مكانه.
وإنما نحصر الكلام الآن في البلاغة أو البيان، فالجرجاني واضع أسس هذا العلم ثم جاء السكاكي وغيره فتوسعوا فيه واستحسنه المنشئون وبالغوا في التنميق حتى صاروا إلى التكلف والتأنق، وتوسعوا في شرح قواعده وزادوا عليه حتى بلغ إلى ما نعرفه من أمره، ومن الكتب الوافية في علم البيان «المثل السائر» لضياء الدين بن الأثير الجزري الآتي ذكره، وقد توسع في أبواب البلاغة وشروطها وانتقادها من حيث الصناعة اللفظية والصناعة المعنوية، ثم ألف كثيرون في الإنشاء وانتقاده في سبيل علم البيان أو البلاغة أو في سبل أخرى، ولابن خلدون في مقدمته فصول في هذه المواضيع جزيلة الفائدة، وكلهم انتقدوا التسجيع إلا بشروط عينوها فوضعوا للبلاغة قواعد ترجع في الحقيقة إلى الذوق.
إن كلامنا عن الشعر فيما تقدم ينطبق على الإنشاء؛ لأنهما من باب واحد، فكان تأثير هذه النهضة عليهما على شكل واحد، ولعل هذا التأثير ظهر في الإنشاء أكثر من ظهوره في الشعر، نعني أن الكتَّاب أخذوا يعولون فيما يكتبونه على المعاني أكثر مما فعل الشعراء، وكان الإنشاء في أواخر العصر العثماني قد أصبح المعول فيه على الألفاظ بين سجع واستعارة وتورية وجناس، بحيث يتعذر عليك الوصول إلى المعنى؛ لما يتلبد حوله من الصور المبهمة. فلما أتتنا هذه المدنية بعلومها الطبيعية والرياضية المبنية على المشاهدة والاختبار، وتعوَّد الناس تقدير الوقت بتقريب المسافات، وأخذت الحرية في الشيوع — أصبح الأدباء ينفرون من استعمال ما لا حقيقة له، ويستنكفون من إضاعة الوقت في السجع البارد، أو تكرار الألقاب والنعوت لمجرد التفخيم، وهان عليهم العدول إلى الحقيقة بحيث يكون همُّ الكاتب موجَّهًا بالأكثر إلى المعنى المراد إيضاحه؛ فأخذت هذه الروح تسري بين الكتَّاب من أواسط هذا العصر، لكنهم لم يتفقوا على أسلوب واحد يتحدونه، فهم مجمعون على أن الطريقة المدرسية المشوشة — كما وصلت إلينا — لا تنفع لغموضها وطولها، فتركوها واختلفوا في الأسلوب الذي يعولون عليه فيما يلائم روح هذا العصر، فرجعوا إلى تحدي أساليب القدماء، فبعضهم تحدى أسلوب صدر الإسلام، وآخرون قلَّدوا أساليب صدر الدولة العباسية، ولا سيما أسلوب ابن المقفع — وهو الغالب على أقلامهم لسهولته ومتانته — على أن بعضهم يتوخى أسلوب ابن خلدون في مقدمته، وآخرون يقلدون الجاحظ أو غيره.
ذلك شأن الكُتَّاب المنشئين الذين يهمهم تنميق العبارة، ولا سيما في المواضيع الخطابية التي تحتاج إلى تقريع أو تهديد، أو إرهاب أو ترغيب، أما في المواضيع العمومية فقد نشأ في الإنشاء أسلوب عصري بسيط لا يرى أصحابه حاجة إلى تنميق العبارة، والتأنق في التركيب، وإنما يجعلون همهم إيضاح المعنى وإيصاله إلى ذهن القارئ بسهولة، وفيهم من يبالغ في إهمال الصناعة اللفظية، ولو أخلَّ بالإعراب واستعمل العامي من الألفاظ، وهذا غلو يُفسِد اللغة ويضيعها، فيجب مع توخي السهولة في الإنشاء المحافظة على قواعد اللغة وروابطها.
أساليب التأليف
- (١)
سلاسة العبارة وسهولتها بحيث لا يتكلف القارئ إعمال الفكرة في تفهُّمها.
- (٢)
تجنُّب الألفاظ المهجورة والعبارات المسجعة، إلا ما يجيء عفوًا ولا يثقل على السمع.
- (٣)
تقصير العبارة وتجريدها من التنميق والحشو؛ حتى يكون اللفظ على قدر المعنى.
- (٤)
ترتيب الموضوع ترتيبًا منطقيًّا في حلقات متناسقة يأخذ بعضها برقاب بعض، وتنطبق أوائلها على أواخرها.
- (٥)
تقسيم المواضيع إلى أبواب وفصول، وتصدير كل باب أو فصل بلفظ أو عبارة تدل على موضوعه.
- (٦)
تذييل الكتب بفهارس أبجدية تسهِّل البحث عن فروع الموضوع الأصلي، وقد يجعلون للكتاب الواحد عدة فهارس، واحد للمواضيع، وآخر للأعلام، وآخر لغير ذلك.
- (٧)
تنويع أشكال الحروف على مقتضى أهمية الكلام، فيجعلون للمتن حرفًا، وللشرح حرفًا، وللرءوس حرفًا.
- (٨)
تسمية الكتب باسم يدل على موضوعها، كتسمية كتاب تاريخ مصر بتاريخ مصر، وكتاب الكيمياء بالكيمياء، وكتاب النحو بالنحو، وأبطلوا التسجيع في أسمائها.
- (٩)
يزينون المؤلفات بالرسوم، ويضبطون الألفاظ بالحركات عند الاقتضاء.
- (١٠)
إذا أرادوا إسناد الكلام إلى كتاب أو كاتب أشاروا إلى ذلك في ذيل الصحيفة.
- (١١)
يفصلون الجمل بنقط أو علامات يدلون بها على أغراض الكاتب، كالوقف والتعجب والاستفهام أو نحو ذلك، وعلامات لحصر الجمل المعترضة، أو تمييز بعض الأحوال.
التراكيب الأعجمية
- (١)
فلان كلاهوتي يقدر أن يؤثر كثيرًّا.
- (٢)
رأيت صديقي فلانًا الذي أعطاني الكتاب (أيْ فأعطاني).
- (٣)
رغمًا عن مساعيه الحميدة لم ينجح في عمله.
- (٤)
مستمدًّا العناية من الله أقف بينكم خطيبًا.
- (٥)
لعب فلان دورًا مهمًّا في هذه المسألة.
- (٦)
المعاهدة المصادق عليها من الدولة الفلانية.
- (٧)
إن الأمر الفلاني مضر بقدر وشرف ومالية فلان.
- (٨)
يوجد في بلاد الحجاز عدة جبال.
- (٩)
هذه المصيبة أعطته درسًا نافعًا.
لغة الدواوين
وهناك أسلوب من الإنشاء تطرَّق إلى اللغة في هذه النهضة، نعني أسلوب دواوين الحكومة المصرية المشهور بركاكته، ويرجع هذا الأسلوب في أصله إلى العصر العثماني؛ إذ بلغت مصر غاية الانحطاط في أحوالها الاجتماعية والسياسية والعلمية، فلم ينقضِ القرن الثامن عشر حتى أصبحت لغة الكتابة أشبه بلغة العامة مع ما يتخللها من الألفاظ الأعجمية، كما يظهر ذلك في إنشاء المؤلفين من أهل تلك الفترة كالجبرتي ومعاصريه، ولما جاء الفرنساويون مصر كان في حملتهم جماعة من التراجمة يتوسطون بينهم وبين الأهلين، ويترجمون لهم المنشورات والمراسلات، والظاهر أن هؤلاء التراجمة كان بعضهم من غير أبناء هذه اللغة، فإذا ترجموا عبارة صاغوها في قالب أعجمي، وما لم يجدوا له لفظًا عربيًّا تركوه على لفظه الإفرنجي، أو وضعوا له لفظًا عاميًّا.
فلما أفضت الولاية إلى محمد علي رأس الأسرة الخديوية، وأخذ في إنشاء الدواوين لم يكن له غنى عمن يترجم بين حكومته وحكومات أوربا، فاستخدم التراجمة، واللغة لا تزال في انحطاطها وركاكتها، والذين يعرفون أساليبها ويحفظون أوضاعها قليلون، ولا سيما في الذين استخدمهم لأعمال الحكومة، أو ترجمة أوامرها، فدخل لغة الحكومة ألفاظ وتراكيب خاصة بها، ولما استنار الناس على أثر نشر الصحافة، ونبغ الكتَّاب والمنشئون في أواخر القرن الماضي انتظم جماعة منهم في مصالح الحكومة، وأخذوا في تنقيح لغة الدواوين من تلك الشوائب، ولا يزالون يفعلون ذلك.١
الإنشاء الصحافي
وهناك ضرب من الإنشاء اقتضته الحاجة إلى تفهيم العامة — نعني إنشاء الصحف — وقد تقلب على أطوار شتى، ومَن يطالع الصحف العربية ويقابل قديمها بحديثها، ينبسط لديه تاريخ الإنشاء الصحافي وتدرُّجه في الارتقاء، كان في أول أمره كما تقدم من ركاكة الإنشاء، ثم أخذ يتدرج في أسلوبه وألفاظه حتى صار إلى ما هو عليه الآن.
وللإنشاء الصحافي تاريخ طويل يقال في إجماله: إن أول مَن حسنه من رجال الصحافة الشيخ أحمد فارس الشدياق في الجوائب، والبستاني في الجنان، ولما زهت الصحافة في زمن إسماعيل خَطَا الإنشاء خطوة هامة على يد أديب إسحق، فإنه اتخذ أسلوبًا تحداه فيه الكتَّاب، ودخل الإنشاء روح سياسية حماسية بسبب الحركة السياسية الوطنية في أواخر أيام إسماعيل، وأوائل أيام توفيق، ولا سيما بعد نزول جمال الدين الأفغاني وادي النيل والتفاف الكتَّاب حوله، وارتقى الإنشاء خطوة أخرى في العصر الأخير باتجاه الخواطر إلى اللغة العربية والجامعة العربية، ونبغت طبقة بليغة من الكتَّاب الصحافيين المعاصرين، وصار الإنشاء الصحافي على إجماله واضحًا مقسَّمًا مبوَّبًا، خاليًا من المقدمات والخاتمات، بلا تسجيع ولا تورية أو تفخيم، وإليك أشهر الصحافيين في هذه النهضة.
الصحافيون بمصر والشام
- (١)أبو السعود توفي سنة ١٨٧٨ / ١٢٩٥ﻫ: هو عبد الله أبو السعود بن الشيخ عبد الله، وُلِد في دهشور سنة ١٨٢٠ / ١٢٣٦ﻫ، وأصله من جبال برقة، تفقه في المدارس التي أنشأها محمد علي، ثم أُلحِق بمدرسة الألسن سنة ١٢٣٩ﻫ على يد رفاعة بك الطهطاوي، وتقدَّم في سار العلوم اللغوية والرياضية والفقه؛ لأنه كان يحضر في الأزهر، وأتقن اللغة الفرنساوية والإيطالية، وأخذ في التعليم وتصحيح تراجم الكتب الرياضية وغيرها، وهو يرتقي في الرتب حتى تعيَّن في ترجمة ديوان المدارس، وفي أول ولاية سعيد باشا سنة ١٢٧٠ﻫ جُعِل رئيس قلم عرضحالات بالمالية، وصار في زمن إسماعيل ناظر قلم ترجمة ديوان المدارس، وعلَّم التاريخ بدار العلوم الخديوية، ثم تعيَّن من أعضاء مجلس الاستئناف إلى أن توفي سنة ١٢٩٥ﻫ، وهو أول من أنشأ صحيفة سياسية عربية غير رسمية بمصر — نعني جريدة «وادي النيل» كما تقدَّم — واشتغل بنقل الكتب عن الإفرنجية، وألَّف كتبًا مفيدة، وهاك أهم آثاره:
- (أ)
نظم اللآلي في السلوك في مَن حكم فرنسا من الملوك: طُبِع بمصر سنة ١٢٥٧ﻫ، وفي ذيله جدول لمقابلة تاريخ الهجرة مع تاريخ الميلاد من أول الهجرة إلى سنة ١٣٠٠ﻫ.
- (ب)
الدرس التام في التاريخ العام: طُبِع بمصر سنة ١٢٨٩ﻫ.
- (جـ)
قناصة أهل العصر في خلاصة تاريخ مصر (القديم): أصله تأليف ماريت باشا بالفرنساوية، ونقله أبو السعود إلى العربية بأمر نظارة المعارف، طُبِع سنة ١٢٨١ﻫ.
- (د)
ديوان شعر طُبِع بمصر، وفيه كثير من المنظومات المولَّدة كالموالي والموشحات.
- (هـ)
أرجوزة في سيرة محمد علي في نحو ألف بيت.
- (و)
منحة أهل العصر بمنتقى تاريخ مصر: لخصه عن الجبرتي.
- (ز)
قانون المحاكمات: ترجمة عن الفرنساوية والإيطالية، طُبِع بمصر سنة ١٢٨٣ﻫ في مجلدين، وله ترجمات أخرى جاء ذكرها في مكان آخر.
- (أ)
- (أ)
نظم اللآلي في السلوك في مَن حكم فرنسا من الملوك: طُبِع بمصر سنة ١٢٥٧ﻫ، وفي ذيله جدول لمقابلة تاريخ الهجرة مع تاريخ الميلاد من أول الهجرة إلى سنة ١٣٠٠ﻫ.
- (ب)
الدرس التام في التاريخ العام: طُبِع بمصر سنة ١٢٨٩ﻫ.
- (جـ)
قناصة أهل العصر في خلاصة تاريخ مصر (القديم): أصله تأليف ماريت باشا بالفرنساوية، ونقله أبو السعود إلى العربية بأمر نظارة المعارف، طُبِع سنة ١٢٨١ﻫ.
- (د)
ديوان شعر طُبِع بمصر، وفيه كثير من المنظومات المولَّدة كالموالي والموشحات.
- (هـ)
أرجوزة في سيرة محمد علي في نحو ألف بيت.
- (و)
منحة أهل العصر بمنتقى تاريخ مصر: لخصه عن الجبرتي.
- (ز)
قانون المحاكمات: ترجمة عن الفرنساوية والإيطالية، طُبِع بمصر سنة ١٢٨٣ﻫ في مجلدين، وله ترجمات أخرى جاء ذكرها في مكان آخر.
- (٢)رزق الله حسون الحلبي توفي سنة ١٨٨٠ / ١٢٩٨ﻫ: أصله أرمني فارسي، وُلِد في حلب سنة ١٨٢٥، وتفقه في دير بزمار (لبنان) في العلوم الدينية، ثم أتقن اللغات الفرنساوية والتركية والأرمنية والعربية والرياضيات، وكان قوي الحافظة، ثم عاد إلى حلب، وتعاطى التجارة حينًا ونفسه تتطلب العلى، فرحل إلى أوربا وطاف عواصمها، واستنسخ بعض الكتب من مكاتبها الشرقية، وجاء الأستانة، واتصل بخدمة الحكومة، وكان بينه وبين معاصريه من الأدباء مساجلات، ثم نشبت حرب القرم بين روسيا والدولة فأنشأ سنة ١٨٥٥ «مرآة الأحوال» في الأستانة، وهي أول جريدة عربية غير رسمية في العالم كله، وصف فيها حرب القرم فذاعت شهرته، فلما جاء فؤاد باشا سوريا على أثر حوادث سنة ١٨٦٠ جاء معه رزق الله لترجمة المناشير والأوامر، وعاد معه إلى الأستانة، ثم رافقه إلى لندن ورجع معه، وتولى نظارة الجمرك في الأستانة، فاتُّهِم بالاستيلاء على أموال الجمارك وسُجِن مع آخرين، ثم فر إلى روسيا، وحمل على الحكومة العثمانية في الجرائد، ونزل لندن فأعاد مرآة الأحوال للشكوى من عمال الحكومة، وكان يكتبها بخطه، ويطبعها على الحجر سنة ١٨٧٧، وأصدر أيضًا مجلة عربية سمَّاها «رجوم وغساق إلى فارس الشدياق»، وأصدر مجلة أخرى شعرية في لندن سنة ١٨٧٩، وكانت نزعته السياسية انتقاد عمال الدولة وطلب إصلاحها، ثم انقطع إلى نسخ الكتب، وتصحيح حروف الطباعة العربية في أوربا، وهذه آثاره:
- (أ)
النفثات: تعريب قصص حكيمة لكريلوف الروسي وغيره، طُبِعت في لندن سنة ١٨٦٧.
- (ب)
أشعر شعر: نظم سفر أيوب، ونشيد الأناشيد، وسفر الجامعة، ومراثي أرميا، وغيرها، طُبِع في بيروت سنة ١٨٧٠.
- (جـ)
السيرة السيدية: شرح الأناجيل الأربعة، طُبِع في بيروت.
- (د)رسائل في الطباعة العربية، وكتاب المشمرات وحسر اللثام، وغيرها.٢
- (أ)
- (أ)
النفثات: تعريب قصص حكيمة لكريلوف الروسي وغيره، طُبِعت في لندن سنة ١٨٦٧.
- (ب)
أشعر شعر: نظم سفر أيوب، ونشيد الأناشيد، وسفر الجامعة، ومراثي أرميا، وغيرها، طُبِع في بيروت سنة ١٨٧٠.
- (جـ)
السيرة السيدية: شرح الأناجيل الأربعة، طُبِع في بيروت.
- (د)رسائل في الطباعة العربية، وكتاب المشمرات وحسر اللثام، وغيرها.٢
- (٣)سليم البستاني اللبناني توفي سنة ١٨٨٤ / ١٣٠٢ﻫ: نعني سليم بن بطرس البستاني الآتي ذكره بين أصحاب الموسوعات، وكان سليم عونًا كبيرًا لأبيه في مشروعاته العلمية في إدارة المدرسة، وتحرير الجنان، وإدارة المطبعة، وكان قلمه سيالًا ولا سيما في المواضيع الصحافية، ويكتب في الجنان على الخصوص المقالات الضافية في السياسة والاقتصاد والأدب، ولا يخلو عدد منه من مقالة افتتاحية سياسية بقلمه، وقد ألَّف عدة روايات تمثيلية وقصصية أكثرها نُشِر في الجنان، كرواية الإسكندر، وقيس وليلى، والهيام في جنان الشام، وزينوبيا وغيرها، وترجم تاريخ فرنسا الحديث، وجاء مصر مرتين في سبيل مشاريع أبيه، وعاد مزوَّدًا بمكارم الخديوي إسماعيل ماديًّا وأدبيًّا في تعضيد الأدب، وتوفي بعد وفاة أبيه بقليل.
- (٤)أديب إسحق الدمشقي توفي سنة ١٨٨٥ / ١٣٠٣ﻫ: وُلِد في دمشق سنة ١٨٥٦، وتعلم في مدرسة العازاريين، وظهرت قريحته وهو غلام فعكف على النظم، واضطر للخدمة في سبيل الرزق، فاستُخْدِم في الجمرك مدة تعلَّم في أثنائها اللغة التركية؛ فبعثت إلى ارتقائه، وهو لا ينفك عن المطالعة والتوسع في الأدب ولم يتجاوز الخامسة عشرة، واستقدمه والده إلى بيروت ليساعده في خدمة البريد، فعرف فيها جماعة من الأدباء، وأخذ يكتب في الجرائد، فظهرت قريحته الإنشائية التي اشتهر بها بعد ذلك، وبدأ بتأليف الروايات التمثيلية أو تعريبها مع صديقه سليم نقاش.
 أديب أسحق.
أديب أسحق.
- (٥)سليم وبشارة تقلا اللبنانيان توفي سليم سنة ١٨٩٢ / ١٣١٠ﻫ: هما من مؤسسي الصحافة المصرية، وُلِد سليم في كفر شيما (لبنان) سنة ١٨٤٩، وتعلم مبادئ العلم في مدرسة القرية، ثم في عبية، فلما حدثت مذابح سنة ١٨٦٠ في لبنان انتقل مع أهله إلى بيروت، ودخل المدرسة الوطنية للبستاني وهو لا يستطيع دفع راتبها، فكان يشتغل فيها بما يقوم مقام ذلك الراتب، ونبغ حتى تعيَّن معلمًا في المدرسة البطريركية، ولم تقنع نفسه بذلك، وسمع بتقريب إسماعيل لرجال الأقلام، فرحل مع أخيه بشارة إلى مصر، وأنشأ جريدة الأهرام سنة ١٨٧٥ أسبوعية٤ بالإسكندرية، ثم جعلاها يومية، وقد قاسَيَا في سبيل نشرها مشقات هائلة؛ لأن الناس لم يألفوا مطالعة الجرائد، لكنهما ثبتا في العمل وهي تزداد انتشارًا ونفوذًا وتقدُّمًا، والرتب تتوالى على صاحبيها.
 سليم تقلا.
سليم تقلا.
- (٦)يوسف الشلفون اللباني توفي سنة ١٨٩٦ / ١٣١٤ﻫ: وُلِد سنة ١٨٣٩ وعائلته من أقدم عائلات لبنان المارونية، وكان جده حاكمًا على ساحل لبنان في زمن الأمير بشير الثالث، وكان أول عهده بالصحافة أنه اشتغل بترتيب الحروف في مطبعة خليل الخوري صاحب حديقة الأخبار، وتعلَّم فن الطباعة واشتغل بها حينًا، ثم أنشأ مطبعة لنفسه، وعني في أثناء ذلك بإنشاء الصحف، فأنشأ الشركة الشهيرة سنة ١٨٦٦، والزهرة سنة ١٨٧٠، والنجاح سنة ١٨٧١، والتقدم، وهذه الأخيرة حرَّر فيها نخبة من الكتَّاب منهم أديب إسحق، وكلها تعطلت.
 يوسف الشلفون.
يوسف الشلفون.
- (٧)حسن حسني الطويراني توفي سنة ١٨٩٧ / ١٣١٥ﻫ: يتصل نسبه بأمير من أمراء الأتراك في مكدونية، وُلِد في القاهرة سنة ١٨٥٠، وأقام في الأستانة مدة أنشأ فيها عدة جرائد ومجلات، ثم جاء القاهرة وأنشأ جرائد أخرى تعطلت كلها الآن، وألَّف كتبًا كثيرة بالعربية والتركية تُعَدُّ بالعشرات، نشر كثيرًا منها في مجلاته وجرائده، وكان كثير النظم سريع الخاطر، وله عدة دواوين لكل منها اسم، منها: ثمرات الحياة في مجلدين، وشطحات قلم، وطوالع الآمال، وغير ذلك، ونال رتبة أمير الأمراء (باشا)، وتوفي بالأستانة سنة ١٨٩٧ / ١٣١٥ﻫ، وكان واسع الاطلاع في تاريخ الدولة العثمانية وأحوالها.٦
- (٨)إبراهيم المويلحي المصري توفي سنة ١٩٠٦ / ١٣٢٣ﻫ: هو من أكابر أئمة الإنشاء الصحافي، يرجع بنسبه إلى عائلة وجيهة خدمت الأسرة الخديوية في زمن محمد علي. نشأ إبراهيم في أول أمره تاجرًا مثل أبيه، فخسر ثروته بالمضاربة، فوهبه إسماعيل باشا مالًا استرجع به تجارته، وعيَّنه عضوًا في مجلس الاستئناف، ثم استقال وتقلَّب في مناصب أخرى ونفسه جانحة إلى الأدب والشعر، واشترك مع آخرين في تأسيس جمعية المعارف لنشر الكتب النافعة كما تقدَّم، وأنشأ مطبعة لطبع تلك الكتب سنة ١٢٨٥ﻫ، ثم أنشأ جريدة نزهة الأفكار لم يصدر منها إلا عددان، وتردد إلى الأستانة مرارًا، وله شئون مع رجال حكومتها ورجال ما بينها يطول ذكرها، لكنه كان ميَّالًا بالأكثر إلى تحرير الجرائد بأسلوب من الإنشاء العصري عُرِف به، ولا سيما بعد أن طال اختباره رجال الدولة، وآخر جرائده «مصباح الشرق» كانت أسبوعية، لكن الأدباء كانوا يشتاقون لمطالعتها لحسن أسلوبها الإنشائي السياسي العمراني، وقلَّده فيه كثيرون كما قلَّد آخرون أسلوب أديب، وما زالت المصباح تصدر إلى وفاته، وله مقالات سياسية اجتماعية اسمها «ما هنالك» طُبِعت في كتاب ليس عليه اسمه، وصف بها حال الأستانة والمابين ورجاله قبل الدستور.٧
 إبراهيم المويلحي.
إبراهيم المويلحي.
- (٩)سليم عباس الشلفون البيروتي توفي سنة ١٩١٢ / ١٣٣٠ﻫ: هو من أشهر صحافيي سوريا، وأكثرها اشتغالًا في الصحافة، فقد حرر في بضع عشرة صحيفة في سوريا ومصر، ولقي بلاء من تقلبات السياسة بمصر في أثناء الحوادث العرابية، فارتحل إلى أوربا والأستانة ثم عاد إلى بيروت، واشتغل ١٨ سنة في تحرير جريدة بيروت، ثم غيرها، وتوفي وهو من محرري لسان الحال.
- (١٠)الشيخ علي يوسف المصري توفي سنة ١٩١٣ / ١٣٣١ﻫ: هو مؤسس الصحافة الإسلامية العصرية بمصر، نعني تأسيس جريدة المؤيد أشهر الجرائد الإسلامية، وأوسعها انتشارًا في أنحاء العالم الإسلامي، وقد تقدَّم في كلامنا عن الصحافة العربية ما نشأ من الشعور الوطني في عهد الاحتلال، وانقسام الكتَّاب إلى أحزاب وطنية واحتلالية وغيرها، وكان الشيخ علي ميَّالًا إلى الصحافة، وقد أنشأ مجلة الآداب سنة ١٨٨٥ بالاشتراك مع الشيخ أحمد ماضي، واتفق ظهور جريدة المقطم سنة ١٨٨٩ — وخطتها احتلالية — فأحس أدباء المصريين بحاجتهم إلى جريدة تمهِّد السبيل إلى إنقاذ مصر من الاحتلال، فوقع اختيارهم على محرري الآداب، فأصدروا المؤيد فنصرهما الوطنيون ماديًّا وأدبيًّا، لكن نصرتهم لم تمنع من قيام العقبات، وبعد قليل توفي الشيخ أحمد ماضي، واستقل الشيخ علي بالمؤيد، وثبت في تأييده، بذل في ذلك ما لا يقدر عليه رجل واحد، حتى بلغ ما بلغ إليه من الشهرة والنفوذ وسعة الانتشار في العالم الإسلامي، وخطته الدفاع عن الإسلام وحقوق المسلمين حيثما كانوا. ونال الشيخ علي من المنزلة الرفيعة ما ليس بعده غاية لمثله، فصار من خاصة القوم المقرَّبين من العرش الخديوي، وولاه سُمُوُّه مشيخةَ السجادة الوفائية.٨
 الشيخ علي يوسف.
الشيخ علي يوسف.
ونشأ في مصر وغيرها طبقة من الصحافة في اللغة العامية، أقدمها جريدة أبو نضارة التي كانت تصدر بمصر في زمن إسماعيل لصاحبها يعقوب صنوع المتوفى في باريس سنة ١٩١٢، فإنه انتقل بها إلى باريس، وأنشأ هناك سلسة جرائد هزلية بلغة عامية ذكرها صاحب الصحافة العربية (صفحة ٢٨١ ج٢)، ولا فائدة من ذكرها هنا.
وتوالى إنشاء الصحف العامية في مصر، أو الفصول الهزلية في قالب الجد، وكان عبد الله نديم أكثر الكُتَّاب عملًا في ذلك في التنكيت والتبكيت وفي الأستاذ وغيرهما، وصدرت جرائد هزلية أخرى في بيروت وغيرها.
 أديب أسحق.
أديب أسحق.
 سليم تقلا.
سليم تقلا.
 يوسف الشلفون.
يوسف الشلفون.
 إبراهيم المويلحي.
إبراهيم المويلحي.
 الشيخ علي يوسف.
الشيخ علي يوسف.في تعريف الإنشاء ووجه تعلمه وأنواعه | تاريخ آداب اللغة العربية
الإنشاء في اللغة: الشروع والإيجاد والوضع، نقول: أنشأ الغلام يمشي؛ إذا شَرَعَ في المشي. وأنشأ الله العالم: أوجدهم. وأنشأ فلان الحديث: وضعه.
وفي اصطلاح الأدباء: هو صناعة النثر، ويُعرف بفن الكتابة؛ فهو يُقابل قرض الشعر، ويكون سجعًا، وموازن الفواصل، ومرسلًا.
فالسَّجْع: يكون ذا فِقَر مُتَّحِدة فواصلها في الحرف الأخير؛ نحو: سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ؛ فإن الفاصلتين «مرفوعة» و«موضوعة» اتَّحدتا في العين، فإن كانت ألفاظ الفقرة أو أكثرها مثل ما يُقابلها من ألفاظ قرينتها وزنًا وتقفيةً كان السجع مرصَّعًا نحو: «يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه.»
والموازن: كالسجع لكن فواصله تتحد في الوزن دُون الحرف الأخير؛ نحو: وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ * وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ؛ فإن «مصفوفة» و«مبثوثة» اتَّحدتا في الوزن دُون التقفية؛ إذ الأولى على الفاء والثانية على الثاء ولا عبرة بتاء التأنيث. وإن كانت ألفاظ إحدى القرينتين أو أكثرها مثل ما يُقابلها من الأخرى في الوزن كان الموازن مماثلًا؛ نحو: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ * وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
والمرسل: ما جاء من غير توخِّي تقفية أو وزن، وقد جاء بالثلاثة القرآن، وأحسنها المرسل؛ فإنه يمضي مع النفَس، وأسرع إلى الأفهام في أداء المعنى، فإن مُنشئ السجع قد يضطر إلى تقديم لفظ وحقه التأخير، أو الإتيان بلفظٍ لا يُوافق موضعه كي يتيسر له التقفية أو الوزن، وقد يحذف ما تضيق عبارته عنه فيأتي الكلام معقودًا ركيكًا، فإن جاءت الألفاظ فيهما على ترتيب المعاني بحيث لا يظهر على الكلام غبار التكلُّف أو القلاقة؛ فقد امتازا عن المرسل بحسن وقعهما في الأسماع، وهما لا يُوجدان في غير العربية.
قال ابن خلدون: «السجع هو الكلام الذي يُؤتى به قِطَعًا، ويُلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة، والمرسل هو الذي يطلق الكلام فيه إطلاقًا ولا يُقَطَّع أجزاءً بل يُرسل إرسالًا من غير تقييد بقافية ولا غيرها. وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في المنثور من كثرة الإسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض، وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه، ولم يفترقا إلا في الوزن، واستمروا على هذه الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطانية، وقصروا الاستعمال في المنثور كله على هذا الفن الذي ارتضوه، وخلطوا الأساليب فيه، وهجروا المرسل وتناسوه، وخصوصًا أهل المشرق، وصارت المخاطبات السُّلطانية لهذا العهد عند الكُتَّاب الغفل جاريةً على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه، وهو على صواب من جهة البلاغة لما يُلاحظ في تطبيق الكلام على مُقْتَضَى الحال من أحوال المخاطِب والمخاطَب، ويجب أن تُنَزَّه هذه المخاطبات عن هذا المنثور المقفى؛ إذ أساليب الشعر تُنافيها اللوذعية وخلط الجد بالهزل، والإطناب في الأوصاف، وضرب الأمثال، وكثرة التشبيهات والاستعارات حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك في الخطاب.
والمحمود في الخطابات السلطانية التَّرَسُّل؛ وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير تسجيع إلا في الأقل النادر وحيث تُرسله المَلَكَة إرسالًا من غير تكلُّفٍ له، أمَّا إجراؤها على هذا النحو الذي هو من أساليب الشعر فمذموم، وما حَمَلَ عليه أهل العصر إلَّا استيلاء العُجمة على ألسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحال، فعجزوا عن الكلام المرسل وأولعوا بهذا المُسجع يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود ويَجبرونه بذلك القدر من التزيين بالإسجاع والألقاب البديعة، ويغفلون عمَّا سوى ذلك، حتى إنهم يُخِلُّون بالإعراب والتصريف في الكلمات إذا دخلت لهم في تجنيس أو مُطابقة لا يجتمعان مع صحتها.» ا.ﻫ. بتصرُّف. وأحسن السجع ما تساوت فيه القرائن وقَصُرَت نحو: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ويليه ما طالت فيه القرينة الثانية عن الأولى طولًا لا يُخرجها عن الاعتدال، وعكسه غير حسن، فإن السمع يكون متوقِّعًا طول الثانية كالأولى، فإذا قَصَرَتْ نبا عنها ولم يصل إلى غايته المنتظرة.
وعلى من يريد أن يبرع في صناعة الإنشاء أن يتزوَّد من فنون الأدب، لا سيما اللغة والمحاضرات، ثُمَّ يُطالع بإمعان نظر منشآت مَن اشتهروا بالبراعة في هذه الصناعة، ثم ينثر أبياتًا شعرية أو يدرس فصولًا من كتاب ممتاز ﮐ «مقدمة ابن خلدون»، ويلخِّص هذه الفصول أو يطوي الكتاب ويكتب من تلقاء نفسه ما علق بذهنه منها، أو يأخذ مثلًا سائرًا ويبني عليه موضوعًا واسعًا، أو يكتب قصة سمعها أو يصف منظرًا رآه، وفي كل هذا يعرض ما كتبه على مُنشئ ماهر كي يرشده إلى الصواب. وبالجملة هذه الصناعة لا تصير مَلَكَة إلا بالمرانة والدُّرْبَة.
والإنشاء أنواع: منها الترسل؛ أي إنشاء الرسائل، وتسمَّى الكتب أيضًا. ومنها التحرير؛ أي كتابة دواوين الحكومات وصحف الأخبار المعروفة بالجرائد. ومنها التأليف؛ أي تصنيف كتب العلوم. ومنها القَصَص؛ أي وضع القصص أو الحكايات. ومنها الخطابة؛ أي وضع الخطب. ومنها الوصف.
تاريخ الإنشاء
كانت الرسائل تُفتَحُ في عهد النبي ﷺ والصحابة والتابعين بكتابة: «من فلان إلى فلان»، سواء كانت الكتابة من أعلى إلى أدنى، أو من أدنى إلى أعلى، أو بين متساويين، وقد يسبق ذلك: «بسم الله الرحمن الرحيم» ويليه: «السلام عليك»، أو «السلام على من اتَّبع الهُدى»، وبعد هذا: «أمَّا بعد؛ فإنَّ الأمر كيت وكيت»، أو «أمَّا بعد؛ فإني أحمد إليك الله وإن الأمر كذا وكذا.» وقد يؤخَّر السلام فيت آخر الكتاب.
وكانت عبارة الرسائل سهلة لا يُتَوَخَّى فيها السجع ولا تزيين فيها الألفاظ إلا إذا جاء ذلك عفوًا.
ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب للملوك قيل له: يا رسول الله، إنهم لا يقرءون كتابًا إلا إذا كان مختومًا. فاتَّخذ ﷺ خاتمًا من فضة منقوشًا عليه ثلاثة أسطر: «محمد» في سطر و«رسول» في الوسط و«الله» فوق ذلك، وصار يختم به كتبه، وقد اتُّخِذَ هذا سُنَّةً من بعده.
قال ابن عبد ربه في «عِقده» ما نصه: «كان رسول الله يكتب إلى الصحابة وأمراء جنوده: من مُحمَّد رسول الله إلى فُلان. وكذا كانوا يكتبون إليه يبدءون بأنفسهم. فممن كتب إليه وبدأ بنفسه أبو بكر والعلاء بن الحضرمي وغيرهما، وكذلك كُتب الصحابة والتابعين. ثم لم تزل حتى وَلِيَ الوليد بن عبد الملك فعَظَّم الكتاب وأمر أن لا يُكاتبه الناس بمثل ما يكاتب به بعضهم بعضًا، فجَرَتْ به سنة الوليد إلى يومنا هذا، إلا ما كان من عُمَر بن عبد العزيز ويزيد الكامل؛ فإنهما عملا بسنة رسول الله ﷺ، ثم رجع الأمر إلى رأي الوليد، والقوم عليه إلى اليوم.» ا.ﻫ.
ولمَّا ارتفع شأن الخلافة الإسلامية وبلغت مبلغها من العظمة والفخار واتسع مجال الأدب، اصطلحوا على ديباجات يُصَدِّرون بها كتبهم المُقَدَّمَة إلى ديوان الخلافة أو ما يتبعها؛ فكانوا يكتبون إلى الخليفة في أول الكتاب: «أدام الله بقاء الديوان العزيز، أو خلَّد سلطانه، أو نحو ذلك» وإلى الملك: «أطال الله بقاء الملك أو خلَّد الله ملكه أو ما أشبه»، وإلى الأمير: «أعزَّ الله أنصار الجانب الشريف، أو أعزَّ الله نصره أو نحوه»، وإلى الوزير: «أدام الله سعادة الوزير، أو خلَّد مجده أو أسبغ عليه نعمه أو ما شاكله»، ويدعون للقضاة والحكام بعز الأحكام وتأييدها، ثم بعد هذا الدعاء كانوا يمدحون المكتوب إليه بِعِدَّةِ أوصاف تليق بمقامه، ثم يدخلون في أغراضهم المقصودة لهم بمثل هذه العبارات الآتية: «العبد أو المملوك يُقَبِّلُ الأرض، أو الأعتاب الشريفة وينهي ما هو كذا وكذا» أو: «الخادم المطيع يُقَبِّلُ الأيدي الكريمة ويُنهي …» أو: «صنيعتكم يتشرَّف بعرض ما هو كيت وكيت»، أو «الدَّاعي ينهي ما هو …» وبعد بيان الغرض من الرسالة يختمونها بالدعاء، ويؤرِّخُونَهَا إن كانت في أول ليلة من الشهر بكتابة: «كُتِبَ لأول ليلة منه، أو لغرَّته، أو مُسْتَهَلِّه»، وفي الليلة الثانية: «كُتِبَ لِلَّيلة الثانية»، وعلى هذا القياس إلى آخر الشهر. ويكتب في الليلة الأخيرة: «لآخر ليلة منه، أو سلخه، أو انسلاخه»، وإن كتب في اليوم الأول يؤرخون بكتابة: «كُتب لليلة خلت، أو أول الشهر، أو غرَّة الشهر»، وفي الثاني: «لليلتين خَلَتَا»، وفي الثالث: «لثلاثٍ خَلَوْنَ أو خلت»، وكذا إلى «عشر ليالٍ خلون أو خلت»، وفي الحادي عشر: «لإحدى عشرة ليلة خلت أو خلون» إلى الرابع عشر فيكتبون: «لأربع عشرة ليلة خلت أو خلون»، وفي الخامس عشر «للنصف من كذا»، وفي السادس عشر: «لأربع عشرة ليلة بقيَت أو بقين» إلى التاسع عشر فيكتبون: «لإحدى عشرة ليلة بقيت أو بقين»، وفي العشرين: «لعشرِ ليالٍ بقين أو بقيت» وهكذا إلى الثامن والعشرين فيكتبون: «لليلتين بقيتا»، وفي التاسع والعشرين: «لليلةٍ بقيتْ»، وفي اليوم الأخير: «لآخر يوم من كذا أو سلخه أو انسلاخه». فالليل عندهم سابق النهار وأول الشَّهر أول ليلة يرون فيها الهلال. قال ابن عبد ربه في «عقده»: «لا بد من تاريخ الكتاب؛ لأنه لا يدل على تحقيق الأخبار وقرب عهد الكتاب وبعده إلا بالتاريخ، فإن أردت أن تؤرِّخ كتابك فانظر إلى ما مضى من الشهر وما بقي منه، فإن كان ما بقي أكثر من نصف الشهر كتبت لكذا أو كذا ليلة مضت من شهر كذا، وإن كان الباقي أقل من النصف جعلت مكان «مضت» «بَقِيَتْ». وقد قال بعض الكُتَّاب: «لا تكتب إذا أرَّخت إلا بما مضى من الشهر؛ لأنه معروف وما بقي منه مجهول».» ا.ﻫ.
وبعد التاريخ يكتبون على الرسائل أسماءهم، أو يطبعون خواتمهم. فإذا عرض الكاتب على الخليفة أو السلطان أو الأمير الرسالة المرفوعة إليه وأمره أن يكتب على حاشيتها بما يفصل في شأنها فما كتبه كانوا يسمونه توقيعًا١ ومثل هذا في عصرنا يُسمَّى شرحًا.قال ابن خلدون: «ومن خطط الكتابة التوقيع، وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه وفصله، ويوقِّع على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها متلقَّاة من السُّلطان بأوجز لفظٍ وأبلغه، فإمَّا أن تصدر كذلك وإمَّا أن يحذو الكاتب على مثالها في سِجِلٍّ يكونُ بيد صاحب القصة.» ا.ﻫ.
وقال أيضًا: «إنَّ الرسائل وغيرها في سالف العصر إلى عهد خلافة بني العباس كانت تُكتبُ في الرق المُهَيَّأ بالصناعة من الجلد، ثم طمى بحر التأليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكه وضاق الرق عن ذلك؛ فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد، وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه، واتخذه النَّاس من بعده صحفًا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية، وبلغت الإجادة في صناعته ما شاءت.» ا.ﻫ.
وقال في موضع آخر: «وكانت صناعة الكتابة عند بني العباس رفيعة، وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة ويكتب في آخرها اسمه، ويختم عليها بخاتم السلطان؛ وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته، يُغْمَسُ في طين أحمر مُذَاب بالماء ويسمَّى طين الختم، ويُطبع به على طرفي السِّجل عند طيِّه وإلصاقه، ثُمَّ صارت السجلات من بعدهم تصدر باسم السلطان ويضع الكاتب فيها علامته أولًا وآخِرًا.» ا.ﻫ. وقال أيضًا: «وأمَّا الخاتم فهو من الخطط السُّلطانية والوظائف الملوكية، والختم على الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل الإسلام وبعده، وقد ثَبت في الصحيحين أنَّ النبي ﷺ أراد أن يكتب إلى قيصر، فقيل له: إن العجم لا يقبلون كتابًا إلا أن يكون مختومًا. فاتَّخذَ خاتمًا من فضة ونقش فيه «محمد رسول الله». قال البخاري: جعل الثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وختم به، وقال: لا ينقش أحد مثله. قال: وتَخَتَّمَ به أبو بكر وعمر وعثمان، ثم سقط من يد عثمان في بئر أريس، وكانت قليلة الماء فلم يدرك قعرها بعد، واغتمَّ عثمان وتطيَّر منه وصنع آخر على مثله.
وفي كيفية نقش الخاتم والختم به وجوه؛ وذلك أنَّ الخاتم يُطلق على الآلة التي تُجعل في الإصبع، ومنه: تَخَتَّم؛ إذا لبسه. ويُطلق على النهاية والتمام، ومنه: ختمت الأمر؛ إذا بلغت آخره، وختمت القرآن كذلك. ومنه: خاتم النبيين، وخاتم الأمر. ويطلق على السِّدَّاد الذي يُسدُّ به الأواني والدنان ويقال فيه ختام، ومنه قوله تعالى: خِتَامُهُ مِسْكٌ، وقد غلط من فسَّر هذا بالنهاية والتمام، قال: لأن آخر ما يجدونه في شرابهم ريح المسك، وليس المعنى عليه وإنما هو من الختام الذي هو السِّدَّاد؛ لأنَّ الخمر يُجعَل لها في الدن سِداد الطين أو القار يحفظها ويطيِّب عَرفها وذوقها، فبُولِغَ في وصف خمر الجنة بأنَّ سِدَّادها من المسك، وهو أطيب عَرفًا وذوقًا من القار والطين المعهودَيْن في الدنيا. فإذا صحَّ إطلاق الخاتم على هذه كلها صحَّ إطلاقه على أثرها الناشئ عنها؛ وذلك أن الخاتم إذا نُقشت به كلمات أو أشكال ثم غُمِسَ في مداف من الطين أو مداد ووقع على صفح القرطاس بقي أثر الكلمات في ذلك الصفح، وكذلك إذا طبع به على جسمٍ ليِّنٍ كالشمع فإنه يبقى نقش ذلك المكتوب مُرتَسِمًا فيه. وإذا كانت كلمات وارتسمت فقد يُقرأ من الجهة اليسرى إذا كان النقش على الاستقامة من اليمنى، وقد يُقرأ من الجهة اليمنى إذا كان النقش من الجهة اليسرى؛ لأن الختم يقلب جهة الخط في الصفح عمَّا كان في النقش من يمين أو يسار، فيحتمل أن يكون الختم بهذا الخاتم بغمسه في المداد أو الطين ووضعه على الصفح فتُنقش الكلمات فيه ويكون هذا من معنى النهاية والتمام، بمعنى صحة ذلك المكتوب ونفوذه، كأن الكتاب إنما يتم العمل به بهذه العلامات وهو من دونها مُلغًى ليس بتمام …»
وأما الرسائل التي كانت سائرة بينهم فكانوا يبتدئونها بما يعنُّ لهم مع مراعاة حال المكتوب إليه، فبعضهم كان يبتدئ بنحو: «كتابي إلى فلان أطال الله بقاءه»، أو: «كتابي إلى ولدي العزيز أمتع الله به»، أو: «إلى فلان التاجر أدام الله إقباله»، ثم يقول: «وبعد؛ فكيت وكيت»، ثم ينهي الرسالة بقوله: «والسلام». وبعضهم كان يبتدئ بالسلام والتحية ويبالغ في وصفها، ثم يقول: «نخصُّ بذلك فلان» ويمدحه ويدعو له ثم يقول: «وبعد؛ فالأمر ما هو كذا وكذا»، ثم يُتم الكتاب بما يُشعر بالانتهاء، ويُؤرِّخون الرسائل ويوقِّعون عليها كما سبق.
وكانوا يتوخَّون في هذه الرسائل السجع وتحسين الألفاظ، لكن بعضهم كان يطنب في صدور الكتب ويُبالغ في مدح المكتوب إليه ويُوجز في الغرض المقصود، وهذا غير حسنٍ في زماننا؛ ولهذا اختاروا الآن في صدور الكتب الرسمية والأهلية ديباجات مُختصرة يتلوها الغرض المقصود.
أمَّا الكتب الرسمية في مصر — وإن شئت قلت: الرسائل بين موظفي الحكومة أو كما يقولون الإفادات أو الجوابات — فديباجاتها عربية مشوبة بالتركية، مع أن عبارات الرسائل نفسها عربية محضة، فيكتبون:- لجلالة السلطان: شوكتلو ولي النعم أفندمز حضرتلريناه.
- وللحضرة الفخيمة الخديوية: دولتلو فخامتلو خديوِ مصر أفندمز حضرتلري.
- وللصدر الأعظم: دولتلو فخامتلو صدر أعظم أفندم حضرتلري.
- ولشيخ الإسلام: دولتلو سماحتلو أفندم حضرتلري.
- وللسر عسكر: دولتلو عطوفتلو أفندم حضرتلري.
- وللمشير: دولتلو أفندم حضرتلري.
- ولذي الرتبة الأولى من الصنف الأول: عطوفتلو أفندم حضرتلري.
- ولذي الرتبة الأولى من الصنف الثاني: سعادتلو أفندم حضرتلري.
- ولذي الرتبة الثانية من الصنف الأول: عزتلو أفندم.
- ولذي الرتبة الثانية من الصنف الثاني: عزتلو أفندي أو بك.
- ولذي الرتبة الثالثة: رفعتلو أفندي أو بك.
- ولذي الرتبة الرابعة: فتوتلو أفندي.
- ولذي الرتبة الخامسة: حميتلو أفندي.
وجاء هذا من دخول مصر في حوزة الأتراك. ويمكن الاصطلاح على ديباجات عربية خالصة تُوازي هذه، وقد أخذ بعض الناس في ذلك الآن فكتبوا بدل «دولتلو فخامتلو» صاحب الدولة والفخامة، وبدل «أفندمز» مولانا وغير ذلك.
وبعد هذه الديباجات يدخلون على المقاصد بعبارات وجيزة تليق بالمكتوب إليه مثل: «يَرفع هذا للسدة الكريمة العبد الخاضع فلان وينهي …» أو: «أتشرف برفع هذا للمقام العالي وأنهي …» أو: «أعرض على مسامع دولتكم ما هو …» أو: «أُحيط عطوفتكم علمًا بما هو …» أو: «أقدم هذا لسعادتكم راجيًا كذا» أو: «ألتمس من عزتكم كيت وكيت» أو: «أبدي لحضرتكم كذا» وعلامة الانتهاء كلمة «أفندم».
ويؤرخونها بالتاريخ العربي والإفرنجي معًا، ويضعونه أسفل الرسالة. والمستعمل الآن في التاريخ أن يكتب عدد ما مضى من أيام الشهر بالرقم وبعده اسم الشهر ثم اسم السنة، وفوقها ما يدل عليها من الأرقام، فيكتب مثلًا: «٢٥ شعبان سنة ١٣١٤».
ثم يكتبون أسماء وظائفهم ويختمون تحتها. وإن اقتصر المرسل على كتابة الاسم سموا ذلك إمضاءً، ويسمون آلة طبع الاسم ختمًا لا خاتمًا.
وإن كانت الرسائل الرسمية جوابًا عن أخرى ابتدءوها بعد الديباجات بنحو: «طبقًا للأمر الصادر في كذا نمرة كذا أو أمر دولتكم» أو: «بناءً على أمر عطوفتكم أو سعادتكم» أو: «بناءً على ما ورد إلينا من عزتكم» أو: «حيث إن حضرتكم طلبتم كذا».
وأما الرسائل الأهلية الآن فيكتبون في صدورها مثل: «حضرة الفاضل أو الكامل أو الأديب أو المحترم أو العزيز أو الأخ أو صديقنا أو السيد فلان دام بقاؤه أو لا زال ملحوظًا بعين العناية أو نحو ذلك». وقد يجمع الكاتب بين وصفين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يذكرون عبارات تُفيد إهداء التحية والسلام إلى المكتوب إليه، ثم يدخلون في الأغراض ويتمِّمُون الكتاب بنحو: «اقبلوا فائق احترامي، والسلام». ويؤرخونها بالتاريخ العربي أو الإفرنجي، وبعضهم يكتبه أسفل الرسالة وبعضهم يكتبه أعلاها كعادة الإفرنج، ويمضونها بكتابة: «عبدكم فلان أو الخاضع المطيع أو محسوبكم أو صديقكم أو المحب المخلص أو والدكم أو أخوكم أو الفقير إليه تعالى أو الحقير أو نحو ذلك». ومع هذا قد مال أغلب الناس إلى ترك مثل هذا واقتصروا على كتابة الاسم مجرَّدًا أو ختمه.
وبعد إنهاء الرسالة رسميةً أو أهليةً تُوضع في غلاف يُسمَّى «ظرفًا» مصنوعًا على صورتها بعد طيِّها، وأطراف الظروف مصمغة فتُبَلُّ ويُلصق بعضها ببعض، ويُكتب عليه عنوان المكتوب إليه، وهو الديباجة المصدرة بها الرسالة.
وعبارة الرسائل الرسمية والأهلية سهلة لا يُتوخَّى فيها السجع، إلا أن أدباء عصرنا يحذون في رسائلهم حذو أدباء السلف ليظهروا فضل أدبهم.
ومن أشهر ما كُتب في الرسائل: رسائل أبي الفضل أحمد بن الحسين المعروف ببديع الزمان الهمذاني، المتوفى سنة ٣٩٣، وقد طُبعت بمطبعة الجوائب سنة ١٢٩٨، وقد كَتَبَ عليها شرحًا مفيدًا الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسي، وطُبع هذا الشرح سنة ١٨٩٠ للميلاد في بيروت. ورسائل أبي بكر الخوارزمي، وكان مُعاصرًا للبديع، وقد طُبعت بمطبعة الجوائب سنة ١٢٩٧. ورسالة أبي الوليد أحمد المعروف بابن زيدون الأندلسي المتوفى بإشبيلية سنة ٤٦٣، وقد أنشأها على لسان ولَّادة بنت المستكفِي في هجاء الوزير أبي عامر بن عبدوس الملقب بالفار، وعليها شرح جليل لأبي بكر محمد بن نباتة المتوفى سنة ٧٦٨ يُعرف ﺑ «سرح العيون».
ومما ساعد على تقدم صناعة الإنشاء في عصرنا هذا (سنة ١٣١٤ للهجرة) صُحُف الأخبار الحاضرة المعروفة بالجرائد، وإنشاؤها في الجملة مرسل حسن يفهمه العوام ويرضاه الخواص. وأقدم الجرائد العربية المنتشرة الآن في مصر الجريدة الرسمية المعروفة ﺑ «الوقائع المصرية»؛ فإن إنشاءها كان منذ ستٍّ وستين سنة في عهد المغفور له محمد علي باشا، ثمَّ جريدة «الأهرام» التي أُنشئت من نحو ٢٢ سنة وصاحبها الفاضل «تقلا باشا»، ثمَّ جريدة «الوطن» ومحررها الفاضل «ميخائيل أفندي عبد السيد»، وكلتاهما ظهرت في عهد المغفور له إسماعيل باشا خديوِ مصر، ثم جريدة «المقطَّم» التي أنشئت منذ تسع سنين، ومنشئوها الأفاضل: يعقوب أفندي صروف وفارس أفندي نمر وجاهين أفندي مكاريوس، ثم جريدة «المؤيد» وصاحبها الفاضل الشيخ علي يوسف وعمرها نحو ثماني سنين، وكلتاهما ظهرت في عهد المغفور له محمد باشا توفيق خديوِ مصر.
وأما كتب العلوم فسير التأليف فيها لم يتغير عمَّا كان عليه في العصر السالف، اللهم إلا من جهة حسن الوضع والترتيب والتقريب إلى الأذهان. ومن عاداتهم أن يبتدئوها بخُطب مفتتحة بالبسملة والحمدلة والصلاة والتسليم، ثُمَّ يقولون: وبعدُ؛ فكذا وكذا، ويُبَيِّنون الغرض من تأليف الكتاب، وقد يذكرون فيه اسم الخليفة أو الملك أو الأمير الذي أُلِّف في عصره هذا الكتاب. وبعض معاصرينا لا يستحسنون ذلك وفاتهم أنَّ هذا مفيد في تاريخ العلوم. وفي هذه الخطب المؤلفون يُظهرون براعتهم في الإنشاء، ويتوخون فيها تهذيب الكلام وتحسينه بأنواع البديع كبراعة الاستهلال والسجع والجناس، ولهذا أفرد العلماء بعض خطب المصنفات بالشروح.
وأما القصص فمنها ما له خارج يُطابقه فيكون من علم التاريخ، ومنها ما هو حكايات مُخترعة وُضعت لتسلية النفوس وقت الفراغ ككتاب «ألف ليلة وليلة»، وهذا النوع يُعرف الآن بالروايات، وقد أكثر من التصنيف فيه معاصرونا اقتداءً بالإفرنج، فإنهم في هذا الفن قد حازوا قصبات السبق.
ومن الحكايات الموضوعة «المقاماتُ الأدبية» التي قَصد بها منشئوها جمع مواد لغوية في حكايات لطيفة حسنة الأسلوب، يرغب فيها طالب الأدب ويسهُل عليه حفظها ويتعرَّف منها أساليب الإنشاء، ﮐ «مقامات أبي الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني» المعروف ببديع الزمان المتوفى سنة ٣٩٣، نسب روايتها إلى عيسى بن هشام، ومبنى حديثها إلى أبي الفتح الإسكندري وكلاهما اخترعه وهمه وخياله. وقد طُبعت هذه المقامات سنة ١٢٩٣ بمطبعة الجوائب، وهي إحدى وخمسون مقامة، وقد شرحها شرحًا لطيفًا الفاضل الشيخ محمد عبده، وقد طبع هذا الشرح في بيروت سنة ١٨٨٩ للميلاد.
و«مقامات أبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري» المتوفى سنة ٥١٦ بالبصرة، قال في خطبتها: «وبعد؛ فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه، ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان وعلَّامة همذان — رحمه الله — وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها، وإلى عيسى بن هشام روايتها وكلاهما مجهولٌ لا يُعرف ونكرة لا تتعرف، فأشار مَن إشارته حكم وطاعته غُنم إلى أن أُنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع، وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع …» إلى أن قال: «وأنشأت خمسين مقامة تحتوي على جِد القول وهزله، ورقيق اللفظ وجزله، وغرر البيان ودرره، ومُلَح الأدب ونوادره، إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات ورصعتُهُ فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاجي النحوية والفتاوي اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري …» إلى أن قال: «ومَن نقدَ الأشياء بعين المعقول، وأنعم النظر في مباني الأصول، نظم هذه المقامات في سلك الإفادات، وسلكها مسلك الموضوعات عن العجماوات والجمادات، ولم يسمع بمن نبا سمعه عن تلك الحكايات أو أثَّم رُواتِها في وقت من الأوقات … فأي حرج على من أنشأ مُلحًا للتنبيه لا للتمويه، ونحا بها منحى التهذيب لا الأكاذيب؟! وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب لتعليم أو هُدِيَ إلى صراط مستقيم؟!» ا.ﻫ. وقد طُبعت في بولاق سنة ١٣٠٠ للهجرة، وكثير من طلاب الأدب يحفظونها أو بعضها. وقد علَّق الأدباء عليها شروحًا كثيرة من أشهرها الشروح الثلاثة لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي المتوفى سنة ٦١٩، وقد طُبع منها: «الشرح الكبير» في سفرين بمطبعة بولاق سنة ١٣٠٠.
و«مقامات جمال الدين أبي الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي» المعروف بابن الإشتركوني المتوفى سنة ٥٣٨، وهي خمسون مقامة أنشأها بقرطبة على منوال «مقامات الحريري»، والتزم فيها ما لا يلزم؛ ولذا تُعرف ﺑ «المقامات اللزومية»، وحدَّث فيها المنذر بن حمام عن السائب بن تمام.
و«المقامات الزينبية» لشمس الدين أبي الندى معد ابن أبي الفتح المعروف بابن صيقل الجزري المتوفى سنة ٧٠١، وهي خمسون مقامة على منوال «مقامات الحريري»، نسبها إلى أبي نصر المصري وعزا روايتها إلى القاسم بن جربال الدمشقي. و«مجمع البحرين» وهو ستون مقامة على منوال «مقامات الحريري»، أنشأها الشيخ ناصيف اليازجي المتوفى سنة ١٢٨٧، وقد طُبعت ببيروت سنة ١٨٥٦ وسنة ١٨٧٢ للميلاد.
وفي كتابي «قلائد الذهب في فصيح لغة العرب» أنشأتُ في ألفاظ مادة «جلل» مقامةً على منوال «مقامات الحريري»، التزمت في كل سجعة منها أن آتي بكلمة من هذه المادة وتعرف ﺑ «المقامة الجلالية»، وسيأتي ذكرها في الفصل الثالث.
وأما الخطب فلا تزال أحوال الناس في كل عصرٍ تدعو إلى قيام نبلائهم ليخطبوا فيهم بما يُقَوِّم معوجهم أو يُرشدهم إلى ما فيه صلاحهم أو يعظهم الموعظة الحسنة أو يستفزَّهم إلى خير أو يُثبطهم عن ضير أو نحو ذلك. وكان الخطباء في العصرِ السَّالف يخطبون ارتجالًا في الأحوال القائمة بينهم، وقبل الإسلام كانت لهم أسواق يُلقُون فيها الخطب، وبعده كانوا يلقونها في المحافل والمساجد. وفي عصرنا هذا الخطب الدينية مدوَّنة يحفظها الخطباء ويُلقونها كما هي أيام الجُمَع على المصلين وقت الظهر، وهذه الخطب تُسمَّى ﺑ «المنبرية»؛ لأنهم يُلقونها وهم على المنابر. وكثير من العلماء صنَّف لكل جمعة من كل شهر خطبة خاصة بها، ومُصنفات الخطب تُعرف ﺑ «الدواوين»، فإذا اتَّبع خطيب مسجد ديوان خطب خاص؛ تكرَّرت الخطبة الواحدة قدر سني الخطابة.
هذا، وقد جمع السيد المرتضى أبو القاسم على بن الطاهر المتوفى سنة ٤٣٦ ببغداد المختار من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الخطب والرسائل والحكم في كتابٍ سماه «نهج البلاغة» قال في خطبته: «وقد رأيت كلامه عليه السلام يدور على أقطابٍ ثلاثة؛ أولها: الخطب والأوامر، وثانيها: الكتب والرسائل، وثالثها: الحكم والمواعظ.» وعلى هذا النهج شرحٌ لطيف للقاضي الفاضل الشيخ محمد عبده، طُبع في بيروت سنة ١٨٨٥ للميلاد.
ولأبي يحيى عبد الرحيم المعروف بابن نباتة خطيب حلب المتوفى سنة ٣٧٤ بميافارقين «ديوان خطب أدبية» عليه شروح كثيرة، منها شرح لعبد اللطيف البغدادي المتوفى سنة ٦٢٩، ومنها شرح الشيخ طاهر أفندي الجزائري، من أفاضل هذا العصر، وقد طبع هذا الشرح مع الخطب في بيروت سنة ١٣١١. وابن نباتة هذا اجتمع مع المتنبي في خدمة سيف الدولة بن حمدان.
وينخرط في سلك الخطب مقالات الزمخشري المعروفة ﺑ «أطواق الذهب في المواعظ والخطب»، طُبِعَت في بيروت في مطبعة جمعية الفنون سنة ١٢٩٣، وعليها شرح لطيف للشيخ الفاضل يوسف أفندي الأسير. و«مقامات الزمخشري» الوعظية، وقد طُبعت بالمطبعة العباسية بمصر سنة ١٣١٢، وعليها شرح له. و«مقالات عبد المؤمن» المغربي الأصفهاني المعروفة ﺑ «أطباق الذهب»، قد سلك فيها مسلك الزمخشري في «أطواقه»، وقد طُبعت بدار الطباعة ببولاق سنة ١٢٨٠ للهجرة.
ومن دواوين الخطب المنبرية ديوان شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري المتوفى سنة ٩٢٦، ويُسمَّى ﺑ «التحفة العلية في الخطب المنبرية». وديوان الشيخ إبراهيم السقا الأزهري، المتوفى سنة ١٢٩٨، ويُسمَّى «غاية الأُمنية في الخطب المنبرية». وديوان الفاضل السيد محمد الببلاوي وكيل المكتبة الخديوية، وقد طُبع هذه السنة (سنة ١٣١٤) بمطبعة بولاق.
وأمَّا الوصف فطريقة كتابة السلف والخلف فيه كطريقتهم في غيره من حيث ابتكار المعاني وحسنها وتسجيع الكلام وإرساله، إلا أنَّ تَجدُّدَ المرثيات المبتدعة مع العصور المتوالية والأمكنة المختلفة جعلت صور الإنشاء فيها بديعة الآن عمَّا كانت عليه قبل، فالحضارة والإقليم لهما تأثير عظيم على الوصف الكتابي كتأثيرهما على الشعر، وهذا النوع من أهم أنواع الإنشاء، وفيه تتفاوت أقدار المنشئين، وقد عُني به الإفرنج كثيرًا تبعًا لمدنيتهم.