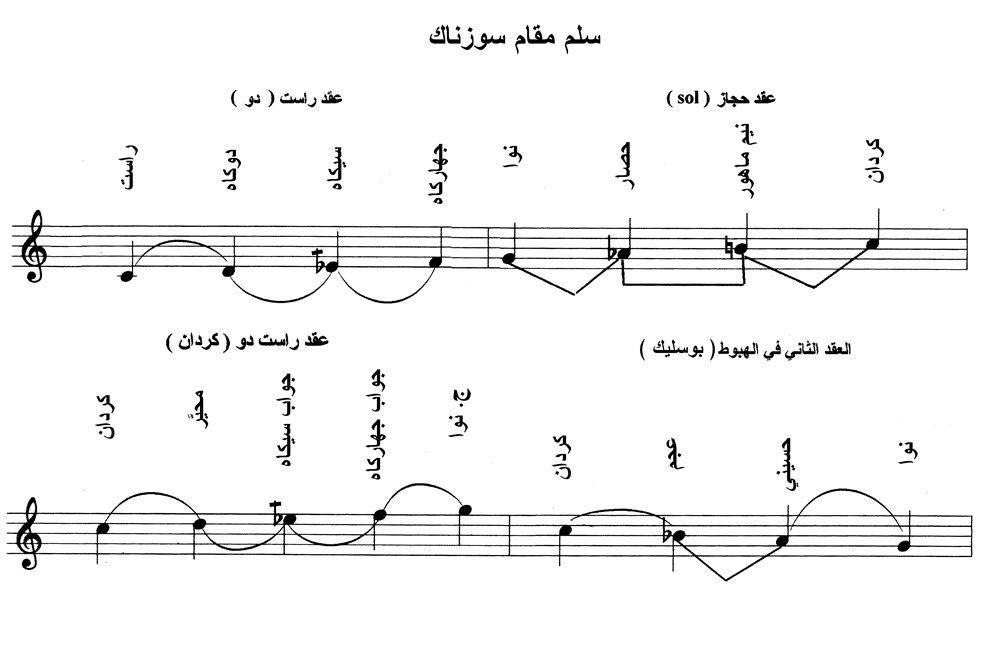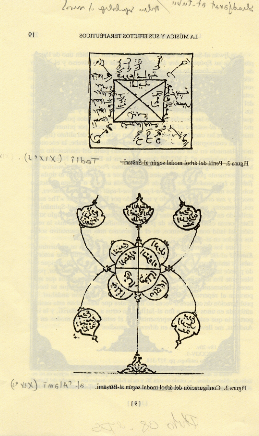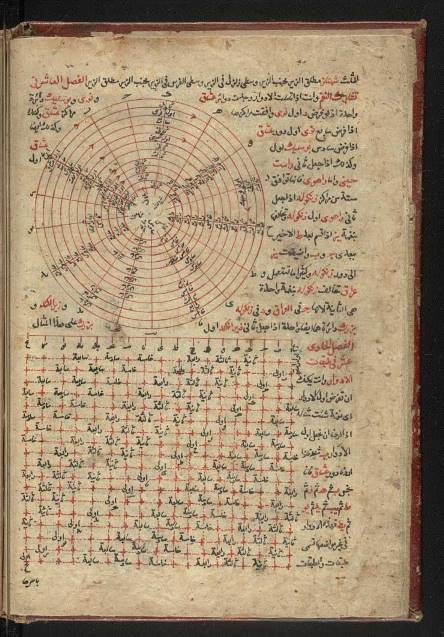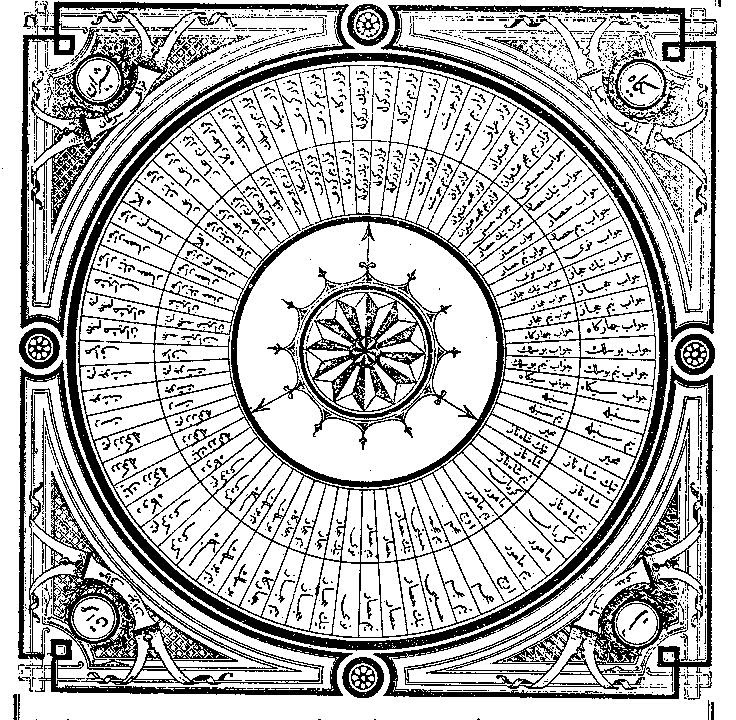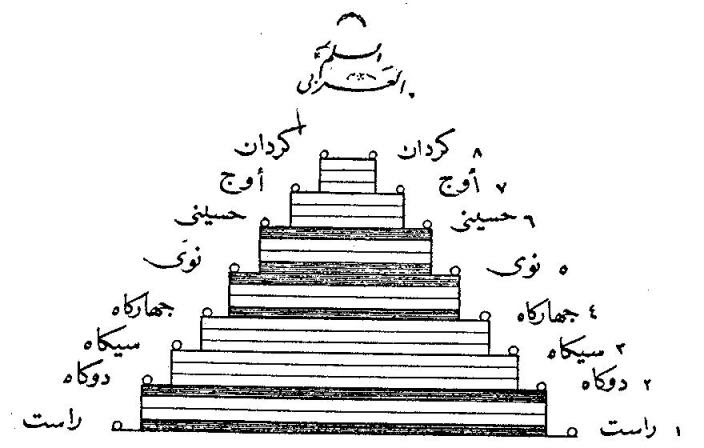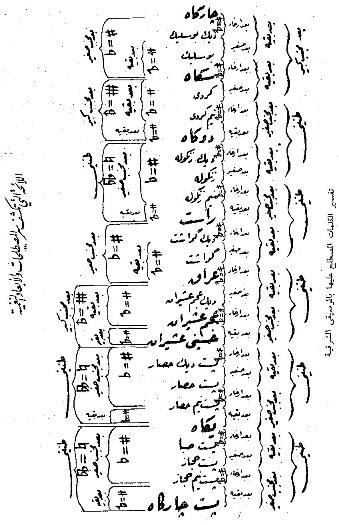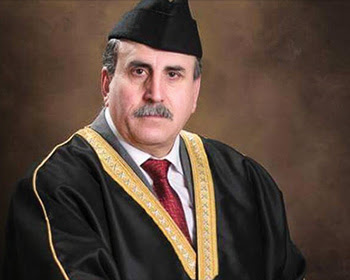علمي المقامات العربية
اللحن والإيقاع

{وَإِنْ
كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا
لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا}[الإسراء : 76]
{سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا}[الإسراء : 77]
***
{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [فصلت : 26]
{وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} [الأنفال : 35]
{لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً} [الغاشية : 11]
***
{وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 30]
******
{وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ}[لقمان : 19]
{وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا}[الإسراء : 64]
{اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا}[فاطر : 43]
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [لقمان :6، 7]
{قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام : 151]
{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف : 33]
{وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [الشورى : 37]
{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم : 32]
*****
{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ}[الأنعام : 73]
{وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا}[الكهف : 99]
{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا}[طه : 102]
{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ}[المؤمنون : 101]
{وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ}[النمل : 87]
{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ}[يس : 51]
{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ}[الزمر : 68]
{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ}[ق : 20]
{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}[الحاقة : 13]
{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا}[النبأ : 18]
{وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [الرعد : 31]
{كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ} [الحاقة : 4]
{الْقَارِعَةُ} [القارعة : 1]
{مَا الْقَارِعَةُ} [القارعة : 2]
{وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ} [القارعة : 3]
*****
{يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا} [طه : 108]
*****
{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان : 32]
{أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل : 4]
{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} [الزمر : 23]
{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}[الرعد : 28]
{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}[الحج : 32]
{وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ} [النمل : 88]
*****
الموسيقى
الموسيقى معناه تأليف الألحان واللفظة يونانية وسمى المطرب ومؤلف الألحان: الموسيقور والموسيقار.
الفصل الأول: في أسامي الآلات وما يتبعها
الأرغانون: آلة لليونانيين والروم تعمل من ثلاثة زقاق كبار من جلود الجواميس يضم بعضها إلى بعض ويركب على رأس الزق الأوسط زق كبير ثم يركب على هذا الزق أنابيب صفر لها ثقب على نسب معلومة يخرج منها أصوات طيبة مطربة مشجية على ما يريد المستعمل.
الشلياق: آلة ذات أوتار لليونانيين والروم تشبه الجنك.
اللور هو الصنج باليونانية.
القيتارة: آلة لهم تشبه الطنبور.
الطنبور الميزاني: هو البغدادي الطويل.
العنق: الرباب معروف لأهل فارس وخراسان.
المعزفة: آلة ذات أوتار لأهل العراق.
المستق: آلة للصين تعمل من أنابيب مركبة واسمها بالفارسية: بيشه مشته.
الناي: المزمار.
السرناي هو الصفارة وكذلك اليراع.
شعيرة المزمار: رأسه الذي يضيق به ويوسع.
الصنج بالفارسية: جنك وهو ذو الأوتار.
قال الخليل: الصنج عند العرب هو الذي يكون في الدفوف يسمع له صوت كالجلجل فأماذو الأوتار فهو دخيل معرب وقيل ذو الأوتار إنما هو الونج.
الشهروذ: آلة محدثة أبدعها حكيم بن أحوص السفدي ببغداد في سنة ثلاثمائة للهجرة.
البربط هو العود والكلمة فارسية وهي بريت أي صدر البط لأن صورته تشبه صدر البط وعنقه.
أوتاد العود الأربعة أغلظها: البم والذي يليه المثلث بفتح الميم وتخفيف اللام على مثال مطلب والذي يلي المثلث المثنى بفتح الميم وتخفيف النون على تقدير: معنى ومغزى والرابع هو الزير وهو أدقها.
الملاوي: التي تلوى بها الأوتار إذا سويت.
الدساتين هي الرباطات التي توضع الأصابع عليها واحدها دستان.
الدستان أيضاً اسم لكل لحن من الألحان المنسوبة إلى باربد.
وأسمى دساتين العود تنسب إلى الأصابع التي توضع عليها فأولها: دستان السبابة ويشد عند تسع الوتر وقد يشد فوقه دستان أيضاً يسمى: الزائد.
ثم يلي دستان السبابة: دستان الوسطى وقد يوضع أوضاعاً مختلفة،
فأولهما يسمى دستان الوسطى القديمة والثاني يسمى: وسطى الفرس والثالث يسمى: دستان وسطى زلزل وزلزل هذا أول من شد الدستان وإليه تنسب بركة زلزل ببغداد.
فأما الوسطى القديمة فشدد دستانها على قريب من الربع مما بين دستان السبابة ودستان البنصر.
ودستان وسطى الفرس على النصف فيما بينهما على التقريب.
ودستان وسطى زلزل على ثلاثة أرباع ما بينهما إلى ما يلي البنصر بالتقريب.
وقد يقتصر من دساتين هذه الوسطيات على واحد وربما يجمع بين اثنين منها.
ثم يلي دستان الوسطى دستان البنصر ويشد على تسع ما بين دستان السبابة وبين المشط.
ثم يلي دستان البنصر: دستان الخنصر ويشضد على ربع الوتر.
مشط العود هو الشبية بالمسطرة التي تشد عليها الأوتار من تحت أنف العود وهو مجمع الأوتار من فوق.
الابريق: اسم لعنق العود بما فيه من الآلات.
عينا العود هم النقبتان اللتان على وجهه.
المضراب هو الذي يضب به الأوتار.
الجس هو نقر الأوتار بالسبابة والإبهام دون المضراب يشبه ذلك بجس العرق.
الخرق: هو مد الوتر ونقيضه الإرخاء.
والحط: نغمة مطلق البم عند نغمة سبابة المثنى على التسوية المشهورة هي سجاحها.
ونغمة سبابة المثنى صياح نغمة مطلق البم.
وكذلك سبابة البم: سجاح وبنصر المثنى صياح وكذلك كل نغمتين على هذا البعد تسمى الثقيلة منهما: سجاحاً والحادة صياحا وتنوب إحداهما عن الأخرى لاتفاقهما.
ويسمى السجاح: الاسجاح.
والصياح الصيحة والاضعاف.
والصحيح السجاح دوبد الاسجاح.
الفصل الثاني: في جوامع الموسيقى
النغمة: صوت غير متغير إلى حدة ولا ثقل مثل مطلق البم أو غيره من الأوتار إذ انقر أو مثل البم وغيره من الأوتار إذا وضعت إصبع على أحد دساتينه ثم نقر.
والنغم للحن بمنزلة الحروف للكلام منه يتركب وإليه ينحل.
البعد: صوت يبتدأ فيه بنغمة ويثنى فيه بنغمة أخرى.
الجمع: جماعة نغمات يؤلف منها لحن.
مراتب حدة الصوت أو ثقله تسمى الطبقات.
والعودان يستويان على طبقة واحدة إذا حركا معا وكذلك غيرهما من المعازف.
البعد ذو الكل ويسمى أيضاً: الذي بالكل هو الذي من مطلق البم إلى سبابة المثنى في العود والذي من سبابة البم إلى بنصر المثنى وكذلك ما بين كل نغمتين إحداهما سجاح والأخرى صياح.
وهو في الوتر الواحد إذا نقر مطلقاً: سجاح وإذا زم على نصفه ثم نقر فهو صياح لذلك المطلق.
والبعد ذو الخمس ويسمى أيضاً الذي بالخمسة هو مثل ما بين مطلق البم إلى سبابة المثلث وفي الوتر الواحد إذا نقر مطلقاً ومزموماً على ثلاثة.
والبعد ذو الأربع ويسمى أيضاً: الذي بالأربعة هو ما بين مطلق البم إلى خنصره وهو ربع الوتر أعني إذا نقر مطلقاً ثم زم عند ربعه ونقر فإن ما بين النغمتين هو البعد ذو الأربع وإنما سمي ذا أربع لأن فيه أربع نغمات وهي نغمة المطلق ونغمة السبابة ونغمة البنصر ونغمة الخنصر لأنه لا يجتمع فيه أصل لحن نغمتا الوسطى والبنصر.
وسمي البعد ذو الخمس بذلك لأن فيه خمس نغمات الأربع المذكورة وسبابة المثلث.
أما نغمة مطلق المثلث فإنها ونغمة خنصر البم واحدة لأن العود هكذا يسوى.
البعد الطنيني والمدة والعودة: هو ما بين المطلق والسبابة وهو يفصل تسع الوتر وكذلك ما بين السبابة والبنصر.
والفضلة والبقية هي ما بين البنصر والخنصر أو ما بين السبابة والوسطى أو ما بين السبابة ووسطى الفرس وهو نصف المدة بالتقريب.
الإرخاء هو نصف الفضلة بالتقريب.
الاجناس ثلاثة:
أحدها: الطنين ويسمى: القوي والمقوي وهو أن يقسم البعد ذو الأربع بمدة ومدة ونصف مدة مثل نغمة المطلق ثم السبابة ثم البنصر ثم الخنصر.
الجنس الثاني: اللوى والملون وهو أن يقسم البعد ذو الأربع بنصف مدة ونصف مدة وثلث مدة وثلاثة أنصاف مدة.
والجنس الثالث ويسمى التأليفي والناظم والراسم وهو أن يقسم البعد ذو الأربع بربع مدة وربع مدة ومدتين فالأول أفحلها يحرك النفس إلى النجدة وشدة الانبساط والجطرب ويسمى: الرجلي.
بين الانقباض ويحركها للكرم والحرية والجراءة. ويسمى: الخنثوي.
والثالث يولد الشجا والحزن وانقباض النفس ويسمى: النسوي.
النغم التي في ضعف ذي الكل المطلق الذي هو من مطلق البم في العود إلى دستان بنصر وترخامس يعلق فيه تحت الزير على تسوية سائر أوتاره وهي خمس عشرة نغمات.
أولاها وهي مطلق البم تسمى: ثقيلة المفروضات.
والثانية: ثقيلة الريسات ثم واسطة الريسات ثم حادة الريسات ثم ثقيلة الأوساط ثم واسطة الأوساط ثم حادة الأوساط ثم الوسطى ثم فاصلة الوسطى ثم ثقيلة المنفصلات ثم واسطة المنفصلات ثم حادة المنفصلات ثم ثقيلة الحادات ثم واسطة الحادات ثم حادة الحادات.
الفصل الثالث: في الايقاعات المستعملة
الإيقاع هو النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادير.
والنسب: أصناف وأنواع.
الإيقاعات العربية أولها: الهزج وهو الذي تتوالى نقراته نقرة نقرة وهذا رسمه تن تن تن تن تن تن تن.
والثاني: خفيف الرمل وهو الذي تتوالى نقراته نقرتين نقرتين خفيفتين وهذا رسمه: تن تن, تن تن, تن تن, تن تن.
الثالث: الرمل ويسمى: ثقيل الرمل وهو الذي إيقاعه نقرة واحدة ثقيلة ثم اثنتان خفيفتان وهذا رسمه تن, تن تن, تن, تن تن تن, تن تن, تن.
والخامس: خفيف الثقيل الثاني ويسمى الماخوري وهو نقرتان خفيفتان ثم واحدة ثقيلة وهذا رسمه: تن تن, تن تن تن, تن.
السادس: الثقيل الأول وهو ثلاث نقرات متوالية ثقال ورسمه: تن تن تن, تن تن تن.
والسابع: خفيف الثقيل الأول وهو ثلاث نقرات متوالية أخذ من نقرات الثقيل الأول وهذا رسمه: تن تن تن تن تن تن.
المصطلحات الموسيقية
مصطلحات الموسيقا العربية القديمة
1- بعد البقية: هو أصغر الألحان اللحنية، ومسافته كل وثلاثة عشر جزءا من مئتين وثلاثة وأربعين 256/243.
2- بعد المجنب: ونسبته كل وتسع كل 10/9 إذا كان كبيرا، وجزء من خمسة عشر جزءا من كل 16/15 إذا كان صغيرا.
3- البعد الطنيني: هو حبس تسع الوتر واهتزاز ثمانية، اتساعه ونسبته كل وثمن كل 9/8.
4- بعد ذي الربع: ونسبته كل وثلث كل وهو حبس الوتر واهتزاز ثلاثة أرباعه 4/3، وسمي بذي الأربع لاحتوائه على أربع نغمات محيطة بثلاثة أبعاد في أكثر الأحيان، ويسمى عند الافرنج (تتراكورد) .
5- بعد ذي الخمس: ونسبته كل ونصف كل 3/2 وهو حبس ثلث الوتر واهتزاز ثلثيه، وسمي بذي الخمس لاحتوائه في أكثر الأحيان على خمس نغمات محيطة بأربعة أبعاد، ويسمى عند الإفرنج (بنتراكورد) .
6- بعد ذي الكل: هو الديوان الموسيقي (الأوكتاف) ونسبته نسبة الضعف 2/1 ويتكون من بعد ذي الأربع وبعد طنيني يسمى (الفاصلة) ، أو من بعد ذي الأربع وذي الخمس، وهو حبس نصف الوتر واهتزاز نصفه الآخر.
7- بعد ذي الكل والأربع: ونسبته نسبة الضعف والثلثين 8/3 وهو حبس ثلاثة أخماس الوتر واهتزاز خمسيه، ويتألف من بعد ذي الكل وذي الأربع.
8- بعد ذي الكل والخمس: ونسبته ثلاثة الأمثال 3/1 وهو حبس ثلثي الوتر واهتزاز ثلثه الآخر، ويتألف من بعد ذي الكل وبعد ذي الخمس.
9- بعد ذي الكل مرتين وهو ديوانان موسيقيان، ونسبته نسبة أربعة الأمثال 4/1، وهو حبس ثلاثة أرباع الوتر واهتزاز ربعه الآخر.
10- بعد ذي الكل ثلاث مرات: وهو ثلاثة دواوين موسيقية، ونسبته نسبة ثمانية الأمثال 8/1 وهو حبس سبعة أثمان الوتر واهتزاز ثمنه الآخر.
11- بزرك: كلمة فارسية معناها (الكبير) ، وهي في الموسيقا العربية اسم نغمة في المنطقة الحادة، تسمع من العود بالإصبع البنصر على الوتر الخامس، وهي صياح النغمة المسماة في الطبقة الوسطى (سيكاه) ، وتطلق (بزرك) أيضا على هيئة لحنية لجماعة أنغام مؤلفة تأليفا معينا، فيما يسميه أهل الصناعة مقام (بزرك) وهو اسم آخر لطريقة مقام (الماهور) .
12- بوسلك: وتسمى هنا (أبو سلمك، والسلمك) ، وهي تسمية اصطلاحية في الموسيقا لنغمة في الطبقة الوسطى تسمع من آلة العود فيما بين سبابة الوتر الثالث المسمى (دوكا) ، وبين نغمة وسطاه، ويسمى أيضا باسم (بوسلك) هيئة لحنية تسمى (مقام بوسلك) في المنطقة الوسطى، مؤسسة على نغمة (دوكاه) ، يستعمل فيها من الأجناس اللحنية الجنس ذو الأربعة المسمى (جنس بوسلك) وهو القوي الأرخى غير المتتالي، الذي يرتب فيه أصغر الأبعاد الثلاثة وسطا، وقد تسمى هذه الهيئة اللخنّية بمقام عشاق.
13- حجاز: اصطلاح في الموسيقا العربية، يطلق على النغمة الرابعة الزائدة قليلا بمقدار، بعد إرخاء مما يلي النغمة الرابعة الأساسية المسمى (جهار كاه) ، وتؤخذ على العود بالإصبع البنصر على الوتر الثالث، ويسمى
باسم حجاز أو حجازي هيئة نغم في المنطقة الوسطى تؤسس على النغمة الأساسية (دوكاه) وهي نغمة مطلق الوتر الثالث في العود.
14- الحسيني: اصطلاح في الموسيقا العربية يطلق على النغمة التي تسمع من سبابة الوتر الرابع في العود، وهو (وتر النواة) ، وسجاح هذه النغمة، أي نظيرتها بالقوة الأثقل هي نغمة (عشيران) ، وتسمع من مطلق الوتر الثاني المسمى وتر (العشيران) وتسمى باسم (حسيني) أيضا، هيئة لحنية لجماعة نغم تعرف (بمقام الحسيني) ، وتميز عند الإجراء باستعمال نغم الجنس القوي المرتكز على نغمة الحسيني، ثم تستقر على نغمة (دوكاه) التي هي مطلق الوتر الثالث في العود، ونغمة حسيني إذا لم تكن صياح مطلق وتر العشيران، فتحولت قليلا إلى جهة الثقل، فإنّها تسمى باسم آخر فهي تارة باسم (شورى) وتارة باسم (حصار) وهذه تسمع من العود قريبا من الأنف على وتر النواة.
15- الدستان: جمعها دساتين ودستانات، كلمة فارسية معناها اليدان، واصطلاحا: موضع أصابع اليد على العود.
16- الراست: كلمة فارسية بمعنى مستقيم، تطلق اصطلاحا على هيئة لحنية لجماعة النغم الأساسية في الموسيقا العربية، التي تعرف بالجماعة المستقيمة، واصطلاحا راست، ويسمى بهذا الاسم أيضا نغمة أساس الجمع المسمّاة (يكاه) ، وكذلك الجنس الأساسي ذو الأربع، وهو من أصناف الجنس القوي المتصل المسمى اصطلاحا (جنس الراست) .
17- راهوي: يستعمل اصطلاحا في الموسيقا العربية على هيئة لحنية تؤخذ من جماعة نغم، تستقر على درجة (الراست) فيما يسمونه (مقام راهوي) ، أو
(رهاوي) ، واستعمال المحدثين لهذا النغم يشبه (مقام الراست) وأما المتوسطون فكانوا يطلقون اسم (راهوي) على ترتيب جماعة أخرى غير التي يستعملها المحدثون.
18- الشهرناز (وجاء باسم الشهناز) : وهو اسم فارسي، معناه (مدينة الدلع) ، ويطلق اصطلاحا في الموسيقا العربية علي هيئة لحنية مركبة تبدأ من المنطقة الحادة بجنس الراست في الكردن، ثم بجنس الراست على النواه، على أن تجعل النغمة المسماة حسيني ظهيرا لجنس الراست النواه، ثم يختم بجنس البيات مؤسسا على الحسيني، وهو الجنس القوي غير المتتالي.
19- عراق: اصطلاح في الموسيقا العربية، تسمى به نغمة في المنطقة الثقيلة، تسمع في العود من مجنب سبابة الوتر الثاني المسمى وتر العشيران، ويختلف تحديد هذه النغمة باختلاف تسوية نغمة مطلق وتر العشيران، ونغمة صياحها بالقوة في المنطقة الوسطى، تسمى (أوج) ، ويسمى أيضا باسم (عراق) هيئة اللحن الذي يستقر على هذه النغمة المسمى باسم (العراق) ، والجنس المميز للحن هذه الجماعة هو القوي المتصل الأشد غير المنتظم.
20- عشاق: اسم آخر لهيئة اللحن المسمى في الموسيقا العربية مقام (بوسلك) الذي يستقر في المنطقة الوسطى على نغمة (دوكاه) ، وهي نغمة مطلق الوتر الثالث في العود، وقد يسمى هذا باسم مقام (عشاق مصري) ، تمييزا له عن المقام المشهور باسم (عشاق تركي) الذي يشبه مقام البيات.
21- الماخوري: ضرب من الإيقاعات الموسيقية العربية التي اشتهرت قديما، كان أهل الصناعة وقتذاك يعدونه هو بعينه (إيقاع خفيف الثقيل الثاني) ، واسم
الماخوري مشتق عن تمخير الإيقاع، ليكون وسطا بين الحثيث من الإيقاعات والخفيف.
22- محصور، أو محصور بالبنصر: اصطلاح موسيقي عند العرب المتوسطين، يطلق على هيئة ترتيب نغم الجنس الذي يستقر على نغمة بنصر الوتر ببعد بقية، وأما المشهور في تجنيس الأغاني في هذا الجنس، فهو مذهب إسحاق الموصلي.
23- المحمول: اصطلاح في الموسيقا عند العرب المتوسطين، لتعريف نغم الجنس الذي يستقر على دستان الوسطى في العود، والأرجح أنهم يعنون الوسطى الفارسية أو مجنب الوسطى، فيشبه ما هو محمول بالوسطى بين السبابة والبنصر، وأما التعريف المشهور الذي يقابله عند القدماء على مذهب إسحاق الموصلي فهو مطلق في مجرى البنصر.
24- المزموم: تجنيس من مصطلحات الأغاني، كان العرب المتوسطون يستعملونه لنغم الجنس الذي يستقر على نغمة سبابة الوتر في العود، مسبوقة بنغمة مجنب الوسطى، أو يستقر على نغمة مطلق الوتر مسبوقة بنغمة مجنبة.
25- المطلق: اصطلاح في تجنيسات الأغاني عند العرب على مذهب إسحاق الموصلي، وهو أن للغناء مجريين في كل طبقة أحدهما منسوب إلى الوسطى والآخر منسوب إلى البنصر، فأيهما جعلت المجرى كانت الطبقة منسوبة إليه.
26- المجنب: أنواع، مجنب السبابة، مجنب الوتر، مجنب الوسطى، وهو تعريف عربي قديم، وهو اسم دستان من دساتين العود تستخرج منه النغمة التي هي أقرب ثقلا إلى نغمة دستان السبابة.
27- النوا (النوى) : اصطلاح يطلق على الوتر الرابع في العود، ويسمى أيضا (نواة) ، وكذلك تسمى نغمة مطلقة، وهي الخامسة التامة في ترتيب النغمات الأساسية في المنطقة المتوسطة صعودا من الأولى المسماة (يكاه) أو (راست) ، وتسمى باسم (نوا) أيضا هيئة لحنية لجماعة نغم تستقر على النغمة المسماة (دوكاه) فيما يعرف باسم (مقام نوا) ، وهو من المقامات المركبة من حجاز النوا عند الاستهلال إلى المنطقة الحادة، وجنس الراست محولا على (الدوكاه) ثم التسليم بجنس البيات.
28- الهزج: في الموسيقا العربية، الإيقاع الموصل ذو الزمان الواحد المتساوي بين كل نقرتين متواليتين.
أوتار العود وما يتعلق بها:
1- الاصطحاب: تسوية الأوتار (أي نصبها) .
2- الاصطحاب المعهود: مصاحبة مطلق كل وتر من مطلقات جميع أوتار العود، مع ما في جنبه على نسبة ذي الأربع ويسمى (شد أصل) .
3- الاصطحاب غير المعهود: وهو مصاحبة كل وتر من مطلقات الأوتار مع ما في جنبه على غير ذي الأربع ويسمى (شد غير أصل) .
4- مطلق الوتر: العزف على الوتر بدون جس.
5- البم: اسم الوتر الأعلى من العود. وبم: كلمة فارسية معناها الغليظ.
6- المثلث: (على وزن مطلب) اسم الوتر الثاني من الأعلى.
7- المثنى: (على وزن معنى) اسم الوتر الثالث من الأعلى.
8- الزير: اسم الوتر الأول من الأسفل. وزير: كلمة فارسية مناها أسفل.
9- ثقل النغمة: قرار النغمة.
10- حدة النغمة: جواب النغمة.
11- أرقام الكسور الاعتيادية المستعملة في نسب الأبعاد: الرقم المقامي يمثل طول الوتر، والرقم البسطي يمثل طول الوتر المهتز، والعدد الفارق بينهما يمثل طول الوتر المحبوس، فمثلا: 4/3 ويطلق عليه كل وثلث كل، لأن الأربعة هي كل الثلاثة وثلثها، فالأربعة تمثل طول الوتر بصورة عامة، الثلاثة تمثل طول الوتر المهتز، والفارق بينهما وهو العدد واحد من الأربعة طول الوتر المحبوس، وهو ربع الأربعة، أي ربع الوتر. وقد استعمل بعض القدماء ومنهم اللاذقي (صاحب الرسالة الفتحية في الموسيقا) الأنغام بواسطة الحروف الأبجدية، فالحروف العشرة الأبجدية الأولى وهي (أب ج د هـ وز ح ط ي) ، وإضافة الحرف العاشر الذي هو الياء إلى الحروف التسعة الباقية فتكون (يا يب يج يد يه يو يز يح يط) . ثم بإضافة الحروف التسعة إلى حرف الكاف الذي رقمه عشرون، وهكذا بإضافة الحروف تسعة إلى الحروف ذات الأرقام العشرية، فاللام ثلاثون، والميم أربعون والنون خمسون.
أسماء النوتات العربية وما يقابلها في النوتات العالمية التي استعملها اللاذقي في كتاب الرسالة الفتحية
رموز نغمات اللاذقي/ رموز النوتة العربية/ ما يقابلها من رموز النوتة العالمية
1- أ/ عشيران/ لا
2- ب/ عشيران عجم/ سي بيمول
3- ج/ عراق (+) / سي كاربيمول (+)
4- د/ كواشت/ سي
5- هـ/ رست/ دو
6- و/ زير كولاه (-) / دوديز (-)
7- ز/ زير كولاه/ دوديز
8- ح/ دوكاه/ ره
9- ط/ كوردي/ مي بيمول
10- ي/ سيكاه (+) / مي (-)
11- يا/ بوسليك/ مي
12- يب/ نيم حجاز/ فاكار ديز
13- يج/ حجاز/ فاديز
14- يد/ حجاز (+) / فاديز (+)
15- يه/ نوى/ صول
16- يو/ حصار/ لا بيمول
17- يز/ تك حصار/ لا كار بيمول (+)
18- يح/ حسيني/ لا
19- يط/ عجم/ سي بيمول
20- ك/ أوج (+) / سي كاربيمول (+)
21- كا/ ماهور/ سي
22- كب/ كردان/ دو
23- كج/ شهناز (-) / دوديز (-)
24- كد/ شهناز/ دوديز
25- كه/ محيّر/ ره
26- كو/ سنبلة/ مي بيمول
27- كز/ بزرك (+) / مي (-)
28- كح/ جواب بوسيلك/ مي
29- كط/ جواب نيم حجاز/ فاكارديز
30- ل/ جواب حجاز/ فاديز
31- لا/ جواب تك حجاز (-) / فاديز (+)
32- لب/ سهم/ صول
33- لج/ جواب حصار/ لا بيمول
34- لد/ جواب تك حصار (+) / لاكار بيمول (+)
35- له/ جواب حسيني/ لا
الدوائر النغمية المشهورة ولكل دائرة لها نغماتها المعروفة لدى الموسيقيين وهي اثنتا عشرة دائرة هي:
عشاق، نوى، بوسليك، راست، عراق، أصفهان، زاير افكند، بزرك، زنكولة، راهوي، حسيني، حجازي.
ومن المصطلحات التي ترد في الكتاب وأكثرها من أصول فارسية:
كان القدماء يسمون بعض الألحان المشهورة في زمانهم مقاما، وبعضها أوازه وبعضها شعبة:
المقام: كان المقام يسمى بأسماء الأصابع والدساتين والطرائق، ثم أطلق عليه شد أو دور، ثم أطلق عليه اسم مقام، وأول من ذكر اسم (مقام) هو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي (ت 710 هـ) في كتابه (درة التاج لغرة الديباج) .
الأواز: أصل كلمة (أوازه) فارسية معناها الصوت، أو جماعة نغم محددة، ويعني جلبة أو شهرة، واصطلاحا: هو ما يتفرع من مقامين، قال بدر الدين الأربلي (ت 755 هـ) :
وفرّعوا من كلّ شدّين نغم ... سمّوه أوازا فبعض قد رسم
ويتفرع من الأواز ستة أنغام:
الأول: كوشت، وهو عشر نغمات مشتملة على تسعة أبعاد.
الثاني: نوروز، ونوروز اسم فارسي معناه (اليوم الجديد) ، وهو اسم لمقام خاص يستقر على درجة العجم، والنوروز عندهم على نوعين، أحدهما ما يكون
أربع نغمات مشتملة على ثلاثة أبعاد، ويسمى هذا بنوروز أصل صغير ونغمته بالنوتة الحديثة (ره دو سي) ، وثانيهما ما يكون سبع نغمات مشتملة على ستة أبعاد، ويسمى هذا بنوروز كبير.
الثالث: سلمك، وهو إحدى عشرة نغمة مشتملة على عشرة أبعاد، وسلمك اسم فارسي، وهو سلم لطريقة مقام الراست.
الرابع: كردانية، وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.
الخامس: مايه، وهو أربع نغمات مشتملة على ثلاثة أبعاد، ومائة كلمة فارسية معناها (الخميرة) .
السادس: شهناز، وهو سبع نغمات مشتملة على ستة أبعاد، وشهناز: كلمة فارسية مؤلفة من كلمتين، شاه: معناها الملك، وناز: معناها المدلل. ويكون المعنى: (الملك المدلل) .
الشعبة: هيئة انتقالية على نغمات المقام على وجه مخصوص، وسميت شعبة لتشعبها من المقام، وهي أربع وعشرون:
الشعبة الأولى: دوكاه، وهي كل نغمتين مشتملتين على بعد طنيني، ودوكاه:
كلمة فارسية مركبة من كلمتين: دو بمعنى اثنين وكاه بمعنى مقام أي المقام الثاني، وهكذا بقية المقامات السيكاه والجهاركاه والبنجكاه بمعنى المقام الثالث والرابع والخامس وهكذا.
الشعبة الثانية: سه كاه، وهي ثلاث نغمات مشتملة على بعد طنيني في الأثقل ومجنب في الأحد.
الشعبة الثالثة: جاركاه، وهو قسم رابع من الأقسام السبعة (أي أقسام الطبقة
الثانية) المستعملة من الأحد، فيكون أربع نغمات محيطة بثلاثة أبعاد، ويسمى هذا بجاركاه ذي الأربع أيضا.
الشعبة الرابعة وهي على نوعين:
أحدهما بنجكاه أصل، وهو قسم رابع لذي الخمس (أي القسم الرابع من الطبقة الثانية) فيكون خمس نغمات محيطة بأربعة أبعاد.
وثانيهما: بنجاكاه زايد، وهو قسم ثامن لذي الخمس، فيكون ست نغمات محيطة بأربعة أبعاد.
الشعبة الخامسة: عشيرا، وهو ست نغمات مشتملة على خمسة أبعاد، ويصدق عليه أنه حسيني محطه يكاه.
الشعبة السادسة: نوروز عرب، وهو ست نغمات مشتملة على خمسة أبعاد.
الشعبة السابعة: ماهور (وما هور كلمة فارسية معناها الهلال) ، وهي على نوعين: أحدهما ما هور صغير، وهو قسم أخير من أقسام الطبقة الثانية (أي القسم الثالث عشر من أقسام الطبقة الثانية) ، فيكون هو خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد.
وثانيهما: ماهور كبير، وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.
الشعبة الثامنة: نوروز خارا، وهو ست نغمات مشتملة على خمسة أبعاد.
الشعبة التاسعة: نوروز بياني، وهو خمس نغمات.
الشعبة العاشرة: حصار، وهو ثماني نغمات محيطة بسبعة أبعاد.
الشعبة الحادية عشرة: نهفت (نهفت كلمة فارسية معناها الخفي المستور) ، وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.
الشعبة الثانية عشرة: عزال، وهو قسم سادس من أقسام ذي الخمس، فيكون هو خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد، وهو حجازي عند القدماء مع بعد طنيني في الأحد، فيصدق عليه أنه دوكاه محطة حجازي.
الشعبة الثالثة عشرة: أوج (أوج معناه الأعلى، وبالفارسي (أويج) والأوج نغمة من نغمات السلم الموسيقي الشرقي وهو جواب نغمة العراق) وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.
الشعبة الرابعة عشرة: نيريز (نيريز مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الرست) وهو على نوعين:
أحدهما نيريز صغير: وهو القسم الثاني عشر من أقسام ذي الخمس، فيكون خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد، فيصدق عليه أنه حجازي عند القدماء محطه يكاه.
وثانيهما: نيريز كبير، وهو ثماني نغمات محيطة بسبعة أبعاد.
الشعبة الخامسة عشرة: مبرقع، وهو كل نغمتين مشتملتين على بعد مجنب.
الشعبة السادسة عشرة: ركب، وهو ثلاث نغمات مشتملة على بعدين مجنبين.
الشعبة السابعة عشرة: صبا (الصبا مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الدوكاه، ونغماته: ماهوران بوسليك شهنازا محير كردان عجم حسيني صبا جهاركاه سيكاه دوكاه صعودا) وهو خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد.
الشبة الثامنة عشرة: همايون، وهو سبع نغمات محيطة بستة أبعاد.
الشعبة التاسعة عشرة: زوالي وهو سيكاه بشرط أن يضاف إلى أحده بعد الإرخاء وهو بعد ربع الطنيني.
الشعبة العشرون: أصفهانك (والأصفهانك مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الدوكاه) ، وهو خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد.
الشعبة الحادية والعشرون: بستة نكار (البسته نكار مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة العراق، ونغماته: (شهناز أو محير كردان عجم حسيني صبا جهاركاه سيكاه دوكاه رست عراق صعودا) وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.
الشعبة الثانية والعشرون: نهاوند (النهاوند مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الرست، وسلمه: كردان نيم ماهرو حصار نوى جهاركاه كردي دوكاه رست صعودا) وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.
الثالثة والعشرون: خوزي، وهو ست نغمات مشتملة على خمسة أبعاد.
الشعبة الرابعة والعشرون: محيّر (المحير درجة من درجات السلم الموسيقي الشرقي وهو جواب الدوكاه، وسلمه: محير كردان أوج حسيني نوى جهاركاه سيكاه دوكاه صعودا) ، وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد.
المقامات وصلتها بالأبراج وتأثيراتها:
المقامات:
الأول: راست، وهو منسوب إلى برج الحمل فطبيعته ناري (راست كلمة فارسية معناها: المستقيم، واصطلاحا: هو السلم الموسيقي الطبيعي للموسيقا الشرقية) .
الثاني: عراق وهو منسوب إلى الثور فطبيعته ترابي، وهو ثلاث نغمات مشتملة على المجنب في الأثقل، والطنيني من الأحد إلى الأثقل.
الثالث: أصفهان وهو منسوب إلى الجوزاء فطبيعته هوائي.
الرابع: زير افكند (زير افكند جملة فارسية معناها: لأن يسقط) ويقال له عند بعضهم كوجاك (كوجاك: كلمة فارسية تركية معناها: صغير) وأرباب الموشح (الموشح أحد الفنون الشعرية السبعة التي هي: الشعر والموشح والمواليا والزجل والدوبيت والقوما والكان كان) يقولونه محبة الأنغام، وهو منسوب إلى السرطان فطبيعته مائي.
الخامس: برزك
السادس: زنكولة (زنكولة: كلمة فارسية معناها: جرس صغير) وهو منسوب إلى السنبلة، فطبيعته ترابي.
السابع: راهوي، وهو منسوب إلى الميزان، فطبيعته هوائي.
الثامن: حسيني، وهو منسوب إلى العقرب، فطبيعته مائي (كما يطلق على الحسيني سابقا ششكاه) .
التاسع: حجازي، وهو منسوب إلى القوس، فطبيعته ناري.
العاشر: أبوسه ليك (أبوسه ليك: جملة تركية معناها: اللثم الخفيف) ، وهو منسوب إلى الجدي، فطبيعته ترابي.
الحادي عشر: نوى، وهو منسوب إلى الدلو فطبيعته هوائي.
الثاني عشر: عشاق (عشاق مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الدوكاه) وهو منسوب إلى الحوت، فطبيعته مائي.
الإيقاعات الموسيقية القديمة وعددها اثنا عشر وهي:
1- الثقيل الأول أو الورشان- 16 نقرة.
2- برافشان- 17 نقرة.
3- الثقيل الثاني- 16 نقرة.
4- خفيف الثقيل- 16 نقرة.
5- ثقيل الرمل- 24 نقرة.
6- خفيف الرمل- 10 نقرات.
7- الهزج الكبير- 10 نقرات.
8- الهزج الصغير- 6 نقرات.
9- الرمل- 12 نقرة.
10- الفاختي الصغير- 10 نقرات.
11- الفاختي الكبير- 20 نقرة.
12- الفاختي الأكبر- 28 نقرة.
الإيقاعات عند المتأخرين وعددها عشرون إيقاعا وهي:
1- الثقيل- 48 نقرة.
2- الخفيف- 32 نقرة.
3- سه ضرب طويل- 32 نقرة.
4- سه ضرب صغير- 16 نقرة.
5- أوسط كبير- 24 نقرة.
6- أوسط صغير- 12 نقرة.
7- جهار ضرب- 96 نقرة.
8- الفاختي الصغير- 10 نقرات.
9- ضرب إنكيز أوروان- 10 نقرات.
10- عمل أو تركي ضرب- 14 نقرة.
11- رمل طويل- 24 نقرة.
12- رمل قصير- 24 نقرة.
13- سرندان- 10 نقرات.
14- صماعي- 10 نقرات.
15- جر ثقيل أو نيم ثقيل- 24 نقرة.
16- روان- 8 نقرات.
17- محجل- 56 نقرة.
18- ضرب الفتح- 88 نقرة.
19- برافشان- 17 نقرة.
20- أزج أو سريع الهزج- هو كل جماعة نقرات بينها أزمنة (أ) .
أسماء المقامات وما يتصل بها ومعانيها باللغة الفارسية:
الماهور: كلمة فارسية معناها: الهلال.
الراست: كلمة فارسية معناها: المستقيم.
السوزناك: كلمة فارسية معناها: المؤلم.
النيروز او النوروز: كلمة فارسية معناها: عيد الربيع.
الماية المغربية: كلمة فارسية معناها: الخميرة.
دلنشين: كلمة فارسية معناها: ساكن القلب.
النهاوند: اسم مدينة فارسية، ويسمى هذا المقام في الجزائر رهاوي أو ساحلي، وفي تونس: محير سيكاه، وفي تركيا: بوسلك أو سلطاني يكاه أو فرح فزا، وعند الفرس: أصبهان.
النكريز: كلمة فارسية معناها: لا تهرب.
الحجاز كار: كلمة فارسية معناها: عمل الحجاز.
الزنكولا: كلمة فارسية معناها: جرس الرأس.
الشاهناز: كلمة فارسية معناها: دلال السلطان.
الهمايون: كلمة فارسية معناها: المبارك.
البسته نكار: كلمة فارسية معناها: رابط المحبوب.
الزيرفكند: كلمة فارسية معناها: زير أسفل أو قديم.
زنكلاه: كلمة فارسية معناها: حبشي.
بزرك: كلمة فارسية تركية بمعنى: عظيم أو كبير.
يكاه: كلمة فارسية مركبة من لفظين أولهما (يك) ومعناه واحد، والثاني (كاه) ومعناه مقام أو درجة صوتية.
دوكاه: كلمة فارسية معناها: المقام الثاني.
سيكاه: كلمة فارسية معناها: المقام الثالث.
جهار كاه: كلمة فارسية معناها: المقام الرابع.
بنج كاه: كلمة فارسية معناها: المقام الخامس.
ششكاه: كلمة فارسية معناها: المقام السادس.
هفتكاه: كلمة فارسية معناها: المقام السابع.
*******
*******
مقامية الموسيقا العربية
محمد قدري دلال
تمتاز الموسيقا العربية بأنها لحنية (ميلودية)، فهي لم تؤسس على تعدد الأصوات (الهارمونية) عموديًا، ولم تُبْنَ على توازي الألحان (البوليفونية) أفقيًاـ بل استعاضت عنهما بالمقامية، لذلك كثرت المقامات وتعددت، وتجاوز عددها المئات، نظرًا لبناء المقام على تغيُّرٍ في الجمل اللحنية مما يستدعي تبدلاً في الدرجات الموسيقية المستخدمة في أبنيتها، وتغيرًا في الأجناس (العقود)، و(السلالم) التي تشكلها هذه العقود، و(الأثر) المتخلِّف في أذن السامع لكل واحد من هذه المقامات.
قبل الخوض في طرق معالجة القدماء لكل مقام على حدة، لا بد من تعريف المصطلحات التي وردت - وسترد كثيرًا -، وبيان وجهة نظرنا بعد أن استقرأناه استقراء وافيًا للألحان المسموعة والمدوَّنة، ونحاول توضيح كل المواضيع الشائكة التي تعترض الدارس المبتدئ، وقد تعوق الباحث عن المتابعة، نظرًا لوجود معمَّيات وألغاز كثيرة وردت في كتب القدماء النظرية.
المقام:
أسلوب خاص جدًا في استخدام درجات موسيقية، تحكمها أبعاد معينة تجتمع في عقودٍ قد يصل عددها إلى /17/ سبعة عشر، العقود هذه تُؤَلف في اجتماعها سلالم كثيرة.. والمقامات تتغير أسماؤها بطريقة تناول هذه العقود، تقديمًا وتأخيرًا، استهلالاً أو بدايةً. ولا بد حين التأليف على مقامٍ ما من إظهار درجات معينة في السلم، والتركيز عليها، كي نفرق بين المقامات التي تشترك في درجات سلم واحد، بحيث يترك كل واحد من المقامات أثرًا مميَّزًا لدى السامع، وانطباعًا مستقلاً لا يشاركه فيه آخر لدى السمِّيع المحترف:
مثال ذلك (مقامات: راست - مـاهور (عربي) - رهاوي - سوزدلارا..) (ومقامات: بياتي - عشاق – حسيني - محيَّر..).
الخلاصة:
المقام: أسلوب خاص في التأليف باستخدام درجات موسيقية معينة، يخلف أثرًا مميَّزًا في أذن السامع، لا يشاركه في الأثر هذا مقام آخر.
أشهر المقامات:
1. المقامات التي تشترك مع (راست) في العقد الأول: راست - سوزناك - ماهور - نوروز سلطاني - دِلنشين - رهاوي - سوزدولارا - يكاه (على درجة صول).
2. المقامات التي تشترك مع (بياتي) في العقد الأول: بياتي - عشاق (تركي) - طاهـر - حسيني - حصـار - قارجغـار (شوري) - محيَّر - وجه عرضبار.
3. المقامات التي تشترك مع (نهاوند) في العقد الأول: نهاوند - نهاوند مرصَّع - نهاوند (كبير) - فرحفزا (على درجة SOL يكاه)ـ
4. المقامات التي تشترك مع (حجاز) في العقد الأول: حجاز - حجاز (غريب) – أصفهان - حجاز كار (على درجة DO) - شاهيناز - زنكلاه (زنجران).
5. المقامات التي تشترك مع (صبا) في العقد الأول: صبا.
6.
المقامات التي تشترك مع (سيكاه) في العقد الأول: سيكاه - هزام - ماية -
بسته نِكار (على درجة SI
)
- عراق (على درجة SI
) - فرحناك.
7. المقامات التي تشترك مع (حجاز كار كرد) في العقد الأول: حجاز كار كرد - طرز ناوين - شوق طرب.
8. المقامات التي تشترك مع (العجم) في العقد الأول: عجم عُشَيران - شوق أفزا.
9. جهار كاه.
السـلَّـم:
هو بمثابة الرسم البياني الذي يظهر لنا الدرجات الموسيقية المستخدمة في مقام ما صعودًا وهبوطًا، متوالية حسب تسلسلهـا (الأدنى فالأعلى - ثم العكس مع التغييرات التي قد تطرأ حين الهبوط)، مُوَضحًا أبعادهـا ومقسمـة إلى عقود (أجنـاس) أقرتها مؤتمـرات الموسيقا العربيـة، بعد دراسة للألحان التراثية (الكلاسيكية)، فهي إذن ملزمة للملحن حين التفكير بالتأليف على هذا المقام أو ذاك، وتلك الطريقة تحكُم تسمية المقام.
وأبعاد الدرجات فيما بينها - متغير في أنحاء الشرق الذي يستخدم المقامات نفسها، فدرجـة (سيكاه) وهي مـن أهم الدرجات في سلالم كثيرة، ليست موحَّدة، ففي تركيا أعلى منها في سورية، وهي في حلب أعلى منها في مصر، وفي باقي المدن السورية.
الخلاصة:
السلم الموسيقي رسم يوضح الدرجات المستعملة في مقامٍ ما (صعودًا وهبوطًا)، مبيِّنًا أبعادها موزَّعة في عقود (أجناس) موروثة.
ألوان من السلالم الموسيقية:
رموز الأبعاد
العقد (الجنس):
مجموعة من الدرجات الموسيقية المتوالية، ذات أبعاد ثبَّتها الاستخدام الموروث لها، يتراوح عددها بين /3/ ثلاثة و/5/ خمسة، والتسمية هذه فيزيائية الأصل، فالوتـر إذا شُدَّ من طرفيه وحُبَس في نقاط معينة، نشأ من اهتزازه بطون، والنقاط المحبوسة عقود تنقسم إلى درجات موسيقية تختلف وطول البطن المهتز.
والعقـود في الموسيقـا العربية و(الشرقية) قد لا يبلـغ مجمـوع أبعادها (فاصلة رباعية) أي (درجتين ونصف) كما في الموسيقا الأوربية، فقد تزيد أو تنقص عن ذلك كما سيأتي لاحقًا.
أنواع العقود:
1. ثلاثي الدرجات: ويحتوي على ثلاث درجات كما في عقد (سيكاه): مجموع الأرباع فيه (درجة وثلاثة أرباع الدرجة).
2. رباعي الدرجات كما في عقدي راست وبياتي: مجموع الدرجات فيهما (درجتان ونصف الدرجة).
3. خماسي الدرجات كما في عقد نكريز وراست بإضافة الدرجة الخامسة: مجموع الدرجات فيه (ثلاثة درجات ونصف الدرجة).
أشهر العقود:
عقد راست - ساز كار – نهاوند - نكريز - كرد - بياتي - صبا - صبا (زمزمة) - صبا (بوسليك) - حجاز- سيكاه – مستعار – عجم - جهار كاه – حصار - حصار كردي (كرد أثر) - نوا...
الخلاصة:
العقد هو مجموعة من الدرجات المتوالية أقلها ثلاث وأكثرها خمس، يسمى حسب أبعادها: باسم أشهر المقامات الذي يكوِّن العقد قسم سلَّمه الأول.
الأثر المقامي:
هو إحساس خاص متفـرِّد، يتخَلَّف عن الغنـاء أو العزف السليمين لمُؤَلَّف من مقـام معيَّن في أذن السامع وروحه، بحيث يميِّز هذا الإحساس من غيره، ويفرِّق المستمع مقامًا من سواه من المقامات الأخرى، وإن اشترك معها في السلم والعقود..
تنبيه: للأرباع الشرقية أسماء وضعها الدكتور ميخائيل مشاقّة، بعد أن قسَّم السلم الموسيقي الشرقي إلى /24/ ربعًا ابتداءً من درجة صول (القرار)؛ ومن قائل إنها موضوعة قبلاً ونسبت إليه، وهي منتشرة بين الموسيقيين الشرقيين عرب وغيرهم، ولا بد للدارس من الاطلاع على هذه الأسماء وحفظها إن أمكن.
جدول بأسماء الأرباع التي سمَّاها الدكتور ميخائيل مشاقّة:
على سبيل المثال إذا أردنا كتابة أسماء درجات سلم راست بالأرباع السابقة- فستكون على النحو التالي:
أما مقام سوزناك المشترك مع راست بالعقد الأول - فيُكتب بالأرباع على النحو الآتي:
مقام راست
من أهم المقامات في الموسيقا الشرقية و(العربية)، فقد لا يخلو مؤَلَّفٌ منه، وهو ذو أثر حزين جليل متَّزن، ويعد أحد المقامات الرئيسية الثلاثة التي يبتدأ بها طقس (الذكر) الإسلامي، كما أن المؤلفات في المقام هذا أكثر من أن تحصى، والانتقال إليـه من مقام آخر يضفي جمالاً على المؤلف غنائيًا كان أم آليًا.. ولذا فإن عقد راست يدخل في صلب سلالم مقامات عدة.
أشهر المؤلفات الآلية التي تعبر تعبيـرًا دقيقـًا عن مقـام راست هي: (بشرف راست لمحمد فخري - بشرف وسماعي طاتيوس أفندي - وسماعيات وبشارف أخرى كثيرة)، أما المؤلفات الغنائية فلا تحصى، منها: موشحان من أقدم ما وصلنا (كلما رمت ارتشافا وأحن شوقًا إلى ديارٍ)[1] يضاف إليهما موشح غير متداول هو (أي بارقَ العلمِ في حيِّ ذي سَلَمِ)، ومن قصائد لحنها الموسيقار المبدع رياض السنباطي: (سمعتُ صوتًا هاتفًا في السحر)، ومن ألحان محمد عبد الوهاب قصيدة (أخي جاوز الظالمون المدى)، وأغنية لحنها لعبد الحليم حافظ مطلعها (قول لي حاجه)، هذه القصائد والأغنية المذكورة هي خير تعبير عن طريقة التلحين التراثية (الكلاسيكية) في هذا المقام.
من الملاحظ أن المستخدم من سلم المقام في الأمثلة السابقة - هو العقد الأول (راست DO) عمومًا-، يصدق هذا على الخانة الأولى، وقد يصدق هذا على التسليم (السماعي مثلاً) - وفي أحيانٍ قليلة يستخدم العقد الثاني (هابطًا) لقفلة مُلِحَّة طارئة، كما نلحظ ذلك في تسليم كلا البشرفين.. فأنت ترى المؤلف يدور في فلك الدرجات الأربع (العقد الأول)، وقد يضيف درجة أو اثنتين مـن (العقد الثاني)، وتحس برنيـن درجتي الأساس والخامسة (دوDO - صول SOL).
في المؤلفات الغنائية التقليدية ينسحب ما ذكرناه عليها أيضًا، إلاَّ أننا نلاحظ ما يلي:
- إمَّا أن يُكتَفى بالعقد الأول كما في موشحي (أحـن شوقًا - أي بارق العلم - ملا الكاسات وسقاني..).
- أو أن ينطلق المؤلف إلى (العقـد الثاني) كما في موشح (كلما رمت ارتشافا).
دوَّنا مقطع اللحن الأول من دور الموشح، أما المقطع التالي فانتقال إلى مقام حجاز غريب، ومنه إلى حجاز كار على درجة (دو DO)، في قفلة مستغربة، أو بعيدة عن جو مقام راست الذي استهلَّ به الموشح.
كما اعتمدنا في إيراد الأمثلة الأخرى على الخانة الأولى من الموشح، ذلك لأن الملحن - حسب ما نراه - لا بدَّ أن يستهلَّ لحنه بأسلوب التأليف الكلاسيكي (التقليدي) للمقام، ومن ثم يعرض ما توحيه عليه قريحته من أفكار موسيقية أخرى في المقام نفسه، أو أن يعرِّج على (عقود) قريبة، سواء أكانت من صلب سلمه أم لا. وهناك رأي آخر يقول: إن الخانة كلها تعبر عن المقام، رغم ما فيها من تغيير أو تعريج على عقود أخرى، إذ هي برأيهـم صورة المقـام الحقيقية!!
ومن الأمثلة الهامة: دور موشح (منيتي من رمت قربه) للحاج عمر البطش، ففي الدور يستخدم العقد الأول وصولاً إلى الدرجة الثانية من العقد الثاني (لا LA)، هبوطًا إلى العقد ما قبل الأساس حتى درجة (يكاه SOL)، لكن التركيز الأكبر يتم على العقد الأول كما هو واضح.
الموشح من ألحان محمد عثمان (1845- 1900)، أضاف محمد عبد الوهاب خانتين، لحنهما لتغنيهما المطربة ليلى مراد في فيلم (عنبر)، في الأربعينيات من القرن العشرين.
هذا ومن القدود ما يعبر بشكل دقيق عن جو المقام وأسلوب التأليف فيه ابتداءً، مثل قد محبوبي (لحن صبري مدلل):
وكذلك اللحن التالي وهو قد معروف في حلقات الذكر، والمناسبات الاحتفالية الدينية الأخرى.
إذا انتهى المؤلف من عرض العقد الأول، ينتقل إلى العقد الثاني من سلم
المقام، فإنه يستهلكه، لكن القريحة والإلهام قد يدفعانه إلى استخدام
ثالث العقود، ومن ثم الهبوط إلى درجـة القرار، مرورًا بالعقـد الثاني
الذي تُخفَض ثالثتُـه (SI
)،
ليتغير اسمه أيضًا فيصبح (عقد بوسليك) على درجة نوا (SOL)، ولقد رآه القدماء
ضروريًا حين الهبوط، ليوحي بالعودة والانتهاء.
ومن الملاحظ أيضًا في المؤلفات القديمة: استخدام عقد (حجاز) أو (بياتي)، وحتى الانتقال إلى مقامات مثل نو أثر أو نهاوند على (دو DO)، ثم العودة إلى المقام الأصل (راست).
ولعل في موشح (كلما رمت ارتشافًا) دليل على ما ذكرناه:
أدرجنا بعض التوضيحات للانتقالات التي حدثت في مجرى اللحن يرجى التنبه لها..
في خانة البشرف أو السماعي الثانية، جرت العادة أن ينتقل إلى العقد الثاني منتقلاً بالمستمع إلى عقد (حجاز)، وليضحي المقام إذا اكتمل بالهبوط إلى درجة القرار (سوزناك).
أما في الثالثة فمن الملحنين من يؤثر الانتقال إلى الجواب (العقد الثالث)، صائغًا جملاً في مقام الكردان (ماهور عربي)[2]، وقد ينتقل كما في سماعي راست لطاتيوس إلى البياتي على الدرجة الخامسة.
لعل للموشح شروطًا أخرى، إذ إن الانتقال إلى العقد الثالث في الخانة أمر مستحب، وبالتالي فنحن نستمع لحنًا وُضِع في مقام (ماهور عربي)، لكن من الطريف ذكره أن محمد عبد الوهاب حين لحن خانتي موشح (ملا الكاسات): جعل الثالثة في مقام صبا على درجة (الحسيني)، مع محافظته في الثانية على ما جرى عليه التقليديين.
وما ذكرناه يتجلَّى في خانة موشح (منيتي من رمت قربه):
وهو كذلك في الخانة الثانية من موشح ملا الكاسات، التي لحنها عبد الوهاب، وهو فيها يجارى التقليديين:
أما لدى المحدثين، فتغييرهم إلى عقود أو مقامات أخرى، لا يتبع منهاجًا معيّنًا، أو قاعدة ثابتة، بل الحبل مُلْقىً على غاربه، والأمر متروك للسليقة والحس الجمالي، وما تمليه لحظات الإلهام من جملٍ قد تصل إلى حد الإغراق في الانتقال الذي لا يخلو من غرابة، خاصة في لحن القصيدة، أو ما يسمَّى بالأغنية العاطفية، تأثُّرًا بما يسمعونه من المؤلفين الأوربيين، والمحدثين منهم، لكن الجمالية متوفرة عند الكثير، وفي الأمر هذا لا يصلح التعميم، فكل عمل موسيقي تجربة فنية لها مزاياها، والذي يجب أن يدرس منفردًا برويَّة وعناية، كي نكتشف بواطن الجمال وسر إيثار هذا السبيل على ما اتبعه التقليديون من ملحنينا، لكننـا والحالة هـذه هل نسمي المقـام المحدث (راست)؟
*** *** ***
المقامية العربية
1
الأصول والتطورات
الوحدة والتنوع في التراث الموسيقي العربي
من مميزات التراث الموسيقي العربي، اتساع رقعته الجغرافية وتنوع روافده التاريخية والثقافية، مما أوجد عددًا وافرًا من القوالب والأساليب المحلية، تتنوع حسب ثقافة الأصل، ومدى تفاعلها مع العناصر المكونة للحضارة العربية الإسلامية خلال مراحلها المتتالية. تتجلى مميزات هذا التراث، في نقطتين أساسيتين:
- تفصح الأولى عن خاصيات محلية، تبرز ملامحها في الرصيد الشعبي بحلل زاهية تتنوع بتنوع الخصوصيات الاجتماعية، والعرقية، والجغرافية، والتاريخية، التي يتشكل منها العالم العربي الإسلامي المترامي الأطراف.
- تكشف الثانية عن وحدة شاملة تتخطى الحدود القومية، تبلورت عناصرها وتطورت داخل إطار الرصيد الكلاسيكي - مجال دراستنا هذه - مستمدة طابعها المميَّز، من الروح الإسلامية واللغة العربية؛ ومما أضفته عليها الخاصيات المحلية من تطعيم وإثراء على مرِّ العصور.
وحدة شاملة، تكونت من خلالها تقاليد موسيقية عدة، قبل أن تتداخل وتتكامل لتصل أوج ازدهارها فيما يمكن تسميته بـ "التقليد الموسيقي الكبير" والذي أفرز بدوره مجموعة من الأساليب والمدارس هي متماثلة ومتباينة في نفس الآن[1]. فعلاوة على المدرسة العربية، توجد:
- المدرسة التركية المغولية: تركيا والمناطق الشرقية باليونان، جزء من قبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا، ويوغسلافيا، بما في ذلك البوسنة وجمهوريات آسيا الوسطى، أوزباكستان-طاجاكستان.
- المدرسة الإيرانية: إيران، بلدان القوقاز الممتدة إلى أذربيجان، أفغانستان، والمناطق الواقعة على الحدود الباكستانية-الإيرانية.
- المدرسة الهندية-الصينية: الهند الشمالي، باكستان، بنغلادش، منطقة سين ديان الصينية، اندونيسيا، جزر المالديف، بروني، ماليزيا وغيرها من مناطق آسيا وأوقيانيا.
- المدرسة الأفريقية، وتشمل المنطقة الإسلامية: السنغال، النيجر، تشاد، مالي، غينيا، جامبيا، جزر القمر... بالإضافة إلى جزء من ساحل العاج، ونيجيريا، وأنغولا وأثيوبيا وغيرها من مناطق القارة الأفريقية.
- أما المدرسة العربية، فهي مع ارتباطها أصلاً بمدى انتشار التأثير اللغوي، تشمل التراث الموسيقي المتداول عزفًا وغناء وسماعًا وتذوقًا، لدى الإنسان العربي داخل الوطن وخارجه، وذلك بصرف النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو مكان إقامته. موسيقيا يتفرع هذا التراث إلى المناطق/المدارس التالية:
المغاربية: المغرب الأقصى، الجزائر، تونس، ليبيا.
المصرية-الشامية: مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، شمال العراق.
الخليجية: جنوب العراق، العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، عُمان، اليمن.
العربية الأفريقية: السودان، موريتانيا، مع الصومال وجيبوتي.
عمليًا، تتضح ملامح هذه المدارس من خلال أساليب الأداء كالتي نلاحظها مثلاً، في النماذج المتنوعة لإلقاء الآذان وترتيل القرآن الكريم وتجويده؛ وكذلك، في هيكلة قوالب الرصيد الكلاسيكي والتي تعود تاريخيًا إلى ما كان يعرف بـ "النوبة الغنائية". فالنوبة كأثر فني لـ "التقليد الموسيقي الكبير" الذي أفرزته الحضارة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي، تشكل نموذجًا موسيقيًا متكاملاً عم استعماله مختلف مراكز البلاد العربية الإسلامية بالمشرق والمغرب والأندلس، وهو لا يزال شامخًا إلى اليوم - كما سنبين لاحقًا.
***
العود آلة مرجعية للمقامية العربية[2]
كان ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، إيذانًا بصحوة كبرى في شبه الجزيرة العربية، ثم المنطقة الإسلامية الواسعة، نشأ في رحابها، فن جديد تسانده عقيدة ولغة، امتاز من بين جميع الفنون، "بطابعه الكوني الموحد في أصوله والمتنوع في روافده". وقد مكنته قدرته التأليفية الفائقة من التطور والازدهار داخل "وحدة جمالية متكاملة" مستوعبًا على مر العصور، مختلف الأنماط الفنية المكونة لتراث الشعوب الإسلامية المنتشرة على رقعة هائلة الامتداد، دون أن يسعى إلى طمس شخصيتها، بل نراه يفتح لها طريق الإبداع والعطاء، في سياق "خط جمالي ناظم وموحد لها جميعًا"، من ذلك الموسيقى.
المدرسة التأسيسية/العودية (إبراهيم الموصلي: تـ. 802؛ وابنه اسحق: تـ 850؛ زرياب: تـ 852؛ الكندي: تـ 874)
منذ الفترة الأموية، احتل العود لدى كبار موسيقيي مدرسة مكة والمدينة ودمشق، مكانة مرموقة واستخدمه المحترفون للمسايرة، واعتمده الروَّاد الأوائل لإرساء أسس تنظير موسيقاهم باعتباره من الآلات الوترية المألوفة منذ القدم، عند الأمم الشرقية، لا تضارعها آلة أخرى في سهولة استعمالها وفخامة الأنغام الخارجة منها، ومطابقتها لأنواع الأصوات الإنسانية. وقد تُوجت هذه المكانة مع الفترة العباسية الأولى (القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي)، حيث بلغ الفن الموسيقي عصره الذهبي في إطار المدرسة العربية القديمة/العودية[3] (حسب تعاليم إبراهيم الموصلي وابنه اسحاق، ونظرية الكندي)، ليشكل أحد أركان العلوم الرياضية وعنصرًا هامًا في الحكمة الرباعية (إلى جانب الحساب والهندسة والفلك)، وجزءًا أساسيًا في الثقافة العربية باتجاهيها: التجريدي المعتمد عل التأثير الموسيقي، أو الطبيعي الرياضي والتجريبي في نفس الآن (مع الفارابي وابن سينا)، والذي يركز أساسًا على فيزيائية الصوت وتحديد النسب[4]. في هذا الإطار صار العود باعتراف الجميع "أشهر الآلات وأثمنها"، والمرجع الرئيسي دون سواه، في معالجة الصناعة الموسيقية وشرح نظرياتها ودراسة أبعادها الفيزيائية والفلسفية والفلكية؛ حتى اعتبرت معرفة العود ونسب دساتينه "من تمام علم الموسيقي"[5]. ومن هذا المنطلق، اعتنى به الفلاسفة والمنظرون وجعلوه يحتل صفحات طويلة من مؤلفاتهم. غير أن المسائل المتعلقة بتسوية الأوتار ومواضع الدساتين، قد حظيت بالاهتمام الأوسع والشرح المستفيض، وذلك لأهميتها في تحديد النسب الصوتية للنغمات التي هي بمثابة حروف الهجاء في لغة الموسيقى، منها يتألف السلم الموسيقى وعليها تستخرج المقامات وتبنى الألحان. لقد شهدت هذه النهضة الموسيقية تطورات وإضافات متتالية، أهمها:
- المدرسة الإبداعية/الطنبورية (الفارابي: تـ 950؛ ابن سينا: تـ 1037؛ ابن زيله: تـ 1048؛ الحسن الكاتب: القرن العاشر...). اقتباس بعض المعطيات والمصطلحات الخاصة بالمنهجية الإغريقية في الكتابة عن الموسيقى، والاعتماد تطبيقيًا، على امتزاج عناصر من الموسيقى الفارسية بالنظام العربي القديم وذلك عن طريق إضافات المحدثين، وانتشار آلة الطنبور الخرساني إلى جانب آلة العود التي بقيت مع ذلك الآلة الرئيسية. ومن بين التغييرات الهامة استعمال بعض المصطلحات الفارسية ودخول السلم الخراساني بتجزيئاته [ليما، ليما، كوما أي بقية، بقية وومضة]. أما البدعة الحقيقية فإنها تكمن في استعمال إصبع وسطى الفرس التي أضيفت إلى دساتين العود بين وسطى زلزل والوسطى القديمة.
- المدرسة المنهجية/النظامية (صفي الدين: 613 - 693 هـ 1216- 1294م وأتباعه، من بينهم، قطب الدين الشيرازي: 710 هـ /1310م؛ لجرجاني: تـ. 816هـ / 1413 م؛ عبد القادر بن غيبي: تـ. 838 هـ / 1434 م؛ فتح الله الشرواني: تـ. 880 هـ /1475 م؛ عبد الحميد اللاذقي: تـ. 900 هـ / 1494 م). تواصلت عملية التثاقف والتداخل بين مختلف العناصر المكونة للأمة العربية الإسلامية (من ذلك العنصر التركي المغولي) تمخضت عنها نهضة فنية عارمة اكتملت بفضلها ملامح الفن الموسيقي فتوضَّحت مناهجه ومصطلحاته وتوطدت أركانه وقواعده.. وقد توجت مراحل التطور هذه، بفضل الجهود التي بذلت لمعالجة ما تبقى من شذوذ وأخطاء من أهمِّها مسألة السلم الموسيقي وبعض النسب المكونة له كوسطى زلزل التي ظلت - كما رأينا - لا تستقر على حال؛ وكذلك قضايا المقامية من حيث مساراتها وعلاقاتها وتسمياتها.
أوتار العود ودساتينه مصدر للنغم والمقام
الأوتار
العود القديم: تتفق المصادر على أنه في الأصل، كان للعود عند الضاربين أربعة أوتار مفردة، تسمى على التوالي [البم – المثلث – المثنى – الزير][6]، بينما كان النظريون - اعتبارًا من الكندي - يفترضون له وترًا خامسًا – لسهولة بحث النظرية الموسيقية في حدود طبقتين (ديوانين)، دون اللجوء إلى نقل اليد اليسرى من وضعها الأول على الدساتين – ويسمون هذا الوتر الخامس [الزير الثاني، أو الزير الأسفل، أو الحاد].
وظهر على الساحة الموسيقية، تباعًا منذ القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، نوعان جديدان من العود:
- العود الكامل: "أشهر الآلات وأثمنها - يقول الصفي الدين- يشد عليها خمسة أوتار مضاعفة [البم – المثلث - المثنى- الزير- الحاد]. وأما اصطحابها فهو أن تجعل مطلق كل وتر مساويًا لثلاثة أرباع (الرابعة التامة) ما فوقه، فيصير الجمع الكامل (أي ديوانين) مندرجًا فيما بين مطلق الأعلى الذي هو البم، وبنصر الأسفل الذي هو الحاد"[7]. وبالتالي، حافظ على التسوية المعهودة، واعتبروه "أشرف الآلات ذوات الأوتار"[8]... يبدو أن استعمال الوتر الخامس أصبح ممكنًا لسببين: أولاً لكبر حجم العود، وثانيًا لنزول الأوتار نحو القرار، وذلك على النحو التالي: [جعل الحاد مكان الزير، والزير مكان المثنى، والمثنى مكان المثلث، والمثلث مكان البم الذي صار أكثر غلظة].
العود الكامل عن الأدوار لصفي الدين الأرموي البغدادي (مخ. بتاريخ: 1333-1334)
- العود الأكمل: تشير مؤلفات القرن الثامن- التاسع الهجري/الرابع عشر- الخامس عشر الميلادي، إلى أن "بعض العملة المتأخرين يشدون على ساعد هذه الآلة وترًا سادسًا ويسمونها العود الأكمل". وهو وتر مفرد، يضاف أسفل الوتر الحاد ويسوَّى على قرار ديوان الوتر الثالث، ويقوم بالتالي، بدور القرار. مما يجعل المجموع إحدى عشر وترًا، خمسة مضعفة وسادس مفرد. وربما ضعَّف البعض الوتر السادس[9]. ويؤكد مخطوط كشف الهموم تداول هذا التنوع بقوله: "أن العود أنواع بحسب عدد أوتاره: فمنه عود ذو اثني عشر وترًا ومعشَّر ومثمَّن". وهو يتضمن صورة لعازف على العود، من المرجح أنه العود الأكمل إذ تبرز منه ستة أوتار.
العود في مخطوط كشف الهموم (القرن التاسع هـ / الخامس عشر م)
الدساتين:
يتفق الجميع على أن الدساتين - الضرورية أو الرئيسية كما يسمونها - "أربعة"، وهي المنسوبة للأصابع الأربع": [السبابة – الوسطى – البنصر – الخنصر]. "فطن لها أكثر الناس واعتادها ونسبوا النغم إليها، وهي الطبيعية عند القدماء"[10]. ومع كتابات الفارابي الذي عالج مختلف الأنظمة المتداخلة في عصره، ظهرت دساتين جديدة لم تُذكر من قبل، كالمجنب بين مطلق الوتر والسبابة، والوسطى الخاصة بين الوسطى القديمة والبنصر. وهذه الدساتين المضافة تعزى إلى مجدد العود العربي منصور زلزل وإلى السلم الفارسي، وهي كلها ذات نسب متغيرة لا تستقر على حال: "منهم من ينزلها قليلاً، ومنهم من يصعدها قليلاً، فيخرج من ذلك أجناس"[11]، لذلك جاء تحديدها متباينًا حسب المنظرين. والغالب على الظن – حسب اعتقادنا - أن هذه المسافات خاصة ما ينسب منها إلى زلزل، كانت متداولة قبل الكندي لأن منصور زلزل كان سابقًا له، علاوة على كونه أستاذ اسحق الموصلي، ومن المرجح أنَّه قد استوحاها من الواقع العملي لأنها تبدو من المكونات الأساسية للمقامية العربية؛ وعدم التعرض لها في المصنفات الأولى للكندي وابن المنجم[12] تلميذ اسحق الموصلي، وإخوان الصفا، ربما يعود لكونها نسبية وغير مستقرة، وأن الهدف آنذاك كان مركزًا على معالجة "النغم التامة الكبار" وهي "سبع لا زيادة ولا نقصان.. دائرة على نفسها".
وفيما يلي، تلخيص للتطور الذي شهده عدد دساتين العود من مدرسة إلى أخرى:
- المدرسة التأسيسية/العودية (الكندي - ابن المنجم – إخوان الصفا) = أربعة دساتين رئيسية أو المشهورة، وهي: سبابة– وسطى- بنصر- خنصر [4 + المطلق = 5].
- المدرستين الإبداعية/الطنبورية = أربعة دساتين رئيسية، مع إضافة مجنبات وتنويع في الوسطى، من ذلك:
· الفارابي: مجنب قديم- مجنب فارسي- مجنب زلزل- سبابة- وسطى قديمة- وسطى فارسية – وسطى زلزل – بنصر – خنصر [9 + مطلق = 10]
· ابن سينا وابن زيلة: الدستان الأخير- مجنب السبابة- سبابة- وسطى قديمة/فارسية/عالية – وسطى زلزل– بنصر – خنصر [7 + مطلق = 8]
· الحسن الكاتب وابن الطحان: المجنب– السبابة– وسطى الفرس– وسطى العرب– دستان زلزل (مهمل)– البنصر– دستان آخر (مهمل) [6 + مطلق = 7]
- المدرسة النظامية/المنهجية = أربعة دساتين رئيسية مع إضافات، منها: صفي الدين، ابن غيبي، الجرجاني[13] واللاذقي: زائد- مجنب– سبابة- وسطى فارسية– وسطى زلزل– بنصر– خنصر [7 + مطلق = 8]
من الملاحظ، أنه منذ عصر اللاذقي، بدأ عدد من الموسيقيين يستغنون عن الدساتين، ثم شيئًا فشيئًا (حسب المراجع المتوفرة)، لم تعد تستعمل في العود، لا عند العرب ولا الأتراك، ويُفترض أن غيابها يهدف إلى ترك أكثر حرية ومرونة لانزلاق أصابع العازف عند الانتقال من نغمة إلى أخرى. وهو ما يضيف أبعادًا جمالية وتعبيرية على أسلوب العزف، تتماشى مع الذوق الشرقي.
جدول مقارن للمدارس الثلاثة: الدساتين على وتر البـم (بحساب السنت والنسب)
|
وتــر البــــــم |
دساتين العود |
||
|
المنهجيّة / النظاميّة (صفيّ الدين...) |
الإبداعيّة / الطنبوريّة (الفارابي – ابن سينا) |
العربيّة القديمة/ العوديّة (الكندي –موصلي/ ابن المنجّم) |
المدارس |
|
1/1 - 0 |
1/1 - 0 |
1/1 - 0 |
مطلق |
|
|
256/243 - 90 (99) |
|
(دستان أخير) |
|
256/243 - 90 |
|
|
زائد |
|
|
162/149 - 145 (139) |
|
مجنّب فارسي (مجنّب سبّابة) |
|
|
54/49 - 168 |
|
مجنّب زلزل |
|
216/310 - 180 |
|
|
مجنّب |
|
9/8 - 204 |
9/8 - 204 |
9/8 - 204 |
سبابة |
|
32/27 - 294 |
32/27 - 294 |
32/27 - 294 |
وسطى وسطى قديمة / (وسطى عالية) |
|
|
81/68 - 303 |
|
وسطى الفرس |
|
215/309 - 384
|
27/22 - 355 (351-347- 343) |
|
وسطى زلزل |
|
81/64 - 408 |
81/64 - 408 |
81/64 - 408 |
بنصر |
|
4/3 - 498 |
4/3 - 498 |
4/3 - 498 |
خنصر |
التدوين الأبجدي والسلم النغمي:
دون التوسع هنا، في المسائل المتعلقة بالنظرية السلمية والجموع المستخرجة منها، عند المدارس المتتالية[14]، نذكِّر بأنه منذ الكندي، استُحدثت طريقة فذة للإفصاح عن النغمات، وتحديد طبقاتها بتعيين مواضعها على أوتار العود ودساتينه. قوام هذا التدوين، الأبجدية العربية بدءًا من حرف الألف المشير إلى أول درجة صوتية منخفضة (مطلق وتر البم = "المفروضة")[15]، ثم يتدرج السلم النغمي في ديوانه صعودًا، حتى حرف اللام المساوي لدرجة الجواب (سبابة المثنى)، فهو تسلسل "لوني" يتألف من اثني عشرة نغمة في الديوان، بينها اثني عشر نصف بعد غير متساوية، يرمز لها بالحروف الاثني عشر الأولى من الأبجدية، كالآتي: [أ – ب – ج – د – هـ - و – ز – ح – ط – ي – ك – ل].
وتكرر الحروف ذاتها لنغمات الذي بالكل الثاني (الديواني الثاني)، مميزًا بينها بلفظ "الأولى" و"الأوسط" و"الحادة". وبينما ينطلق الكندي من نغمة مطلق وتر البم (المفروضة) محتسبًا كامل الدرجات الكائنة داخل الديوانين (وهي ستة عشر إذا ما استثنينا الدرجات المكررة)، يبدأ اسحق الموصلي ونظراؤه "ممن جمع العلم بالصناعة والعمل"، من مطلق المثنى وهي عندهم "الاعتماد "، معتبرين بأن "النغم تسعًا"، والعاشرة "نغمة الضعف"[16]، أي أنهم يعتمدون نغمات الديوان الواحد، رافضين احتساب "نغم الأضعاف". وهذا تباين شكلي في الأساس، لأن الانطلاق من المثنى لا ينال من جوهر السلم المستعمل، بقدر ما هو يستجيب إلى مسائل تعبيرية وعملية كتعزيز العزف بين القرار والجواب، وإمكانية الانتقال بين الطبقات، وسهولة تعويض وتر انقطع وقت الحاجة. وإن كنا نرى بأن انتقاد الحسن الكاتب لهذه الطريقة، في محله، حين يقول[17]:
ليس الأمر كما ظن إسحق ومن تبعه: أن في الوترين (يقصد المثنى والزير) من النغم ما يغني عن الجملة، ونسي أنها محاكيات لنغم الحلوق، وقسمت إلى طبقتين: طبقة الصياح وطبقة الأسجاح، وقوبلت كل نغمة حادة بنظيرتها من الثقال حتى كمل اتفاقها وباتت كل واحدة من الأخرى في اللحن.
وفيما يلي، رسم بياني يحدِّد تسوية أوتار العود ومواضع الدساتين الأربعة الأساسية، حسب نظرية المدرسة العربية التأسيسية/ العودية [اسحق والكندي]؛ وبالمقاييس المتعارف عليها [الأصابع، التدوين الأبجدي، النسب، السنت، السافار والنوتة الحديثة متخذين درجة العشيران (لا) لنغمة مطلق البم]:
ويتَّبع الفارابي الطريقة ذاتها، غير أنه لا يكرر نفس الحروف في الديوان الثاني، بل يستعمل الحروف التي تليها حسب تسلسلها: [م – ن – س – ع – ف – ص – ق – ر - ش - ت - ث – خ – ذ الخ.]
بينما يتخذ ابن زيلة توجهًا جديدًا تأكد مع مدرسة صفي الدين، وذلك باستعمال هذه الحروف، لا حسب تسلسلها كحروف، بل بمعناها الحسابي كأعداد متوالية، فيبدأ التدوين بـ الألف ويتواصل مع الحروف العشرة الأولى، أي حتى الياء، كالآتي:
|
أ |
ب |
ج |
د |
هـ |
و |
ز |
ح |
ط |
ي |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ثم تضاف الحروف التسعة الأولى إلى الحرف العاشر:
|
يا |
يب |
يج |
يد |
يه |
يو |
يز |
يح |
يط |
... |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
... |
ثم تضاف إلى الذي عدده عشرون [الكاف = كا – كب – كج... الخ.]... وهكذا.
مع المدرسة المنهجية، تواصل وتوضح استعمال الحروف الأبجدية المفردة والمركبة لتسمية نغمات السلم الموسيقى / فالحروف العشرة الأولى: [ أ ب جـ د هـ و ز ح ط ي] ثم إضافة الحروف التسعة الأولى إلى الحرف العاشر[الياء = يا، يب، يج، يد، يه، يو، يز، يح، يط] ثم إضافتها إلى الحرف الذي عدده عشرون [الكاف = كا، كب، كج... الخ] ثم إضافتها إلى الحرف الذي عدده ثلاثون [اللام = لا، لب، لج... الخ] ثم إضافتها إلى الحرف الذي عدده أربعون [النون = نا، نب، نج، ند... الخ.]
جدول مقارن للديوان الأول في السلم المنهجي: الدساتين بحساب السنت
والنسب
(مع التدوين الأبجدي، العربي الحديث والغربي)
أما فيما يتعلق بالنغم، فقد بدأ البحث، بداية من الفارابي، يتجاوز الدساتين الأساسية، ليشمل كل ما تفرزه الساحة الموسيقية، من أصوات مستقرة وغير مستقرة (درجات المجنب والوسطى الخاصة)، وتنوعت تبعًا لذلك السلالم المقترحة، قبل أن توضح وتثبت مع صفي الدين ومن جاء بعده، تجزئة الديوان إلى ثماني عشرة نغمة محصورة بينها، سبعة عشر بعدًا غير متساوية.
ولا بد من الاعتراف، أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة، بقي التنظير في قضايا النغم والسلم الموسيقي، يتأرجح بين المثالية والواقعية في محاولة لإرساء مبادئ وقواعد الموسيقى العملية في إطار نظرية مقبولة. هذا التأرجح الذي تسبَّب في جملة من التناقضات وحتى بعض الأخطاء، يعود في نظرنا إلى طبيعة هذه الموسيقى التي تتنافى مع الضبط الدقيق والتقنين الصارم، لا شك وأن هذا كان من الدوافع التي أدت في النهاية، إلى التخلي عن دساتين العود[18]. ولا تزال أي محاولة من هذا القبيل في إطار المدرسة الحديثة، تتهاوى أمام تفاصيل الصناعة العمليَّة بتعقيداتها وحركيتها وحيويتها على الدوام.
وهذا التأرجح يبرز ضمنيًا، في مؤلفات كبار منظري الموسيقى عند محاولتهم تحديد نسب الأبعاد اللحنية، فنراهم يعطون لنفس البعد، أكثر من نسبة مما يعسر معه معرفة نوعية البعد المقصود فعلاً في تأليف الأجناس المستعملة عند أرباب الصناعة. وها هو صفي الدين، يعطينا خير شاهد على ذلك.
جدول: تعريفات صفي الدين للأبعاد اللحنية:
|
|
النوع الأول |
النوع الثاني |
النوع الثالث |
النوع الرابع |
|
بعد (ط) (البعد الطنيني) |
8/9 204 سنت |
19683/22528 234 سنت |
2673/3072 241 سنت |
---- |
|
بعد (ج) (أوسط الأبعاد) |
11/12 151سنت |
81/88 143سنت |
59049/65536 182سنت |
2048/2187 114سنت |
|
بعد (ب) (أصغر الأبعاد) |
243/256 90 سنت |
704/729 61 سنت |
32/33، 53 سنت |
------- |
وتأكيدًا للتنوع الحاصل في اعتماد آلة العود لمعالجة مواضع النغم، نقدم فيما يلي جدولاً مقارنًا لمختلف المحاولات المبذولة في هذا المجال [للتوضيح، نستعمل وترًا واحدًا على درجة الدو، مع تنويع المقاييس المتعارف عليها، وهي على التوالي: النسب، السنت، الكوما، السافار، تجزئة الوتر، الأصابع والنوتة الحديثة]:
جدول: نسب الدساتين حسب المدارس العربية الثلاثة
وفي إطار المدرسة المنهجية، تم تجديد وحصر عدد أنواع أبعاد ذي الأربع (العقد الرباعي) وسميت أقسام الطبقة الأولى وكذلك أبعاد ذي الخمس (العقد الخماسي) وسميت أقسام الطبقة الثانية، واستخرجت منها الدوائر اللحنية المذكورة.. كما توسع استعمال الحروف المميزة للنغم، إلى تدوين موسيقي أبجدي، مستدلاً بها على السير اللحني، وذلك بتوزيعها تحت كلمات النص الغنائي، ووضع عدد النقرات الإيقاعية تحت كل نغمة بالأرقام الهندية. فصارت الحروف بمثابة النغم والأعداد بمثابة الأزمنة، ومتى علم هذان في لحن وأشير إلى جنس نغمه وإيقاعه، أمكن إدراك الهيئة اللحنية للمقطوعة المدونة. وهكذا قدمت أقدم وثيقة مدونة وصلتنا عن الموسيقى العربية، مثال ذلك (طريقة في الرمل كواشت)[19]:
[مثال من تدوين صفي الدين: كتاب الأدوار]
[مثال من تدوين ابن غيبي: جامع الألحان]
***
أصول المقامية العربية
نظرية الأصابع والمجاري
بُذلت منذ عهد الأمويين عدة محاولات لوضع قواعد ثابتة في الفن الموسيقي. وازدادت هذه القواعد وضوحًا وانسجامًا بفضل أساتذة العصر العباسي الأول وخاصة الكندي وإسحاق الموصلي. وإن لم يكن إسحاق في مثل تضلع الكندي في علم الموسيقى واستنباط نظرياته، استطاع بالرغم من ذلك أن يخضع المدرسة العربية القديمة إلى مذهب موسيقي تطبيقي ونظري متآلف العناصر. فهو "الذي صحح أجناس الغناء وطرائقه مواصلة لجهود والده إبراهيم الموصلي الذي جنَّس الطرائق وحدد تسمياتها، وكانت قبله تعرف الطرائق بالألحان أو اللحون، فيقال: اللحن الأول، والثاني، والثالث، والرابع والخامس والسادس والسابع[20].. فصارت، تعرف الألحان بالطرائق - وذلك انطلاقًا من وظيفة كل من المطلق والأصابع - كما سنبين ذلك.
المائة الصوت المختارة:
وضع أبو الفرج الأصبهاني كتابه الجامع: الأغاني الكبير، على أساس المائة صوت المختارة - وهي أغان اختيرت للرشيد من الغناء العربي كله (من الجاهلية إلى عصر المؤلف / القرن الرابع الهجري – العاشر الميلادي) - ثم اختير منها خمسون، واختير من الخمسين عشرة، ومن العشرة ثلاثة أصوات مع الإجماع عليها، وهي[21]:
- القصر النخل فالقصر فالجماء بينهما (ابن قطيفة / معبد: خفيف الثقيل الأول)
- أهاج هواك المنزل المتقادم (نصيب / ابن محرز: ثقيل الثاني)
- تَشكَّى الكُميْتَ الجري لما جهدته (ابن أبي ربيعة / ابن سريج: ثقيل الثاني)
واختاروا صوتًا واحدًا هو [أهاج هواك المنزل المتقادم] وذكروا أن طريقته لا تبقي نغمة من نغمات التلحين إلا وتوجد بها (التيفاشي).
والمائة صوت ثبتها أبو الفرج في شكل مجموعات مرفق كل منها باسم الشاعر والمغني، مع إشارات تفيد "الإيقاع" و"المقام" (وأحيانًا معلومات أخرى). مثال ذلك: [الشعر لأبي العتاهية والغناء لفريدة، خفيف الرمل بالوسطى].
فإلى جانب درجة الأساس (مفروضه/اعتماد) التي يمكن أن تستمد من نغمة مطلق الوتر أو من أحد الدساتين، يوجد عنصر أساسي آخر يحدد لنا نوعية المقام (وكان يطلق عليه اسم طريقة أو لحن أو إصبع أو طنين) وهو المجرى الذي يكون على شكلين: مجرى الوسطى ويعطينا مسافة الثلاثية الصغيرة؛ ومجرى البنصر وتستخرج منه الثلاثية الكبيرة.. أي عندما نقول مثلاً: "مطلق في مجرى الوسطى"، فإننا نعنى بذلك جمعًا أو مقامًا درجة أساسه نغمة مطلق الوتر الثالث (المثنى = نقطة البداية عند العوديين) وتسلسل خليته تحتوى على ثلاثية صغيرة.. لذلك فإن المجربين لا يتقابلان، الأمر الذي جعل ابن المنجم يؤكد بأن جميع الذي يأتلف في غناء العرب من النغمات العشر، يكون فيه الغناء ثماني نغمات تبين مذهبهم في ذلك. وشد بعض النغم إلى بعض أكثر ما يبنى عليه الصوت من النغمات الثماني كلها. فعلى هذا يأتلف نغم غناء العرب، وعليه تجرى عامة أصناف الغناء.
وقد يمكن أن يلطف الصوت حتى يكون مؤلفًا من تسع نغمات، ومن العشر نغمات كلها، وذلك ينال بتأليف لطيف، وحيلة رفيعة، وعلم بوجوه التأليف ومصارفه.."[22]. وعلى هذا الأساس، أصبح متيسرًا فك رموز نظرية الأصابع والمجاري التي يذكرها كتاب الأغاني.
وهي في مجموعها، تتلخص في ثمانية طرائق/أصابع، والتي يمكن إثباتها – تقريبًا - كالآتي:
وهذا الصنف الأول بأنواعه الثلاثة (وهو يعتمد أساسًا على الجنس الطنيني/الدياتوني، مع احتمالات لونية وتأليفية)، وهي تحاكي شكلاً اليوم: العجم والنهاوند والكردي؛ وعند المتوسطين المنهجيين: عشاق، نوى، أبوسليك. وهذا النظام النغمي للحون يتضح أكثر مع المدرسة الإبداعية/الطنبورية (القرن العاشر الهجري)، وذلك بإبراز الصنف الثاني القوي المستقيم، الذي يأخذ في الاعتبار درجتي المجنب ووسطى زلزل، أي بعد الثنائية الخاصة. مما يضيف ثلاثة أنواع أخرى، تقريبًا هي:
[ 1- 4/3 - 4/3] ، [4/3 – 4/3 – 1] ، [4/3 – 1 – 4/3].
وهو ما يحاكي شكلاً اليوم: الراست، البياتي، السيكاه؛ وعند المتوسطين المنهجيين: راست، نوروز/حسيني، عراق... ومما لا شك فيه أن مختلف هذه الأنواع كانت متداولة في المدرسة العربية القديمة/العودية، غير أنه كما سبق وأشرنا بالنسبة للمسافات، لم يتم التعرض إليها نظرًا لعدم استقرارها.
من اللحون والطنينات والأصابع، إلى الطرائق والجموع
تواصل مع المنظرين أمثال الفارابي وابن سينا وابن زيلة، وصف النظام النغمي على قاعدة الأجناس، أجمعوا على كونها ثلاثة: قوية، ورخوة (ملونة وتأليفية)، ومعتدلة (راسمة)، والجماعات أو الجموع الناتجة عنها عن طريق الترتيب والانتقال الصاعد أو الهابط (وعددها اثني عشر): "من أراد أن يؤلف لحنًا، فيجب أن يفرض – أولاً – جماعة من الجماعات، إما تامة، وإما ناقصة، محدودة التمديد، ويرتب فيه الجنس أو الأجناس التي تحتمله، سواء حفظ الجنس بحاله، أو رأى أن يداخله بتجنيس آخر، كأن ينتقل بين طرفي الذي بالأربعة من جنس إلى جنس.. ثم ليفرض انتقالاً معلومًا، وليجعل للانتقال إيقاعًا معلومًا؛ من هزج موصل، أو إيقاع مفصل. فإذا فعل هذا، فقد ألف لحنًا"[23].
ومع القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي[24]، نلاحظ بروز تسميات تجمع بين البعدين التطبيقي والوصفي؛ وإن كنا نلاحظ، فيما يتعلق بهذه الطرائق (المقامات) وأسمائها، كثيرًا من الاختلاف، أغلبها تنسب إلى الأصابع، والبقية إلى الدساتين. فالأنواع المشهورة والمنسوبة إلى الأصابع الأربعة، هي[25]:
1. المطلق: وينسب إلى الخنصر (لأنهما سواء في التسوية)، سمي مطلقًا لاحتواء النغم المطلقات عليه واحتواء نظائرها.
2. المزموم: وينسب للسبابة، وهو أول ما يلازم من النغم في الوتر.
3. المحمول: وينسب إلى الوسطى، إما في دستان الوسطى الأول (القديمة/وسطى الفرس) أو الثاني (وسطى زلزل). وهو يشبه بشيء محمول بين شيئين، فكأنه محمول بين المطلق والمزموم، والمحتوى عليه الوسطى. (ومن أصناف المحمولات: المعلق: ماهو من الأجناس بالوسطى والمطلق)
4. المحصور: وينسب إلى البنصر، سمي كذلك لانحصار الصوت فيه وقوته.
هكذا، تم الانتقال من مجريين في كل طبقة (أحدهما منسوب إلى الوسطى والثاني إلى البنصر)؛ ثم صارت المجاري الألحان ثلاثة، وهي منسوبة إلى الوسطييْن والبنصر (وتسمى المجاري)؛ تضاف إليها تنويعات عدة. ومتى لينت نغمة السبابة فأبدلت بها نغمة المجنب سمي ذلك التجنيب (وهو إما تلوينًا للجنس الأصل أو تغييرًا له). والتليين ينال أيضًا المزموم (مجنب السبابة – وسطى الفرس – وسطى زلزل)، وكذلك الوسطى/مجنب الوسطى (الدستان الذي يقع بين دستاني السبابة ووسطى القدماء أي الفرس).
كما تمت الإشارة إلى تفرعات عدة، خاصة ما تعلق منها بتنويعات عنصر الإيقاع - وهي في الواقع، ليست بطرائق - من ذلك:
- الماخوري (الثقيل الثاني الخفيف): حذف بعض نقرات الإيقاع الأصلية المفردة أو تخفيفها والإسراع فيها بالإشمامات والاختلاسات والنقرات اللينة والوقفات في خلال ذلك. وهو يجوز في سائر الطرائق، غير أنه اشتهر في بعضها (كان إبراهيم الموصلي يحب الغناء فيه ويكثره، فنسب إليه).
- المخالٍف: هو الذي خولف بين أدوار إيقاعه بالعدد أو الترتيب، وهو يقع في الرمل والهزج كثيرًا فنسب إليهما، وإن كان ممكنًا في سائر الإيقاعات. وهو يختص بالطنبور أكثر من اختصاصه بالعود، وأصله رمل محمول وإنما خولف إيقاعه فرُفعت السبابة عن دستانها إلى المجنب فسمي بهذا الاسم، والغناء فيه مليح مطرب.
- السريجي: يشبه بنحو من ألحان ابن سريج، وكان قد تفرد بها في عصره فعرفت له. ليس بطريقة مفردة بذاتها ولكنه مذهب لابن سريج استعمل فيه أغانيه وقطع به الأزمان وعرف به وهو يدخل على سائر الطرائق والألحان ويجيء في تضاعيفها وعُلحها (الجهال يعتبرونه طريقة).
- المجنب: ليس بطريقة مفردة أيضًا، وإنما هو مذهب لإسحق الموصلي، ابتدعه وذلك لأن حلفه نفر في آخر عمره عن الوتر وبايَنه فتحيل حتى عفق المجنب، وذلك أنه جس إلى ما تحت لزوم دستان السبابة فيه فجعله فوقه، وشد له هذا الدستان وأمال غنائه كله إليه فصار مذهبًا له، وخفي ما لحقه في تضاعيفه، وهذا حسن.
- الخسرواني: في عصرنا من يوقع الرمل المعلق بإرخاء بعض الأوتار ويسميه "خسروانيًا" ويمر ذلك على أكثر الناس وليس هو بالخسرواني، لأن تلك الطريقة فارسية كثيرة الأدوار والنقرات، تتفرع وتخرج من نوع إلى نوع، ولا يمكن إيقاعها – بالحقيقة – إلا في العيدان الأعجمية الدقيقة الأعناق.
- الطرخاني: مجرد توقيع الرمل المنسرح ويميله بعض الإمالة.
- الحميري: طريقة تختص بالطنابير وعليها وُضعت، وهي خفيف الرمل المحصور قد نقَّصوا من عدد نقراته وأفسدوا أدواره ولقبوه هذا اللقب.
- خفيف الهزج: من أهم الطرائق وأغربها وأعجبها.
وفي شرح بحور التلحين التي ترجع إليها الأصوات المائة المذكورة وغيرها من سائر الغناء العربي القديم، نلاحظ بعض التباين حسب المصادر، من ذلك: أ/ البحور ستة وثلاثين بحرًا أصلها كلها الثقيل الأول ثم يتفرع منه ستة بحور وهي ثقيل أول مطلق وثقيل أول معلق وثقيل أول مزموم وثقيل أول مسرج وثقيل أول محمول وثقيل أول مجنب... ثم يتصرف في كل ثقيل أول منها ستة بحور: ثاني ثقيل، وخفيف ثقيل وخفيف ورمل وهزج وهزج الهزج، فيكون الجميع ستة وثلاثين وذلك من ضرب ستة في ستة إذ كان لكل ثقيل أول ستة من هذه البحور المعدودة، ثم يخرج من هذه الأًول في الغناء العربي القديم أربعة أصوات مختارة هي: الحجازي والممخّر والزطّي والمرجل، فهذا جملة بحور الغناء العربي القديم لا يمكن أن يشذَّ عنها منه شيء البتة[26].
الطرائق العربية: الثقيل الأول أربعة أنواع هي الأصول الثقال وأربعة أنواع هي خفايفها المساوية لها في النقرات والدوار وإنما يبينها الثقل والخفة: المطلق والمزموم والمحمول والمحصور – الثقيل الثاني أربعة أنواع هي الأصول وأربعة أنواع خفايفها مساوية لها وهي الماخوريات التي لا يُوقع منها شيئًا في زماننا هذا غير نوع واحد غير صحيح. ثم الرمل وهو أربعة أنواع ثقال لها خفايف مساوية لنقراتها. ثم الهزج وهو أربعة أنواع بطيّة وأربعة سريعة وعي خفايف الأهزاج التي هي خفايفها.
مجمل الطرائق وخفايفها اثنان وثلاثون طريقة. ثم المركبات وهي أربعة أنواع أخر، فإذا حسب الجميع صار أربعًا وستين طريقة والأربعة أنواع هي ما تركب وصارت الأصول كالأجسام التي تُدخل عليها الأعراض فبعضها منسوب إلى الأصابع وبعضها منسوب إلى الطرائق مُحدثة مبتدعة وقديمة، وهي بـ الوسطى والمجنب والممخر والمُصرع.
وإذا ما سلمنا بما جاء في بعض مصادر القرن السابع هـ / الثالث عشر م[27]، فإنه لم يعد يُوقع من الماخوريات غير نوع واحد غير صحيح؛ بل ولم يبق من الطرائق إلا المخالف وهو من الطرائق المستعملة في الطنابير أكثر من العيدان ثم الطريقة المنسوبة إلى ابن طرخان يظن أنه أتى بها كما أتى ابن سريج وما صنع شيئًا إنما هي خفيف الرمل المحمول أماله بعض الميل وأحاله عن تركيبه وزاد في نقراته وسماه بهذا الاسم ولو أراد مريد أن يصنع عدة طرائق من هذا الثقيل ويسميها باسمه لفعل غير أنه يخالف ما جده المتقدمون. وها هنا طريقة تسمى الحميرية وهي خفيف الرمل المحصور قد غيرها بعض التغيير... وإيقاع آخر يسمى الخسرواني وهو فارسي.
من الطريقة والجمع إلى الشدِّ والدور، ثم النغم والمقام والطبع
مع القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، وفي إطار المدرسة المنهجية (بداية من صفي الدين)، صارت الطرائق تعرف بـ الأدوار والأوازات (أي المقامات الأصلية وفروعها) وأعطي لكل منها اسمًا مخصوصًا:
- اثنا عشر أساسية (أدوار أو شدود، ج. دور أو شد، وتسمى البردوات/بردة بلغة الفرس): [عشاق، نوى، بوسليك، راست، عراق، اصفهان، زيرا فكند، زنكوله، بزرك، راهوى، حسيني وحجازي].
- استخرجت من البرداوات أصوات في مجرى البُرْداوات إلا أنها دونها في العمل تسمى الأوازات (ج أواز)، وهي ستة فرعية: [كواشت، كردانية، سلمك، نوروز وماية وشهناز]. وهذه الأوازات راجعة إلى البرداوات، استخرج من كل برداوين أواز فكانت ستة بسبب ذلك.
فهذه جملة بحور الأغاني التي يرجع إليها كل شعر يلحن ويُغنى به في الشرق في هذا التاريخ بلغتي العرب والعجم لا يشذ عنها... وقد قدمت في شكل دوائر لحنية يصل عددها إلى أربع وثمانين دائرة (إحدى وتسعون في عصر اللاذقي)، كل منها بمثابة سلم موسيقى؛ وهو مجموع جاء نتيجة إضافة كل قسم من أقسام الطبقة الأولى وعددها سبعة أقسام إلى كل قسم من أقسام الطبقة الثانية وعددها اثنتا عشر قسمًا.. ومن هذه الدوائر ما هو ملائم وما هو واضح التنافر أو خفي التنافر. هكذا لقد استعملت لأول مرة، عملية التصوير حيث صُور كل دور في سبعة عشر درجة أي على سائر نغمات السلم المذكور.
كما عُرفت الأبعاد بحروف الهجاء: البعد الطنينى (ط)، والبقية (بـ)، الثنائية الخاصة (ج). وهذه الأدوار الاثني عشر الأساسية كما يعرفها صفى الدين من اليسار إلى اليمين (المجموعة الأولى من الحروف تدل على الأبعاد الفاصلة بين نغماتها، والمجموعة الثانية تدل على الدرجات المكونة لسلالمها):
ونجد لدى العُمري توضيحات هامة تساعدنا على ربط هذه المصطلحات بعضها ببعض. حيث يقول: رأيت بين القدماء والمحدثين، اختلافًا في ألقاب الأنغام التي صنعوا فيها الأصوات اختلافًا في الأسماء لا في المسميات، أي اتفاق القدماء والمحدثين في المعنى واختلافهم في اللفظ. وعند تنزيل أسماء المحدثين على أسماء القدماء، نلاحظ ما يلي[28]:
الأوائل رحمهم الله، رتبوا ألحانهم على نوعين: ضرب ولحن، مسميات بأسماء اصطلحوا عليها وجعلوا:
أنواع الضروب ستة: ثقيل أول وثقيل ثان وخفيف الثقيل ورمل وخفيف الرمل وهزج.. وهذا كما يُقال إن الضرب فيه بنقرات ثقال وخفاف وخفاف الخفاف.
أما الأصابع فهي الألحان عندهم، وهي ست كذلك: المطلق والمعلق والمحمول والمنسرح والمزموم والمجنب. وإذا ضربت ثلثه في ستة كانت ثمانية عشر رجوعًا إلى أن الضرب مع اللحن يختلف مع الثقال والخفاف وخفاف الخفاف، فتحالف الصوت مع الضرب بالقوة والضرب فيسمى كل واحد باسمٍ ولهذا يقولون مطلق السبابة والوسطى والخنصر والشهادة أو مقبوضها كل ذلك إشارة منهم إلى الألحان المختلفة فسموا كل لحن باسم علم عليه يُعرف به ليلاّ يصل العلم عند التعليم. كذلك فعل المتأخرون من الفرس حين سموا هذه الأسماء الأعجمية المصطلح عليها في زمننا وهي الراست والعراق والزيرفكند والاصفهان والزنكلا والبزرك والراهوي والحسيني والماآه وأبوسليك والنوى والعشاق، وأوازها وهي: النيروز والشهناز والسلمك والحجاز والكوشت، على اختلاف في هذه التسمية فهذه تلك الست تضاعفت ثلاثة بحسب التركب فبلغت ثمانية عشر:
- المطلق هو الراست
- المعلق هو العراق
- المحمول هو الزيرفكند
- المنسرح هو اصفهان
- المزموم هو الزنكلا
- المجنب هو بُزْرَك
ثم تركبت الستة الباقية من الستة الأولى:
- الرهوي من المطلق والمعلق
- الحسيني من المحمول والمنسرح
- الماآه وأبوسليك من المزموم
- النوى والعشاق من المجنب
ثم أخذ بالتركب:
- النيروز من المطلق والمعلق لاختلاف الضرب
- الشهناز من المحمول والمنسرح
- السلمك من المزموم والمجنب
- الزركشي من المحمول والمنسرح
- الحجاز من المزموم
- الكواشت من المجنب
أما الماخوري والمحصور والمشكول فتأخر تسميته مع متأخري أوايلهم وكذلك غيرها، وتركيبها كتركيب الشاذ عند المتأخرين والله أعلم.
وفيما يلي، جدول مقارن لمختلف المصطلحات المستعملة لدى المدارس الثلاثة:
مصطلحات الطرائق
المقترنة (عند القدماء والمحدثين:
IX
–
XIII)
أ/ تشابه مباشر ب / تشابه مركب
|
الطنبوريون |
المنهجيون |
|
المنهجيون |
الطنبوريون |
المؤسسون (العوديون) |
|
مطلق + معلق |
راهوي |
|
بوسلك |
مطلق: ½1 1 |
إصبع: 3 – 6 |
|
محمول + منسرح |
حسيني |
|
نوى |
معلق: 1 ½ 1 |
إصبع: 1 – 4 – 7 |
|
مزموم |
ماآه + بوسلك |
|
عشاق راست |
محمول: 1 1 ½ 1 ¾ ¾ |
وسطى (قديمة/فارسية/زلزلية) |
|
مجنب |
نوى + عشاق |
|
عراق |
منسرح: ¾ 1 ¾ |
------- |
|
---------- |
--------- |
|
نوروز |
مزموم : ¾ ¾ 1 |
سبابة (---) |
|
مطلق + معلق |
نوروز |
|
بزرك |
مجنب: 1 1 ½ |
إصبع: 2 – 5 – 8 |
|
محمول + منسرح |
شهناز |
|
بوسلك |
محصور: ½ 1 1 |
بنصر |
|
مزموم + مجنب |
سلمك |
|
|
|
|
|
محمول + منسرح |
زركشي |
|
|
|
|
|
مزموم |
حجازي |
|
|
|
|
|
مجنب |
كواشت |
|
|
|
|
أ / تشابه مباشر ب / تشابه بالتركيب
|
الطنبوريون (المتوسطون) |
المنهجيون (المتأخرون) |
|
المنهجيون (المتأخرون) |
الطنبوريون (المتوسطون) |
|
مطلق |
راست |
|
راهوي |
مطلق + معلق |
|
معلق |
عراق |
|
حسيني |
محمول + منسرح |
|
محمول |
زرافكند |
|
ماآه + بوسلك |
مزموم |
|
منسرح |
إصبهان |
|
نوى + عشاق |
مجنب |
|
مزموم |
زنكولا |
|
-------- |
|
|
مجنب |
بُزرك |
|
نيروز |
مطلق + معلق |
|
|
|
|
شهناز |
محمول + منسرح |
|
|
|
|
سلمك |
مزموم + مجنب |
|
|
|
|
زركشي |
محمول + منسرح |
|
|
|
|
حجازي |
مزموم |
|
|
|
|
كواشت |
مجنب |
***
الخصوصيات المقامية:
المقام
من الملاحظ، أن مصطلح "مقام" (ج. مقامات) الذي حل محل الاصطلاحات [إصبع- طنين - لحن - شد - جمع] و[طريقة - بحر - دور - برده - أواز]، لم يعمّ استعماله إلا مع القرن الثامن الهجري/الرابع عشر ميلادي[29]. المتأخرون قد سموا بعض الألحان المشهورة في زمانهم "مقام (12) وبعضها أواز (7) وبعضها شعبة (24) وبعضها تركيب (30). ويوجد البعض الآخر منها لا اسم له عندهم). أما الآن فيسمون تلك الألحان بمقام فقط "... وهي في عصر اللاذقي، إحدى وتسعون دائرة حاصلة من إضافة أقسام الطبقة الثانية إلى أقسام الطبقة الأولى"[30].
هكذا، نلاحظ امتدادا لمذهب المتوسطين عند المتأخرين (بداية من العاشر هـ / السادس عشر م)، الذين توسعوا بدورهم في فروع الأصول واستخراج ما يتشعب. وهذه القائمة كما وردت لدى قدماء المنهجيين (صفي الدين) والمتأخرين منهم (اللاذقي):
|
المقامات |
الأوازات |
الشعب |
التراكيب |
|
راست |
كواشت - كواشت |
دوكاه - يكاه |
--- - سنبلة |
|
عراق |
نوروز - نوروز |
سيكاه - دوكاه |
--- - عزال |
|
أصفهان |
سلمك - سلمك |
جهاركاه - سيكاه |
--- - نهفت |
|
زيرافكند |
شهناز - شهناز |
بنجكاه - جهاركاه |
--- - نيريز صغير |
|
بزرك |
كردانية - حصار |
عشيران |
--- - نيريز كبير |
|
زنكولة |
ماية - كردانية |
نوروز عرب |
--- - هاوند صغير |
|
راهوي |
---- - ماية |
ماهور |
--- - قرجغار |
|
حسيني |
|
نوروز خارا |
--- - عجم |
|
حجازي |
|
نوروز بياتي |
--- - اصفهانك |
|
أبوسليك |
|
حصار |
--- - راحة الأرواح |
|
نوى |
|
نهفت |
--- - زوالي سه كاه |
|
عشاق |
|
عزال |
--- - زوالي اصفهان |
|
|
|
أوج |
--- - نمار |
|
|
|
نيريز |
--- - نيشابورك |
|
|
|
مبرقع |
--- - خوذي |
|
|
|
ركب |
--- - حجست |
|
|
|
صبا |
--- - زمزم |
|
|
|
همايون |
--- - همايون |
|
|
|
اصفهانك |
--- - مستعار |
|
|
|
زاولي |
--- - نكانيك |
|
|
|
بستة نكار |
--- - بنجكاه أصل |
|
|
|
نهاوند |
--- - بنجكاه زايد |
|
|
|
خوذي |
--- - محيّر |
|
|
|
محيّر |
--- - أوج |
|
|
|
|
--- - ماهور كبير |
|
|
|
|
--- - ماهور صغير |
|
|
|
|
--- - بستة نكار |
|
|
|
|
--- - عشيران |
مذاهب هذه القسمة من أصول وفروع ومركبة توسعت وتنوعت على مر العصور، مع اختلاف في هيئات الشعب والأوازات. وتوجد روايات تبلغ فيها المقامات الأساسية والفرعية ستة وثمانين (86) مقامًا، تم اختيارها من مائتين وخمسة وثلاثين (235) مقامًا. ويصل المجموع حوالي 360 مقامًا عند العرب والأتراك والفرس، بين أساسية وفرعية وفرعية مركبة (341 حسب ترتيب سليم الحلو، ص 88-133؛ المشهور منها 32 عند عرب المشرق والأتراك، دون احتساب الطبوع المغاربية). إن توليد المقامات ليس له نهاية، لكنها عمليًا تنحصر في خمسة وتسعين مقامًا، استعمل منها زمنًا طويلاً لدى الممارسين، من الثلاثين إلى الأربعين مقامًا. وتنظيمًا لهذا الكم الهائل من المقامات، اجتهد بعضهم في تصنيفها بطريقة تبسط سبل التعامل معها، من ذلك ترتيبها بحسب درجات استقرارها الأصلية؛ أو بحسب المقامات الأصلية وفصائلها، على النحو التالي[31]:
المقامات بحسب درجة ارتكازها الأصلية[32]
|
درجة الارتكاز |
المقامات |
درجة الارتكاز |
المقامات |
|
- اليكاه
- العشيران
- عجم عشيران
- العراق
- الراست |
اليكاه – شد عربان – فرحفزا – سلطان يكاه – طرز جديد – نهوفت العرب. (حسيني عشيران) – سوزدل – شوق طرب. عجم عشيران – شوق آور – شوق أفزا - عجم مرصع . العراق – (أوج) – بستة نكار - راحة الأرواح – فرحناك – أويج آرا. الراست – ماهور – ( كردان) - رهاوي – سوزدلارا – زاويل – سازكار – (زنكلاه) - دلنشين – بسنديدة - سوزناك – نهاوند – نهاوند كردي – نهاوند كبير – نهاوند مرصع – نوأثر – نكريز – بسنديدة - حجاز كار – حجاز كار كرد – زنجران – سوزناك جديد – طرزنوين. |
- الدوكاه
- السيكاه
- الجهاركاه - نوى |
بياتي – عشاق تركي – حسيني- طاهر - عرضبار – (حسيني) –محير- (قارجغار / شوري) - كلعزار – بياتين – صبا- صبا زمزمة – صبا بوسليك – قارجغار – كرد – شاهناز كردي – حجاز – حجاز عجمي – شاهناز – (بوسليك) – بوسليك جديد – (عشاق مصري) – نيشابورك – أصفهان - حصار. السيكاه – ماية – شعار – مستعار – هزام. جهاركاه – جهاركاه تركي. نوى – نوى كرد – نوى عجم – نوى بوسليك – حجاز نوى |
المقامات بحسب فصائلها[33]
|
المقام |
الفصائل |
المقام |
الفصائل |
|
- عجم
- راست
- سيكاه - هزام - عراق - نهاوند
|
عجم عشيران - شوق أفزا – عجم مرصع – جهاركاه . راست كردان – رهاوي – ماهور – سوزدل آرا – زاويل – سازكار – دلنشين – سوزناك – يكاه – نوى – نيرز راست – نيشابورك – أصفهان. ماية – شعار- أويج – مستعار – فرحناك. راحة الأرواح. بسته نكار. نهاوند كرذي – نهاوند كبير – نهاوند مرصع – فرحفزا – سلطاني يكاه – طرز جديد – نوى عجم – بوسليك – بوسليك جديد – عشاق مصري – شوق آور. |
- نوأثر - حجاز
- كرد
- بياتي
- صبا |
حصار – نكريز – بسنديدة – حجاز كار – شد عربان – سوزدل – أويج آرا – شاهناز- جهاركاه تركي - نهوفت العرب – حجاز النوى – حجاز عجمي – زنجران – سوزناك جديد. حجاز كار كرد – شوق طرب – طرزنوين – شاهناز كردي – حصار كردي . حسيني – محير – طاهر – عرضبار – عشاق تركي – حسيني عشيران – بياتين – قارجغار. صبا زمزمة – صبا بوسليك. |
تبسيط المقامات واختصارها في 11 جنسا رئيسية (بحجة تماثلها)[34]
|
الجنس الأساسي |
الارتكاز الأصلي |
النسب |
الجنس المماثل |
الارتكاز |
|
العجم عشيران |
عجم عشيران |
(1) (1) (½) |
الجهاركاه |
جهاركاه |
|
الراست |
راست |
(1) *(¾) * (¾) |
اليكاه |
يكاه |
|
نهاوند |
راست |
(1) (½) (1) |
البوسلك العشاق |
دوكاه دوكاه |
|
نوأثر |
راست |
(1) (½) (1½) |
الحصار |
دوكاه |
|
بياتي |
دوكاه |
* (¾)* (¾) (1) |
|
|
|
حجاز |
دوكاه |
(½) (1½) (½) |
الحجاز كار السوزدل الشاهناز الشدعربان الأوج آرا |
راست عشيران دوكاه يكاه كوشت |
|
الصبا |
دوكاه |
* (¾) * (¾) (½) |
|
|
|
الكرد |
دوكاه |
(½) (1) (1) |
العجم كرد |
دوكاه |
|
السيكاه |
سيكاه |
* (¾) (1) |
الفرحناك |
عراق |
|
العراق |
عراق |
* (¾) (1) * (¾) |
|
|
|
الهزام |
سيكاه |
* (¾) (1) (½) |
راحة الأرواح |
عراق |
* = نسبة تقريبية
***
الطبع
كما ظهر مصطلح "طبع" (ج. طبوع) بالمغرب العربي، مع القرن العاشر الهجري / السادس عشر ميلادي. أقدم وثيقة وصلتنا تتعلَّق بالطبوع، تعود إلى العهد الحفصي من خلال قصيد في 56 بيت من بحر البسيط، في ذكر الرسول (صلعم) للشاعر الصوفي محمد الظريف (تـ 1385)، مطلعه: "من سفك دمعي ومن تحبير أجفاني". ست أبيات منه [15-20] تتضمَّن مجموعة تسميات، دون ذكر مصطلح الطبع[35]. وهي على التوالي:
الرهاوي – الذيل – الرمل – الإصبهان – الصيكة – المحير – المزموم – العراق – الحسين – النوى – ( رصد الذيل) - الماية - الرصد - الأصبعين
كما ورد مصطلح الطبع مع أربع تسميات: [ذيل - عراق عرب - رمل ماية- رمل] في هامش لمقطوعة زجلية لـ لسان الدين ابن الخطيب[36] (1313- 1374) ولا ندري بالتحديد، إذا كان هذا التعليق هو من إضافة أحد ناسخي المخطوط، أو يعود إلى المؤلِّف نفسه الذي وضع مصنَّفه بعد صرفه عن الأندلس واستقراره بالمغرب.
ولم تتوضح مسألة الطبوع إلا مع أوائل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، وذلك من خلال قصيد في إحدى عشر بيتا من بحر الطويل، للقاضي عبد الواحد الونشريسي (1478-1548)، أواخر عهد الوطاسيين بالمغرب الأقصى، مطلعه: "طبائع ما في الكون أربعة"، يذكر فيه مصطلح الطبع مع 17 تسمية (5 أصول و12 فروع)، توسعت فيما بعد لتصل إلى 26 (5 أصول و21 فروع). يقول البوعصامي: "أعلم أن كل ما يدور على الألسنة من أنواع التلحين – على اختلاف أجناسها – فهو راجع إلى خمسة: أصول الطبوع وهذه الخمسة تفرعت عنها فروع، وكلها طبوع". هكذا، تزايد عدد الطبوع من 13 (الظريف تـ 1385) إلى 17 (الونشريسي تـ 1549)، 23 (الوجدي XVII)، ثم مع البوعصامي والحايك (XVIII) شجرة بها 26 طبعا: 5 أساسية و21 فرعية (غير أن الصيكة والمشرقي خارجان عن الشجرة). يوجد نفس الشيء لدى إبراهيم التادلي (تـ 1894) في كتابه أغاني السكا في علم الموسيقى. وهذه الأصول والفروع تكون كالآتي:
|
طبوع فرعية |
طبع أساسي |
|
رصد الذيل ـ رمل الذيل عراق [العرب / العجم- مجنب الذيل – استهلال الذيل]. |
ـ ذيل |
|
رصد – حسين – رمل [الماية – انقلاب الرمل – صيكة] |
ـ ماية |
|
أصبهان – عشاق– حصار - زوركند – حجاز[الكبير / المشرقي ] |
ـ زيدان |
|
غريبة الحسين [حمدان – مشرقي] |
ـ مزموم |
|
................. |
ـ غريبة المحرّرة |
هذه المصطلحات الخاصة بالطبوع المغاربية، تحاكي أسماء الأوتار الأربعة للعود التقليدي وكذلك بالنغمات الأصول السبعة للسلم، والتي تسمَّى "في عرف هذا الإقليم بالذيل للدرجة الأولى ثم الماية للدرجة الثانية ثم السيكة للثالثة ثم المزموم للرابعة ثم الرمل للخامسة ثم الحسين للسادسة ثم سيكة حسين للسابعة على الترتيب يرمز ذلك بقولنا[37]:
|
د |
م |
ســـ |
ــــمـــ |
ـــر |
حـــ |
ــــس |
|
ديل |
ماية |
سيكة |
مزموم |
رمل |
حسين |
سيكة حسين |
عمليًا، تتخذ هذه الطبوع خاصيات تختلف باختلاف الأرصدة المغاربية، يمكننا حوصلتها في الجدول التالي (علمًا وأن تماثل المصطلحات لا يعني تماثل الطبوع أو الأجناس المكونة لها)[38].
جدول مقارن للطبوع المغاربية بحسب الاصطلاحات المتداولة
|
الطبوع |
ليبيا |
تونس |
الجزائر |
المغرب |
|
الطبوع |
ليبيا |
تونس |
الجزائر |
المغرب |
|
ـ ذيل |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- رمل الكبير |
|
+ |
|
|
|
مجنب الذيل |
|
+ |
|
+ |
|
- رمل الماية |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- رصد الذيل |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- الماية |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- رمل الذيل |
|
|
|
+ |
|
- انقلاب الرمل |
|
|
|
+ |
|
- استهلال الذيل |
|
|
|
+ |
|
- صيكة |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- ذيل قسنطيني |
|
|
+ |
|
|
- صيكة حسين |
|
|
+ |
|
|
- ذيل براني |
|
|
+ |
|
|
- أصبهان |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
ـ ماية |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- عشاق |
|
|
|
+ |
|
ـ زيدان |
|
|
+ |
+ |
|
- حصار |
|
|
|
+ |
|
ـ مزموم |
|
+ |
+ |
|
|
- زوركند |
|
|
|
+ |
|
- مزموم محير |
+ |
|
|
|
|
- حجاز الكبير |
|
|
|
+ |
|
- مزموم صنعة |
|
|
|
+ |
|
- حجاز المشرقي |
|
|
|
+ |
|
- مزموم مُوال |
|
|
|
+ |
|
- مشرقي |
|
|
|
+ |
|
ـ غريبة المحرّرة |
|
|
|
+ |
|
- مشرقي صغير |
|
|
|
+ |
|
- غريبة الحسين |
|
|
+ |
+ |
|
- نوى |
+ |
+ |
+ |
|
|
- عراق |
+ |
+ |
+ |
|
|
- أصبعين |
+ |
+ |
|
|
|
- عراق العرب |
|
|
|
+ |
|
- انقلاب أصبعين |
|
+ |
|
|
|
- عراق العجم |
|
|
|
+ |
|
- محير |
|
|
+ |
|
|
- رصد |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- محير عراق |
|
+ |
|
|
|
- رصد قناوي |
|
|
|
+ |
|
- محير صيكة |
|
+ |
|
|
|
- رصد عبيدي |
|
+ |
|
|
|
- رهاوي |
|
+ |
+ |
|
|
- حسين |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- ساحلي |
|
|
+ |
|
|
- حسين عجم |
+ |
+ |
|
|
|
- جاركه |
|
|
+ |
|
|
- حسين صبا |
+ |
+ |
|
|
|
- مُوال |
|
|
+ |
|
|
- حسين نيرز |
|
+ |
|
|
|
- غريب |
|
|
+ |
|
|
- حسين عشيران |
|
+ |
|
|
|
- مجنبة |
|
|
+ |
|
|
- رمل |
+ |
+ |
+ |
|
|
- حمدان |
|
|
|
+ |
|
- رمل العشية |
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
الأجناس المستعملة
|
الأجناس المستعملة |
المصطلحات المحلية |
|
(1) (1) (½) |
غريبة الحسين (المغرب) |
|
(1) (½) (1) |
حسين (المغرب) |
|
(½) (1) (1) (1) |
صيكة (المغرب- الجزائر) |
|
(1) * (¾)* (¾) (1) |
ذيل (تونس – ليبيا) |
|
* (¾)* (¾) (1) |
حسين (تونس-ليبيا) |
|
*(¾) (1) |
صيكة (تونس – ليبيا) |
|
(1) * (¾)* (1 4/1) (½) |
رصد الذيل (تونس – ليبيا) |
|
(1) * (¾)(1) * (¾) |
رصد الذيل (تونس) |
|
(½) (1½) (½) |
مجنبة، رمل، زيدان (الجزائر) زيدان، حجاز كبير، حجاز مشرقي، رمل الذيل (المغرب) |
|
(1) (1½)(1) |
رصد (المغرب – تونس) |
|
(1) (½)(½)(½) |
الرصيد الشعبي |
* = نسبة تقريبية
لقد تحددت واستقرت طرائق المقامات والطبوع مع المُحدَثين (الثاني عشر هـ / الثامن عشر م)، حيث كان للمرحلة العثمانية تأثيرًا واضحًا في انتشار المصطلحات الخاصة بالمقامات والإيقاعات وتوضيح طرائقها وإثراء أساليبها؛ قبل أن تعود لتنحسر وتتراجع تحت وطأة تأثير النظام الموسيقى التونالي الغربي بدعوى التطور ومواكبة العصر!
الخصوصيات المقامية ومبدأ التأثير Ethos:
وبالرغم من عدم وجود وثائق "حية"، فإن المعلومات المتوفرة لدينا تثبت وجود طريقة صوتية مكتملة العناصر، تقوم على عنصرين أساسيين هما: نغمة الأساس ونوعية المجرى (الثلاثية).. وهذا الإطار اللحني لا يقوم على تقسيم جمع الذي بالكل (الديوان) باعتباره وحدة منفصلة، إنما على مبدأ الخلايا (عقود/أجناس رباعية أو خماسية): خلية أساسية، تضاف إليها واحدة فأكثر - متجانسة أو متباينة- في القرار أو الجواب، وذلك عن طريق الاتصال، الانفصال أو التداخل.
كما اعتنى المنظرون، بمعالجة تأثير الموسيقى في نفوس الكائنات الحية، وكذلك في الجسم، وخاضوا في موضوع الموسيقى من ناحية علاقاتها بالفلك والأجرام السماوية. ويبيِّن الكندي وإخوان الصفا من بعده: كيف ركبت على العود أربعة أوتار بعشر طاقات (4+3+2+1)، ثم صبغت بألوان النقوش السحابية التي تُرى قبالة الشمس، والتي تُرينا ألوان العناصر الأربعة: "فالزير يشبه بالصفراء، والمثنى بالحمرة والدم، والمثلث بياض البلغم، والبم بسواد السوداء".
يتم الانطلاق من أوتار العود والنغم المستخرجة من دساتينه، لشرح العلل النجومية التي وضع عليها العود، ومشاكلة أوتاره الأربع للأرباع الفلك، وأرباع البروج، وأرباع القمر، وأركان العناصر، ومهب الرياح، وفصول السنة، وأرباع الشهر، وأرباع اليوم، وأركان البدن، وأرباع الأسنان، وقوى النفس المنبعثة في الرأس، وقواها الكائنة في البدن، وأفعالها الظاهرة في الحيوان... وغير ذلك من التفاصيل، نلخص بعضها في الجدول التالي[39]:
جدول: النظرية الفلكية للموسيقى
|
الأوتار |
اللون |
الأركان |
التناسب / الصفة |
الطبائع / الأخلاط |
المفعول |
المضادة |
|
الزير |
أصفر |
النار |
حرارة النار وحدتها |
تقوي خلط الصفراء |
تزيد في قوتها وتأثيرها |
تضاد خلط البلغم وتلطفه |
|
المثنى |
أحمر |
الهواء |
رطوبة الهواء ولينه |
تقوي خلط الدم |
تزيد في قوتها وتأثيرها |
تضاد خلط السوداء وترققه وتلينه |
|
* وتر زرياب |
*أحمر داكن |
* الحياة |
--------- |
* الروح |
---------- |
------------ |
|
المثلث |
أبيض |
الماء |
رطوبة الماء وبرودته |
تقوي خلط البلغم |
تزيد في قوته وتأثيره |
تضاد خلط الصفراء |
|
البم |
أسود |
التراب |
ثقل الأرض وغلظها |
تقوي خلط السوداء |
تزيد في قوتها وتأثيرها |
تضاد خلط الدم وتسكن فورانه |
هذا الاتجاه التجريدي/الميتافيزيقي الذي يربط مبدأ التأثير الموسيقي بالظواهر الطبيعة، كان من مميزات المدرسة التأسيسية/العودية، اهتم به روادها انطلاقًا من الكندي ثم زرياب وإخوان الصفا. ومع القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، تقلص الاهتمام به، واختار كل من الفارابي وابن سينا من بعده، عدم المبالغة فيه معتمدين في المقابل، توجهًا طبيعيًا رياضيًا وتجريبيًا في نفس الوقت، يعتمد أساسًا، على فيزيائية الصوت الموسيقي وتحديد النسب الرابطة بين مختلف الأصوات. غير أن هذا، لم يمنع تواصل الاهتمام بالمنحى التجريدي في المراحل اللاحقة[40]. يقول الفارابي:
والألحان بالجملة صنفان: صنف ألف ليلحق الحواس منه اللذة فقط، من غير أن يوقع في النفس شيئًا آخر، ومنها ما ألف ليفيد النفس مع اللذة شيئًا آخر من تخيلات أو انفعالات، ويكون بها محاكيات أمور أخر، والصنف الأول أقل غناء، والثاني هو النافع منها، وهو الألحان الكاملة، وهي أيضًا التابعة للأقاويل الموزونة، أعني الشعر [...] والألحان الكاملة ثلاثة أصناف: منها الألحان المقوية، ومنها الملينة ومنها الألحان المعدلة، وقد تسمى الاستقرارية أو الحافظة...[41]
وقد تواصل هذا التوجه مع المتأخرين، حيث كانت تنزل هيئات الأصول والفروع على البروج الاثنى عشر (وإن اختلفوا في هيئات الشعب والأوازات)، وذلك في إطار ما يعرف بـ "الشجرة" الحاوية لمجمل المقامات (الأًول والفروع). من ذلك[42]:
"شجرة المقامات": أربعة أصول (راست – عراق – زيرافكند – أصفهان)، تستخرج منها 8 فروع (اثنان من كل أصل) وهي التي كانت تعرف بالأدوار؛ ثم 24 شعب (اثنان في كل دور)، و6 أوازات من بين كل اثنين من الأدوار، أي ما مجمله 42.
المقامات الاثنى عشر والأصول وما يقابلها من الأمزجة والعناصر والبروج
|
المقامات |
الأمزجة الغالبة في الإنسان |
العناصر الطبيعية |
الأخلاط |
البروج الفلك (12) |
|
الراست (الزنكلاه – العشاق)
|
حار يابس |
النار | الصفراء |
الحمل الأسد القوس |
|
العراق (الحجاز – أبوسليك)
|
حار رطب |
الهواء | الدم |
الجوزاء الميزان الدلو |
|
الزيرفكند (الرهاوي – البزرك)
|
بارد رطب |
الماء | البلغم |
السرطان العقرب الحوت |
|
الأصفهان )الحسيني – النوى)
|
بارد يابس |
التراب | السوداء |
الثور السنبلة الجدي |
"شجرة الطبوع": وكذلك الأمر بالنسبة لموسيقى المغرب العربي، حيث اتخذت مجموعة الطبوع المذكورة ضمن قصيدة الونشريسي، كقائمة أولية، أساسًا لما صار يعرف بـ "شجرة الطبوع"، اعتمدها فيما بعد وتناولها بالتعديل والتنقيح والإضافة، أهم منظري الموسيقى بالمغرب العربي، ومن بينهم: البوعصامي والوجدي/الغماد، وأحضري، والحائك، وسيالة، وبن عبد ربه وغيرهم... (راجع قائمة المصادر). وإذا ما تجاوزنا اختلاف الروايات، يمكن حوصلة هذه الشجرة في أربعة أصول (ذيل - ماية - زيدان – مزموم)، تستخرج منها 21 فرع (مع أصل: الغريبة المحررة، وهو دون فرع). ولهذه الأصول الأربعة وما تفرع عنها من الطبوع "تعلُّق بالطبائع الأربعة والعناصر الأربعة"، وذلك على النحو التالي:
|
طبوع فرعية |
مطلقات أوتار العود |
طبع أساسي |
العناصر الكونية |
الطبائع البشرية |
|
رصد الذيل ـ رمل الذيل عراق [العرب / العجم- مجنب الذيل – استهلال الذيل]. |
ذيل |
ذيل |
التراب |
السوداء |
|
غريبة الحسين [حمدان – مشرقي] |
حسين |
مزموم |
النار |
الصفراء |
|
رصد – حسين – رمل [الماية – انقلاب الرمل – صيكة] |
ماية |
ماية |
الهواء |
الدم |
|
أصبهان – عشاق– حصار - زوركند – حجاز[الكبير / المشرقي ] |
رمل |
زيدان |
الماء |
البلغم |
|
................. |
|
غريبة المحرّرة |
|
|
لكن المحدثين في كل من المشرق والمغرب، حسموا المسألة - على الوجه الذي استقر عليه الأمر إلى الآن - وذلك بتعريف المقامات والطبوع بالقياس إلى فصائلها في جماعاتها المختلفة النغم، دون الاهتمام بالعلاقة بين الأنغام وبين عناصر البروج والطبائع.
*** *** ***
المقامية العربية 2
الأصول والتطورات
ثوابت المقامية من خلال الغناء بطريقة النوبة
تعود الملامح الأولى للغناء بطريقة النوبة في الرصيد الكلاسيكي، إلى القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي، اتضحت ملامحه مع العصر الذهبي خلال الطور العباسي الأول، قبل أن يعم استعماله مختلف مراكز البلاد العربية الإسلامية بالمشرق والمغرب والأندلس. والنوبة الغنائية[1] تعد أهمَّ القوالب وأكملها منذ المدرسة العربية القديمة، وقد كان لها بالغ الأثر في تطوُّر الشعر والموسيقى إذ أنَّها تفسح المجال لتعدد الضروب والأساليب في الحصَّة الواحدة حيث يكون للتصرُّف والترديدات والإبداع الفوري مكانة أساسية، وهي كلُّها عناصر إثراء وتجديد في مجالي التلحين والأداء الآلي والصوتي كما أنَّ مسايرة تنوُّع الإيقاعات الموسيقية واستنباط ما يناسبها في النظم الشعري أدخل تنوُّعًا متواصلاً على الأنماط الغنائيَّة نظمًا وتلحينًا حيث صار الشعر ينظَّم من أجل الغناء، أي أصبح الإيقاع الموسيقي هو الاعتماد والأساس، هذا مما ساعد على تحطيم قيود النظم التي منها أبحر العروض المحدودة والقافية الموحَّدة، وذلك إثر محاولات اهتمت بتنويع نظم الشعر والتفنُّن في القافية والوزن، بلغت ذروتها مع استنباط الموشَّح والزجل في الأندلس، والتي يقول عنها ابن سناء الملك (1155-1211):
لخروجها عن الحصر وانفلاتها من الكفِّ، وما لها عروض إلا التلحين، ولا الضرب إلا الضرب، ولا أوتاد إلا الملاوي، ولا أسباب إلا الأوتار [...] فهي كلام منظوم على وزن مخصوص لا يمكن ضبطها إلا بالتلحين فيلجأ فيها إلى إدخال ألفاظ الترنُّم لإكمال تطابق الإيقاع الشعري على الإيقاع الغنائي[2].
كما تجدر الإشارة إلى أنِّ قالب النوبة يحتوي على مختلف العناصر الفنيَّة والتقنية للرصيد الكلاسيكي، وقد ساعد إلى حدٍّ كبير - بالرغم من الخصوصيات المحليَّة التي أثَّرت في تنوُّع تراكيبه وتغيُّر تسميته - على المحافظة على طابع هذا الرصيد ومضمونه العام، وعلى ضمان استمراريته لدى مختلف المجتمعات العربية الإسلامية.
ثوابت قالب النوبة
|
الأداء |
الشعر |
الإيقاع الشعري |
الإيقاع الموسيقي |
اللحن |
القطع |
|
يتسم بكثرة الارتجالات والترديدات والتصرفات اللحنية والإيقاعية |
عربي قديم- أعجمي (بالمشرق) عربي قديم مع *موشحات وأزجال أشعار المولدين (بالأندلس والمغرب)
|
تعدّد البحور والأوزان الشعرية مع تنوع القافية |
تنوع الإيقاع والحركة من الحر المنساب ثم الثقيل الموسع إلى الخفيف المتوسط السرعة.. فالسريع المرقص |
وحدة المقام/الطبع، مع إمكانية الانتقال بين مقامات/طبوع متقاربة والرجوع إلى الأصل |
عدد من القطع الآلية والغنائية تؤدّى حسب تسلسل معين |
مع الحفاظ على الثوابت المشار إليها كقالب مركب من مجموعة أنماط غنائية وآلية تؤدى حسب نسق معين، شهد الغناء بطريقة النوبة تعديلات وإضافات متعاقبة، نوجزها في الجداول التالية.
1- تطور النوبة بالمشرق
|
بغداد |
التطورات بالمشرق الإسلامي |
ملاحظات |
||
|
VIII-X |
XI |
XIII |
XIV |
وحدة المقام- تنوع في الشعر والإيقاع والحركة من الحر المنساب، ثم البطء إلى الخفيف السريع |
|
نشيد |
قول |
قول |
قول |
إنشاد حر فيه عمل |
|
بسيط[3] |
غزل |
غزل |
غزل |
غناء متقن – إيقاع موسع ، من بحر القول[4] |
|
|
ترانا |
ترانا |
ترانا |
دوبيت أو رباعي متوسط الحركة، من بحر القول |
|
|
|
فروداشت |
فروداشت |
سريع الحركة، من بحر القول |
|
|
|
|
مستزاد |
من إضافات ابن غيبي، يؤدى قبل الفروداشت |
من الواضح، أنه طرأ على النوبة الغنائية المشرقية تغييرات جذرية، حيث صارت طريقتها محدثة متأثرة بطريقة "الفرس أهل العراق الأعلى"، تتضمن أربعة حركات، تؤدى على النحو التالي:
- القول: وهو إنشاد بالعربي فيه عمل.
- الغزل: وهو شعر بالعجمي من بحر القول، على إيقاع ثقيل.
- الترانا: وهو دوبيتي بالعربي من بحر القول، على إيقاع متوسط السرعة.
- الفروداشت: مقطع وبيت واحد بالعربي من بحر القول، على إيقاع سريع.
وقد أضاف ابن غيبي، قطعة خامسة من اختراعه سماها المستزاد، تؤدى بين الترانا والفروداشت. وهذه الحركات أو الأقسام الخمسة لنوبة الغناء، منها الآلية والغنائية مع بيان قافيتها ونوعية إيقاعها وحتى افتتاحيتها الآلية المسماة "البيشرو" ("الطريقة" سابقًا)[5].
2- تطور النوبة بالمغرب والأندلس[6]
|
بغداد |
التطورات بالغرب الإسلامي |
ملاحظات |
||
|
VIII-X |
زرياب XI |
ابن باجة XII |
|
وحدة المقام- تنوع في الشعر والإيقاع والحركة أشعار عربية قديمة ، وفيها للمخضرمين المولدين |
|
نشيد |
نشيد |
استهلالó نشيد |
|
إنشاد حر |
|
بسيط |
بسيط |
عمل ó استهلال |
|
غناء متقن – إيقاع موسع |
|
|
محركات / أهزاج |
محركات / مرقصات |
|
غناء خفيف – إيقاع مرقص |
|
|
|
موشحات / أزجال |
|
شعر محدث يعتمد الإيقاع الموسيقي، يرقص عليه |
واضح أن النوبة كأثر فني، تشكل نموذجًا موسيقيًا متكاملاً امتزجت في إطاره ألوان متنوعة وثرية بتنوع وثراء روافد التراث الموسيقي العربي الإسلامي وتأكيد خصائص أدائه، من ذلك فن الارتجال. في هذا الصدد يذكر لنا التيفاشي (الباب العاشر) نموذجين يدلان بوضوح على مدى القيمة الفنية التي وصل إليها الأداء في ذلك العصر، حيث يقول:
لقد حضرنا بإفريقية مغن أندلسي فغنى من شعر أبي تمام الذي أوله: ]ومنفرد بالحسن خلو من الهوى]، فعددت له في هذا البيت أربعة وسبعين هزة؛ وحضرت جارية مغنية في مجلس عظيم من عظماء المغرب، تغني في هذا الشعر لابن أبي ربيعة: ]تشكَّى الكميت الجري لمَّا جهدته]، فمر عليها في غناء هذا البيت وحده مقدار ساعتين من الزمان.
ودون أن ندخل هنا في التفاصيل التحليلية، نلاحظ أن هذا الوصف يؤكِّد على جودة الغناء وعلى المستوى الذي ارتقت إليه التقنية الصوتية وفن الارتجال والتصرف وهي أمور تعتبر من ركائز الموسيقى العربية، بل والمقامية الشرقية عمومًا.
3- النوبة وطرق أدائها في الأندلس وإفريقية والمغرب
|
النوبة في الأندلس وإفريقيا حسب التيفاشي |
ملاحظات |
|
|
الأندلس إفريقية (المغرب) |
وحدة المقام- تنوع في الشعر والإيقاع والحركة |
|
|
نشيد (استهلال وعمل) |
نشيدó استهلال |
إيقاع حر |
|
صوت (عمل كله دون استهلال) |
عمل |
إيقاع موسع |
|
موشح |
محرك |
إيقاع خفيف |
|
زجل |
موشحة + زجل |
|
|
الأداء طريقة أهل الأندلس في الغناء، الطريق القديم وأشعارهم التي يغنون فيها أشعار العرب القديمة المذكورة في كتاب الأغاني الكبير للاصفهاني بنفسها |
الأداء أهل إفريقية فإن طريقتهم في الغناء مولدة بين طريقة أهل المغرب والمشرق فهي أخف من طريقة أهل الأندلس وأكثر نغما من طريق أهل المشرق، وكذلك أيضا أشعارهم التي يتغنون فيها هي أشعار المولدين |
|
|
التلحين أما طرائق التلحين، فإن طريقة الندلسيين فيها أثقل وأكثر نغما |
|
|
رغم تصدع الحضارة العربية الإسلامية وانقسامها، استمر قالب النوبة التقليدية من خلال التطورات المتعاقبة التي عرفها في كل من المشرق والمغرب، محافظًا على إطاره العام، مستفيدًا من كل المبادرات والإضافات التي أدخلت عليه، خاصة بداية من القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي. وهو لا يزال ماثلاً في قوالب المدارس التالية[7]:
المقام العراقي – الصوت الخليجي – القومة الصنعانية – الوصلة الشامية المصرية.. وكذلك، الفاصل التركي – الشاش مقوم الأوزبيكي والطاجيكي – الداستقاه الإيراني والأفغاني – المُقام الأذربيجاني - الأونيكي مُقام الإيغوري – الراقا الهندي...
|
العربية |
العربية الإفريقية |
التركية |
الإيرانية |
الهندية |
|
. “المقام” العراقي . “الصوت” الخليجي . “القومة” الصنعائية . “الوصلة” الشامية المصرية . “النوبة” المغاربية |
. أزوان بني حسان بموريتانيا |
. “الفاصل” التركي . “الشاش مَقوم” الاوزبيكي والطاجيكي |
. “الداستقاه” الايراني والافغاني . “المُقام” الاذربايجاني . “الاونيكي مُقام” الايغوري ( تركستان كازاخستان/ منطقة سين كيان الصينية) |
. “الراقا” (الهند الشمالي – باكستان - أفغانستان)
|
في إطار هذه القوالب الكبرى المنحدرة من النوبة التقليدية توجد أهم الأنماط الغنائية والآلية للرصيد الكلاسيكي ومن خلالها مختلف العناصر المكونة للمقاميات المحلية وطرق الأداء الآلي والصوتي وتشكيلات الآلات التقليدية. فهي قوالب محكمة في بنيتها وطرق أدائها، تتطلب من المغنين والعازفين مهارة فائقة وحذقًا للصنعة ودراية عميقة بأسرار اللغة الموسيقية التقليدية.. هذا مع اكتساب الخبرة والذوق الرفيع والإحساس المرهف. لذلك اعتبر الخوض فيها مقياسًا للمستوى والتميُّز في هذا المجال.
***
استمرارية مرجعية آلة العود[8]
رغم فترات الركود التي اعترضت مسيرته، استمر العود يتبوأ الصدارة بين الآلات والفرق الموسيقية وهو داخل إطار التواصل المذكور، يتخذ في التراث الموسيقي العربي أصنافًا تقليدية متنوعة، أبرزها:
أ. العود المشرقي، المصطلح عليه بـ "المصري" أو "الشامي": وهو خماسي أو سداسي الأوتار. فهو الأكثر رواجًا على الساحة الفنية العربية، بقي محافظًا – باستثناء بعض التغيرات الطفيفة لا تمس الجوهر، مثل غياب الدساتين - على أغلبية الثوابت التي رأيناها مع الرواد الأوائل: خمسة أوتار مزدوجة، تسويتها تتبع طريقة تتالي الرابعات (ثنائية بين الأول والثاني)، وهي على التوالي من القرار إلى الجواب: يكاه (يمكن تغييره حسب المقام) - عشيران - دوكاه - نوى - كردان (مع إمكانية إضافة وتر سادس).
ب. العود المغاربي، تختلف تسميته حسب المناطق: العود "العربي" أو "الرمال" أو "الصويري"، وكذلك "الكويترة": رباعي الأوتار تعتمد تسويتها على تداخل الخامسات، وليس على تتالي الرابعات المتعارف عليه في العود المشـرقي. تتخذ الأوتار تسمية تتماشى مع المصطلحات المألوفة في التراث الموسيقي المغاربي، وهي من القرار إلى الجواب: [الذيل - الماية - الرمل - الحسين/عوض الاصطلاح القديم: بم - مثلث - مثنى – زير/أو الحالي: عشيران - دوكاه - نوا – كردان]. وهي مستمدة من أسماء الطبوع (مقامات) الأساسية في شجرة طبوع التراث الموسيقي المغاربي.
وهذا جدول مقارن للتسويتين المشرقية والمغاربية
وفيما يلي جدول يلخص النقاط المذكورة:
|
الأوتار (1) (من القرار إلى الجواب) |
الرمز [ذمْرحْ] |
الأوتار (2) (حسب تسلسلها على الآلة) |
الرمز [ذحْمرْ] |
مطلق |
سبابة (شاهد) |
بنصر (ضامن) |
|
الذيل |
الذال |
لذيل |
الذال |
أ (دو) |
|
|
|
الماية |
الميم |
حسين |
الحاء |
ب (ري) |
ج (مي) |
د (فا) |
|
الرمل |
الراء |
الماية |
الميم |
هـ (صول) |
|
|
|
حسين |
الحاء |
الرمل |
الراء |
و (لا) |
ز (سي) |
ح (دو) |
*استعمالنا للنوتة الغربية نسبي، فالمهم – كما هو الحال في النظام المقامي – مراعاة النسب الكائنة بين النغمات. وهو ما يمكن ترجمته بالرسمين التاليين:
الجدول يعطينا التسوية التالية
ج. العود التقليدي بالجزيرة العربية (القنبوس): تداوله اليوم يكاد ينحصر على اليمن حيث يصنع محليًا ويسمى "طرب" أو "طربي" (تصغير لـكلمة طرب)، انتشر من عدن، باسم "القنبوس"، إلى مدغشقر وجزر القمر، واندنوسيا. فهو رباعي الأوتار تكون من القرار إلى الجواب، على الترتيب التالي: [الجر أو اليتيم (راست/دو1) - الرخيم (دوكاه/ري) - الأوسط (نوى/صول) - الحازق (كردان/دو)]، أي رباعية تامة - رباعية تامة - ثنائية كبيرة (كما هو الحال لآلة العود والموسيقى العربية عمومًا، تبقى ترجمة الدرجات بالنوتة الغربية الحديثة، تقريبية، إذ إن المهم هو احترام النسب الكائنة بين النغم، انطلاقًا من الطبقة الصوتية المعتمدة).
هكذا تتلخص تسوية القنبوس كالآتي:
|
ترتيب الأوتار |
تسمية الوتر |
المقابل في العود الشرقي |
مطلق |
بالسبابة |
بالبنصر |
بالخنصر |
|
1 |
الجر/ اليتيم |
راست |
دو1 |
|
|
|
|
2 |
الرخيم |
دوكاه |
ري1 |
مي ¼ |
فا1 |
|
|
3 |
الأوسط |
نوى |
صول2 |
لا2 |
سي2 (خاصة) |
|
|
4 |
الحازق |
كردان |
دو2 |
ري2 |
مي2 (خاصة) |
فا2 |
د. العود العراقي: جاء نتيجة التثاقف الإيجابي الذي حصل بين المدرستين العربية والتركية والدور الذي لعبته في هذا المضمار مدرسة بغداد للعود. فهو مع اقترابه بالعود المشرقي، يتبع تسوية مرتفعة بحوالي الخامسة، مع إمكانية وضع بعد الوتر الحاد، وترًا سادسًا يكون على حوالي الديوانين والسادسة في القرار. وهذه التسوية تأتي كما يلي: [دوكاه - بوسلك – حسيني – سهم – عجم].
تسويات آلة العود
***
التوجهات الحديثة:
المقامية العربية في ظل العولمة:
مع المحدثين حُسمت المسألة المقامية - على الوجه الذي استقر عليه الأمر إلى الآن - وذلك بتعريف المقامات والطبوع بالقياس إلى فصائلها في جماعاتها المختلفة النغم، دون الاهتمام بالعلاقة بين الأنغام وبين عناصر البروج والطبائع.
مع وفرة التنوُّع الذي وصلت إليه المقامات والطبوع (مائة والأربعة عشر حسب إحصائيات مؤتمر القاهرة 1932)، بقي تطبيقها يصارع محاولات التثبيت المتتالية التي ما فتئ يشاهدها السلم الموسيقي العام. ظل هذا الأخير، طوال المرحلة العثمانية، يعتمد أساسًا على معطيات ونتائج المدرسة المنهجية، أي ضبط السلَّم الموسيقي بتوالي: بقيَّة – بقيَّة – ومضة (ليما- ليما- كوما) مع احتساب الإضافات الزلزلية والفارسية التركية.. باستثناء المغرب العربي - خاصة الجزائر والمغرب - حيث تواصل العمل بالنظام الدياتوني-اللوني؛ واعتماد البعض منذ عبد القادر المراغي (تـ 1435) وخضر بن عبد الله موسيقار الخليفة العثماني مراد الثاني (1421- 1451)، في قسمة السلَّم على أساس المجنّب (بعد طنيني = 9 كومات، ومجنّب كبير = 8 كومات ومجنّب صغير = 5 كومات)، وقد تطوَّر السلم التركي في تلك الحدود حتى رتبه أخيرًا رؤوف يكتا (1878- 1935) وقسَّمه إلى 24 جزء غير متساوية تقوم على المجنّب والبقية والومضة؛ وهي لعمري طريقة أكثر صوابًا من الرأي القائم على تقسيم السلَّم إلى 24 جزء متساوية أي على غرار السلم المعتدل الغربي، والذي وُجد له تحت وطأة الغزو الثقافي الأوروبي منذ القرن التاسع عشر، أنصار لدى العرب والأتراك والإيرانيين وغيرهم ممَّن راهنوا على "محاكاة موسيقى الغرب".. الأمر الذي أدخل تشويهًا فادحًا على المقامية العربية والشرقية عامة... وقد أشار لهذا التوجُّه عربيًا ميخائيل مشاقة ( تـ 1888)، قبل أن ينقلب من مجرَّد افتراض ينكره الواقع الموسيقي، إلى قاعدة مسلَّم بها لدراسة، بل لنسف هذا الواقع، مما أجهض معظم البحوث والدراسات في هذا المجال حتَّى الجادة منها.
وأمام المحاولات والتجارب العديدة والمتضاربة التي شاهدتها عملية ضبط السلَّم الموسيقي العربي في إطار المدرسة العربية الحديثة، منذ القرن التاسع عشر وحتى الآن.. نلاحظ أنها في مجملها مستقرة على مبدأ تجزئة الديوان إلى أربعة وعشرين ربعًا، وذلك حسب الأهواء والتوجهات دون الوصول إلى أي اتفاق يذكر، فهي:
عند البعض، متساوية أي بحساب الأرباع المعتدلة (أسوة بالأنصاف المتساوية للنظام التونالي المعدَّل الذي فرضه بأوروبا تطوُّر الآلات الثابتة والكتابة التوافقيَّة). وهذا التوجُّه استعرضه مشاقة وواصله أغلب الموسيقيين المنظِّرين خاصة في مصر[9]. هكذا فإنَّ السلَّم الموسيقي حسب هذا التوجُّه، يتكوَّن من ستَّة أبعاد كاملة (= بردات ج. بردة) تقسَّم إلى أنصاف (عربات ج. عربة) وأرباع (نيمات ج. نيم/للربع الأدنى من نصف الدرجة) وثلاثة أرباع الدرجة (تيكات ج. تيك/للربع الأعلى من نصف الدرجة) وذلك بتساوي القيمة النغمية أي أربعة وعشرين ربعًا متساويًا تُرصد عن طريق الجذر الرابع والعشرين، وليس البقية والومضة/الليما والكوما [مثلاً من الراست إلى الكردان = 4/4- ¾- ¾ - 4/4- 4/4- ¾ - ¾ أي 6 درجات كاملة] غير أنَّه لا بدَّ من التنويه هنا ببعض الأفكار النيِّرة - وإن بقيت محدودة[10]- انطلاقًا من واقع الصناعة الموسيقية؛ ووجوب "البحث أوَّلاً عن السلَّم الطبيعي أو السلالم الطبيعية لمقاماتنا، أي دراسة السلَّم الشامل لجميع درجاتها"، ثمَّ التوجُّه بعد ذلك إلى التعديل "إذا ما وجدنا حينئذ ما يستوجب التعديل"؛ وبالتالي فإنَّ دراسة السلم "هي في الواقع دراسة للمقامات دراسة علمية معملية" أي "قياس ترددات مكونات المقامات المتداولة في جميع البلاد العربية بحثًا عن المفردات النغمية التي تكوِّن السلَّم الموسيقي العربي المتداول" وذلك "دون استثناء أو اختيار أو تفضيل، أو تصنيف للمقامات إلى أساسية وفرعية" عند البعض الآخر، فهي غير متساوية أي بحساب الكومات والليمات المستوحى من دائرة الخامسات الطبيعية والمتوارث عن النظام القديم (العربي – الفيثاغوري). وباستثناء البعض مثل الشيخ علي الدرويش الحلبي: 1884-1952، الذي كان يقول بنظام تركي مشابه يقوم على المجنّب، فإنَّ غالبية الموسيقيين الباحثين بالشام اتبعوا هذا المنحى، نذكر من بينهم:
توفيق الصبَّاغ (1892-1964) الذي لم يكن "يبحث عن معادلة رياضية مجرَّدة، بقدر ما كان يحاول تقدير تردُّدات الدرجات الصوتية للمقامات"، فالسلَّم عنده يتكوَّن من 53 كوما/تسع الدرجة، أي أقلُّ قليلاً من 24 ربعًا أو 6 درجات إلا كوما (543/48) ويشتمل على 19 درجة أبعادها غير متساوية، تتركَّب منها مجمل النغمات الأصلية والفرعية، وهي على التوالي بحساب الكومات من الراست إلى الكردان: [0-5-4-4-1-2-2-4-4-1-4-4-1-4-4-3-1-1-4] أي ما مجموعه [53 كوما]، ومقام الراست عنده يأتي بهذا التسلسل: [1- - ⅔ - ¾1- 1- 1- ¾ - 2/4 ، أو بحساب الكومات: 9-7-6-9-9-7-6] وهو توجُّه يغلب عليه الحسُّ الموسيقي والذوق الشخصي، إلى جانب الخبرة والمهارة في التعامل مع المقامات... نفس المبدأ نجده عند مجدي العقيلي (1917-1983) الذي يرفض أيضًا السلم المعتدل ونظرية الأرباع المتساوية لأنَّها خاطئة ولا تُنصف الأذن الموسيقية العربية، فالسلَّم عنده يتألَّف من ثلاث وخمسين كوما حسب الترتيب: [ليما- ليما- كوما] على غرار السلَّم العربي القديم، وهو مثله يضمُّ سبع عشرة درجة حدَّدها بناءً على إحساسه وخبرته وممارسته للمقامات، وهي تتضمَّن: [البعد الطنيني والمجنّب الكبير والمجنّب الصغير والبقيّة والبقيّة الصغرى والفضلة (أو الومضة) أي بحساب الكومات: 9-8-5-4-3-1]... وكذلك الأمر في أعمال فؤاد محفوظ الذي يرى في سلَّم الأرباع "وهْم لا تقبله الألحان العربية، ولا تستسيغه" ويرى أنَّ الـ كوما والليما "تفعلان بموسيقانا فعل السحر، لذا نرى أنفسنا منساقين على سجيَّتنا في بحث قيمة كلٍّ منهما في موقعها ضمن السلَّم الموسيقي"... أمَّا ميخائيل الله ويردي (1904-1981) فبالرغم من تهجُّمه على السلَّم المعدَّل ودفاعه عن جمال السلَّم العربي "الطبيعي" الذي بذل جهدًا ضخمًا في سبيل دراسته وتثبيته، كان له تصوُّر مختلف، فهو يجزئ السلَّم إلى خمسة أبعاد طنينية (يساوي كلٌّ منها 8 كومات ونصف) وسبعة كومات ونصف، أي ما مجموعه [50 كوما]، والديون عنده يحتوي على [سبعة عشرة صوتًا] في حين أنَّ تحليل المقامات الواردة بالدراسة تفصح عن [47].. هذا إلى جانب الكثير من الخلط والتعقيد مع اصطناع التعديل الصريح في النسب، ومقابلة النسبة بالذرات /السنت أو بأرباع الكومات وكيفية متشعِّبة في معالجة المقامات وابتداع المصطلحات، وطريقة التدوين، علاوة على "فلسفته" الرامية إلى "هرمنة الموسيقى الطبيعيّة" (أي العربية).. وغير ذلك مما جلب لآرائه وحساباته حول السلم العربي، الكثير من الجدل والنقد.
الثوابت والمتغيرات
كما نلاحظ، ما فتئ المهتمُّون "بتنظيم الموسيقى العربية"، يبحثون عن "سلم شامل" لجميع مقتضياتها النغميَّة.. وفي نفس السياق، يسعون إلى تحديد مقاماتها وإيقاعاتها وتوحيد مصطلحاتها باعتماد المقارنة والمقايسة أو المفاضلة وصولاً إلى الاختيار وعند الاقتضاء، إلى الإهمال والإلغاء! كلُّ ذلك بدافع "النهوض بالموسيقى العربيَّة وتمكينها من مواكبة العصر"؟!... كثيرون هم الذين اهتمُّوا بهذه "المعضلة" ووضعوا لها حلاّ تدبَّروه – تبعًا لنزعاتهم وغاياتهم وكلٌّ يظنُّ أنَّ حلَّه هو الأنسب إن لم يكن هو الممكن الأوحد. ولنا أن نتساءل:
- هل أنَّ سلَّم الأصوات "مشكلة وليدة عقول علماء الموسيقى المنظِّرين؟
- هل أنَّ العقبات التي تصطدم بها هذه الدراسات هي نتيجة خلط في المفاهيم والرؤى وازدواجيَّة بين نظامين متباينين: المقامي والتونالي.. وبالتالي هي وليدة عقد التقليد والتبعيَّة؟
- ما هي الغاية المرجوَّة فعلاً من وراء تثبيت السلَّم وتنظيم المقامات؟
- ما هي حقيقة مسافة "ربع البعد"؟
- هل إنَّ تثبيت السلَّم ضروري لإيضاح المقامات أم أنَّ دراسة المقامات وتحليلها وإبراز مختلف النغمات والمسافات المكوِّنة لها، شرط أساسي لإقرار السلَّم؟
حفاظًا على خصوصية المقامية العربية وثراء تنوعها، لا بدَّ من التأكيد على ضرورة التحرُّر من العقد والمسلَّمات الواهية التي ما فتئت تحاك حول مسألة السلَّم الموسيقي والمناداة بتعديله وتثبيته كحتمية "تفرضها متطلبات التطوُّر" و"مواكبة العصر" وما يتبعها من حجج حول "تقنين التدوين الصحيح ومناهج التدريس وأساليب التأليف واستغلال الإمكانات التي تتيحها الآلات الثابتة ومجالات التوزيع والكتابة الديافونية والبوليفونية والهارمونية النابعة منها"... وفي نفس السياق "تحقيق وحدة الفكر العربي في قطاع الموسيقى" بوضع "سلَّم موسيقي موحَّد" يسمح بتجاوز "الخلافات في التسمية وفي طريقة العمل في المقامات والفروق الكائنة بينها"... الخ من التعليلات الواهية.
بعيدًا عن معضلة التقليد وما تسفر عنه من خلط مريب في المفاهيم والرؤى، فإنَّ الواقع الموسيقي ودراسات علم اللغة الموسيقية، تفيد بأنَّ السلَّم الموسيقي ما هو إلا تجسيد مجرَّد لمكوِّنات موسيقى الشعوب عزفًا وغناء، يحيكه الإنسان من مكوِّنات مخزون حضارته وأخلاقه وإحساسه، في تراكيب إيقاعية لحنية تعبِّر عن ذاته وصفاته، وهي التي يجب أن تكون منطلقًا للبحث عمليًّا ومنتهاه نظريًّا.. لذا لا يمكن الفصل بين السلَّم والمقامات التي لها الأولوية في الحصر والتصنيف والتبويب وقياس نسب درجاتها وأبعادها، على أن يشمل ذلك جلَّ المقامات المتداولة في كامل البلاد العربية دون استثناء أو تحيُّز، والعمل على تقدير قيمة تردُّداتها دون تكييف أو تطويع لتكريس نظرية رياضية مسبقة... لا شكَّ في أنَّ نجاح هذه المرحلة وما ستسفر عنه من نتائج فنَّية وعلمية، سوف يعزِّز وعينا وينير سبيلنا فيما يستوجب عمله للنهوض بموسيقانا على أحسن وجه...
علمًا وأنَّه إذا كان من بين طموحات هذه المرحلة العمليَّة المعمليَّة، الكشف عن مكوِّنات مختلف المقامات العربية وتقدير تردُّداتها تقديرًا صحيحًا ثمَّ ترتيبها في إطار سلَّم موسيقي عام وشامل، فإنَّه لا يجب بحال من الأحوال، النيل من بعدها الحيوي أو التفريط فيه إذ إنَّه يشكِّل العنصر الجوهري والأساسي في نظامنا المقامي.. إلاَّ إذا كنَّا نريد استبداله، وهذا أمر آخر!
تأكيدًا على أهمية هذه المسألة الشائكة، نرى من الضروري توضيح ما يلي:
منذ أواخر القرن التاسع عشر تاريخ انطلاق النهضة العربية الحديثة، شهد الفن الموسيقى من التحديث والتغيير ما عرفه الأدب والمسرح والفنون التشكيلية، وانفعل بنفس الموضوعات والتطلعات، فتنوعت المحاولات والاتجاهات وتعددت المواقف. فبالإضافة إلى القطيعة المؤسفة التي علقت بهذا الفن منذ قرون، بين العلم والعمل، جاء التصادم المفاجئ بالنموذج الغربي وتأثير التكنولوجيا الصناعية... تغيرات جذرية حصلت بكيفية سريعة ومتتالية على المشهد الموسيقي العربي، كان من نتائجها التخلي تدريجيًا عن الثوابت والتشبث بالمتغيرات الوافدة. وقد كان للتعليم الموسيقي حسب النموذج الغربي، الدور المركزي في تكريس هذا التوجه القائم على الخلط غير المدروس بين مكونات نظامين موسيقيين مختلفين تمام الاختلاف: المقامي العربي والتونالي الغربي. أن مميزات كل منهما تبرز واضحة جلية، من خلال الموسيقى ذاتها، وهيكلتها، وتراكيبها اللحنية والإيقاعية، والآلات الموسيقية والتقنيات الصوتية والوظيفة الاجتماعية. وبإيجاز شديد، يمكننا القول، أن الموسيقى الغربية الكلاسيكية تقوم على نظام تونالي سلمه معدل ثابت الدرجات، وعلى أساس مقاميْ الكبير والصغير (ماجور- مينور) والإيقاع المنتظم النبرات، مع اعتماد التدوين والكتابة التوافقية العمودية والتوزيع الأوركسترالي، الخ. بينما الموسيقى العربية تعتمد نظامًا مختلفًا، يمكن تلخيص عناصره كالآتي:
- الاعتماد أساسًا على التلقين الشفوي وهو عنصر حيوي، يكون فيه للإبداع والارتجال، والذاكرة، وسعة الخيال، دور رئيسي يتطلب التعامل معه الكثير من الوقت والمثابرة والصبر إذ إن الغناء والعزف والنظريات والتحليل وبالتالي الإبداع والتلحين، كلها عناصر تتماشى مع بعض ويُستمد بعضها من بعض. ولا غرابة في أن عظماء من تدارسوا الموسيقى من الأقدمين عندنا، أمثال الكندي والفارابي وإخوان الصفا وابن سينا وصفي الدين، وغيرهم، وبحثوا في أدق جزئياتها، قد تجنبوا عمدًا وضع ترقيم جاف يكون بمثابة تحنيط لفن روحي وحيوي كالموسيقى.
- الانتماء إلى الأسرة المقامية أي الاعتماد على مبدأ المقام أو الطبع الذي يعبِّر في نفس الوقت عن سلم موسيقي معيَّن، وعلى ما يتضمنه من خاصيات وما يثيره من تفاعلات سيكولوجية وفيزيولوجية. فكل مقام أو طبع يشكل ظاهرة مقامية تسبح في عالم "نغمي-إيقاعي" خاص، تخضع فيه بنياته الداخلية، الفضائية منها والزمنية، إلى مجموعة قوانين تفرضها التقاليد ويكيفها الذوق، وكل ما تفرزه اللهجات والأصوات المقترنة بعبقرية الفئات الاجتماعية.
- السلم المعتمد في النظام المقامي، مستمد من مبدأ تآلفي، يعود إلى أصل سامي قديم - رغم نسبته إلى فيثاغورس - وهو فيزيائيًا، سلم "طبيعي" مستخرج من تسلسل تآلف الخامسات، ويعتمد على النظام السباعي أو الخماسي أو بمزج الاثنين معًا. عمليًا يتبلور في شكل خلايا متتالية (اثنتان فأكثر، تكون واحدة منها الأساس): أجناس أو عقود ثلاثية، رباعية، أو خماسية، من النوع المقامي (الدياتوني)، أو المتقارب (اللوني)، أو الشرقي بثلاثيته أو ثنائيته الخاصة (4/3 أو ¼1 تقريبًا). وتكون إما متصلة وإما منفصلة ببعد طنيني أو متداخلة. وهذا السلم الطبيعي الذي يعتبره العلماء أفضل سلم لحني على الإطلاق، ليس له أي علاقة بالسلم الغربي المعتمد على المعادلة الرياضية وتجزئة الديوان إلى اثني عشرة نصفًا من البعد متساوية، أو إلى أربعة وعشرين ربعا متساوية كما يطالب بذلك بعض النظريين المعاصرين من العرب وغيرهم من الشرقيين. فكلاهما يعود إلى قياسات حسابية مصطنعة، الهدف من ورائها تثبيت الكتابة التوافقية/الهارمونية، وإقحام الآلات ذات المنازل الثابتة.
- دراجات السلم: تكون ثابتة في النظام التونالي، وتتسلسل من درجة الأساس إلى جوابها، وهي تكتسي في هذا الحيِّز، أهمية متباينة حسب دورها داخل المركبات المتآلفة وقواعد الكتابة التوافقية، من ذلك: الرابعة (تحت المسيطرة) والخامسة (المسيطرة/الثابتة)، والسابعة (الحساس)، والثامنة (الديوان). بينما درجات السلم في النظام المقامي، تختلف بين ثابتة ومتحركة بحكم الجاذبية الطبيعية حسب الأهمية، مع إمكانية تغيُّر بعضها عند النزول مقارنة بما هي عليه في الصعود. ويمكن تحديد الفروق الكائنة بين الدرجات، في النقاط التالية:
· درجة القرار: المحور الأساسي الذي يحوم حوله ويبنى على أساسه سير اللحن. وهي تبرز خاصة في القفلات النهائية أو شبه النهائية، وتعطي أحيانًا اسمها للمقام المرتكز عليها.
· المراكز أو الغمازات: تتغير حسب نوعية الخلايا المكونة للمقام.
· المبدأ أو المدخل: بالرغم من تنوعها، فهي ذات أهمية بالنسبة لانطلاق الحركة اللحنية.
· درجات يفصح تجنبها أو تأكيدها عن شخصية المقام أو الطبع، وهي باختلاف وظائفها تفرز بين مقامات وطبوع تتماثل من حيث السلم.
- روح المقام: ينفرد كل مقام بملامح معيَّنة تبرز من خلال تراكيبه اللحنية (وأحيانًا اللحنية–الإيقاعية)، تعرف بـ "روح المقام"، يستمد منها قدراته التعبيرية والتأثيرية. ولهذا الإحساس المقامي المميَّز، ثلاثة أبعاد:
· فنِّي: ثابت يتم من خلاله التعرف على المقام.
· تأثيري: يختلف وقعه حسب الإدراك الحسي والمزاج النفسي للمؤدي وكذلك للمتلقي.
· ماورائي : تقليديًا كان يُنسب لكل مقام أو طبع قدرة تأثيرية (إيتوس Ethos) خاصة، بنيت على أساسها نظرية ما كان يعرف بـ شجرة المقامات أو الطبوع الأصلية والفرعية... غير أن هذا العنصر رغم أهميته، لم يعد متداولاً اليوم.
- أسلوب الأداء: يعتمد الإضافة الشخصية (الزخارف والتلوينات والارتجالات المقامية والإيقاعية) كظاهرة حيوية وإبداعية هدفها تجاوز قيود الهوموفونية وإبراز الخط اللحني في صوره الجمالية الزاهية والمتنوعة، أي بطريقة التعدد النوعي (هيتروفونية)، تزداد حيوية وتكاملاً مع رهافة إحساس الموسيقيين وتمكنهم من تقنيات الأداء وقدرتهم على التصرف والتفنُّن... هذا ما يتعارض تمامًا مع الأسلوب العمودي التوافقي القائم على احترام السير اللحني في أدق تفاصيله، والذي يزداد انضباطًا مع إتباع المدونة الموسيقية والتضخيم العشوائي لعدد العازفين والمنشدين واعتماد قائد للفرقة. الحصيلة: التقيُّد بدقة الأداء وتوحيده، وبالتالي طغيان الرتابة، على حساب تلقائية المبادرة الشخصية وحيوية التجدد والتواصل والتكامل. وهذا يعني التخلي عن عناصر فنية وجمالية جوهرية، واستبدالها بأخرى مختلفة بل متضاربة تمامًا مع ما هو مطلوب.
- أما العنصر الإيقاعي فهو لا يقل أهمية، إذ إنه يبرز في الموسيقى المقامية بطرق وإمكانيات فائقة التنوع والثراء. كل ذلك في تسلسل دوري، قوامه النبرات المميزة، داخل إطار زمني يحدده عدد معين من الوحدات، منها الساكنة، ومنها المتحركة بمختلف مستويات القوة والضعف حسب ما تمليه التركيبة الإيقاعية. هذا ما تفصح عنه مختلف المصطلحات المستعملة، منها:
· أصول: أي أصل، أساس.
· إيقاع (ج. إيقاعات): أي أن النبرات الإيقاعية تلعب دورًا أساسيًا في تركيبه وتنويعه (يعبر عنها موسيقيا بـ: دم – دم مه – تكْ – تكَّ – تكّه – تاكاه...)، مع اعتبار ما يُعرف بالزمان الأول أو المعيار.
· وزن/ميزان (ج. أوزان/ميازين): أي أنه أداة تنظيم وقياس لأزمنة النغمات، فهو يقسمها إلى مجموعات متساوية تتكرر حسب نظام خاص، فيأتي اللحن موزونًا جميل الوقع.
· ضرب/دور- دائرة/طقم (ج. ضروب/دوائر/طقوم): جملة نقرات متحركة وساكنة، متنوعة النبر من حيث القوة والضعف، تضبط أزمنتها وتتوالى، حسب نظام مخصوص لكل إيقاع. أي تسلسل منتظم طوال القطعة الموسيقية لعدد من الإيقاعات لها نفس المدة الزمنية ونفس النبرات ونفس النقرات القوية والضعيفة والساكنة، تعود بانتظام.
· تعمير/حشو أو طرز: فن التلوين والتزويق في النقرات والنبرات الإيقاعية، بمعنى التنوع والإثراء وفيه حسب مقدرة الناقر، طرق شتى وفنيات عدة، تصل مع تعدد الناقرين إلى طريقة التعدد النوعي في الإيقاع (الهيتروريتمية).
· عنصر التعبير: المتمثل في سير الحركة وتنوعها، حيث يتنوع الإيقاع بين منساب (مفتوح) وموزون تتدرج حركة أدائه من البطيء (موسع/ثقيل)، إلى متوسط السرعة (قنطرة/خفيف) فالسريع (انصراف، ملفوف). وهو ما يجعل من المقطوعة في نفس الآن، وحدة مستقلة ومتآلفة مع بقية المقطوعات داخل الوصلة في تسلسل محكم من البداية إلى النهاية.
فلكل من كلمة إيقاع ووزن مفهومًا خاصًا ولو أنها كثيرًا ما تستعمل الواحدة مكان الأخرى. فالوزن يعني: تنظيم الحركة وتقسيم الأزمنة في الألحان تقسيمًا منظمًا، وإن اختلف هذا التقسيم في أجزاء الأزمنة. وقد تكون لقطعتين موسيقيتين وزن واحد ولكنهما من إيقاع مختلف، وقد تكون عدة مقاييس في قطعة موسيقية متساوية الميزان طبعًا ولكن إيقاع كل مقياس يختلف عن الآخر بسبب اختلاف تقسيم زمن النقرة إلى عدد من النغمات مغاير لما في الآخر... وقد يتغير الإيقاع كذلك بتغيير سرعة أداء القطعة الموسيقية بكاملها.
والجدير بالملاحظة، أنه إذا ما بحثنا في جمالية البناء اللحني-الإيقاعي للنظام المقامي العربي، نجده يحاكي الاتجاه الجمالي المميَّز لنماذج الفن الإسلامي عمومًا، كالتوريق النباتي، والتظفير الهندسي، ونماذج الرقش العربي مثلاً، فهو يميل مثلها إلى استعمال وسائل تقنية وأسلوبية واضحة ومتفتحة، تبتعد أساسًا عن الخداع والقولبة وافتعال العناصر الوهمية.
هذه الفوارق المشار إليها، بين النظامين الموسيقيين، تبرز بإلحاح في أساليب التعليم. فهي بالنسبة إلى "النظام التونالي" الأوربي تقوم على التقاليد المكتوبة التي تتطلب "التطبيق الحرفي لما كتب حسب التقريب" اعتمادًا على "ذاكرة ذات اتجاه واحد غير مدمجة ضمن نظام ثابت ودقيق"؛ في حين أننا نجدها في "النظام المقامي" العربي والشرقي عمومًا، تعتمد على تقاليد شفوية تقوم على "ذاكرة متعددة الاتجاهات ومدمجة تبعًا لعادات متأصِّلة ضمن نظام حيٍّ وذات صيغ متعددة ومبادئ وفنيات جرِّبت طويلاً"، فهي مزيج من المقدُرة المكتسبة والإبداع ومن الارتجال والتأليف. وهي بالتالي، نتيجة مباشرة من المعلِّم إلى المتعلِّم ويبذل هذا الأخير مجهودًا يتضاعف تدريجيًا لفهم وهضم العمل الفني في أكمل أشكاله. ويأنس بذلك لقواعد اللغة الموسيقية ويكتسب في الآن نفسه ذوقًا وإحساسًا وقدرة على الإبداع. ولا يمكن أن يتحقق ذلك، إلا بالاستماع إلى فنان حقيقي والسير على منواله، وليس بتلقي دروس جافة من معلم مدرسة (كما لا يمكن أن يصبح المرء شاعرًا بمجرد درسه لعلم العروض ومعرفته لبحور الشعر). وهنا تأتي التفرقة بين التعليم الذي يهدف إلى تكوين فنانين مبدعين داخل المعاهد المختصة، والتربية التي تسعى إلى التثقيف والتوعية الموسيقية ضمن التكوين العام. كما يكتسي التوجه المتبع في مجال التعليم والتربية والثقافة الموسيقية عمومًا، أهمية بالغة، إذ صار متأكدًا بحكم التجربة، بأن الطرق الخاصة بالنظام التونالي، التي لم تعد ملائمة حتى للموسيقى الكلاسيكية الغربية ذاتها، تلحق فادح الضرر بالتقاليد الموسيقية الأخرى خاصة تلك الخاضعة إلى النظام المقامي. هذا مما دفع عددًا من أهل الاختصاص في التربية الموسيقية بأوربا من أمثال: سلطان كوداي، وكارل أورف، وموريس مارتنو، وسوزوكي وغيرهم.. إلى البحث عن أساليب جديدة عرفت بالتعليم "النشيط"، والتي ما هي في واقع الأمر، سوى محاولات محتشمة إذا ما قارناها بالأساليب العائدة إلى طريقة التقليدية الشفوية المباشرة، المتبعة في الموسيقى المقامية. ولقد برهنت هذه الأساليب الحسيَّة المستحدثة على نجاحات باهرة في مجالات تعليم الآلات الموسيقية ومجالات التربية الموسيقية بصفة عامة من الناحيتين النظرية والعملية. فهي تركِّز على تنمية الذكاء الموسيقي والذاكرة والمهارة لدى الطفل منذ نعومة أظفاره؛ وقد استفادت في مجملها من مكتسبات الطريقة الشفوية التقليدية التي تنطلق أساسًا من التطبيق الملموس، والتي برزت إيجابيات استغلالها وتجلَّت بوضوح – كما أسلفنا - من خلال تجارب علم النفس التربوي الحديث. والغريب في الأمر، أن بعضنا ينادي باعتمادها كما هي وكأنَّها حدث جديد عن مجال التعليم في الموسيقى العربية، بينما هي في الواقع، تشكل أحد أهم مميِّزاتها.
غير أن المشكل يكمن في كون مشاغل هذا العصر الذي نعيشه، تحول دون تطبيقها، إذ إنها تتطلب تعايشًا يكاد يكون مستمرًا بين المعلم والمتعلم. لذلك بات من الضروري التوصل إلى حل وسط يجمع بين الطريقتين، مع مراعاة شروط أساسية لا بد من الحفاظ عليها في المراحل الأولى من التعليم على الأقل، من بينها:
· الانطلاق من عناصر اللغة الموسيقية المحلية؛ واعتماد سواها، عناصر إثراء لا بدائل.
· استعمال النظريات كنتيجة للتمارين العملية (الصوتية والآلية)، واستعمال الترقيم الموسيقي كمعين للذاكرة، لا كعنصر أساسي يُتبع حرفيًا.
· التخلص نهائيًا، من الاعتقاد بكون النوتة "لغة إنسانية" والتونالية الغربية "موسيقى عالمية"، فهو إدعاء باطل سوَّقه غزو ثقافي مهيمن بثقله على بقية ثقافات شعوب العالم.
· الاعتراف بكون العالمية هي الانتصار للمحلية وللتنوع الثقافي في مفهومه الشامل.
هذه المقارنة الموجزة، تجعلنا نؤكد مرة أخرى على وجوب إعادة النظر في مناهج الدراسة ومناقشة المفاهيم المعتمدة، والآراء السائدة إلى حد الآن لدى أغلب مؤسساتنا التعليمية... فلقد بات من الضروري إرجاع الاعتبار إلى موسيقانا اعتمادًا على نظرة علمية فنية ثاقبة، تربطها أساسًا بمتطلبات نظامها المميَّز وخصوصياته..
*** *** ***
التأثير الموسيقي عند العرب 1
مقاربة تاريخية - نظرية - فنية
مدخل:
ربط الموسيقى بمعتقدات روحانية وتنجيمية، توجه قديم موروث يركِّز على علاقة الأصوات بالطبائع البشرية والعناصر الكونية، وعلى مبدأ التأثير الموسيقي وقد اتبعه وتعمَّق في شرحه المنظرون العرب الأوائل، قبل أن يصير من ركائز المدرسة المغاربية-الأندلسية؛ حيث أعطيت أهميَّة كبيرة للقدرة التعبيريَّة والعلاجيَّة للموسيقى ولآثارها على النفس الإنسانيَّة.
موضوع عميق، متعدد المشارب، تتداخل فيه الموسيقى مع مجالات عدة [فلسفية – باطنية – صوفية – أخلاقية]، [طبيعية – رياضية - طبية – خيميائية/الكيمياء القديمة]، [كوسمولوجيَّة/نشكوية - تنجيمية – فلكية – العلاقة بالبروج، علم الكف...]. فالموسيقى - على رأي الفاربي - علم مستخرج من علم الهيئة، وعلم الحكمة، وعلم الطب، وعلم النجوم، وعلم الطبيعة، وأن له تعلقًا بجميع العلوم.
لذا، سوف أختصر مداخلتي على جوانب منها، مما له علاقة بالتأثير الموسيقي. والبداية بوضعها في سياق التفكير الإسلامي العام.
في سياق التفكير الإسلامي العام
أ. منحى عقائدي، أخلاقي، كوني (كوسمولوجي):
حسب التعاليم الصوفيَّة [راجع خصوصًا آثار ابن عربي، وأبي مدين، وجلال الدين الرومي]، خلق الله الكون في كماله وروعته ثمَّ شاءت إرادته الثابتة أن يملأ الأرض بساكنيها، وقبل أن يصوِّر الإنسان ويعدِّله، خلق كلَّ الأرواح التي قرَّر لها أن تسكن مع توالي الأحقاب والأزمنة المقدَّرة، أجساد الآدميين الفانية طيلة المدَّة التي سيستغرقها بقاء الكون. بعد ذلك أمر الخالق الكواكب السبعة وأجسامًا أخرى سماويَّة أن تتحرَّك، عندها سمعت الأرواح الألحان الرائعة الناتجة من حركاتها الموقَّعة. لذا، فإن الانسجام الموسيقي في أرقى وأكمل أشكاله، يتجسد في الأجواء السماوية وموسيقاها، وما الانسجام الأرضي، بما في ذلك انسجام الموسيقى التي هي من صنع الإنسان سوى انعكاس باهت للانسجام الكوني الرفيع.
ولأجل هذا السبب نرى الصوفية يؤسسون علاقة للموسيقى مع أصوات الأفلاك تارة وتسابيح الملائكة ونغمات الجنة وصور إسرافيل تارة أخرى. فعلى صفة الكلام الذي هو تجل من تجليات هذه الصفة ينبني المبدأ الميتافيزيقي/التجريدي للموسيقى عند الصوفية، والذي يؤسس غايته النهائية على وجوب تذكير الإنسان بالوجود المطلق مكتسبًا معناه في هذا السياق الذي بدوره يندرج في سياق أعم متفرع عن نظرة الصوفية إلى الوجود. فـ "السماع سر من أسرار الله تعالى، وهو ينقسم على ثلاثة أقسام: سماع إلهي وسماع روحاني وسماع طبيعي" (ابن عربي: الفتوحات 1، ص 367).
كما تفيد نفس التعاليم، بأن الله عزَّ وجل، عندما خلق آدم، أمر الروح بدخول جسده فأخذ نبضه في الخفقان، وكان لآدم أيضًا صوت حسن وبما أنَّ الأزمنة الفاصلة بين النبضات كانت متساوية فإنَّه كان إذن يتوفر في جسمه على الصوت والإيقاع [جنيد المتوفَّى عام 910] الذين هما أساس كلِّ موسيقى.
هذا الطابع التيوقراطي/التربُّبيُّ للمجتمع العربي والمعتقدات السائدة بينه حول نشأة الكون قد جعلت من الموسيقى سندًا للروح في بحثها عن الكمال المطلق أي الخالق. ذلك أن الموسيقى تستوقف نظرة الوجود عمومًا ونظرة الروح أو باصطلاح الفلاسفة نظرة النفس على وجه الخصوص... "ولما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وكونه وأظهر ذريته للدنيا ظهر ذلك السر المصون المكنون فيهم فإذا سمعوا نغمة طيبة وقولاً حسنًا طارت هممهم إلى الأصل الذي سمعوه من ذلك النداء". ولما كان الروح رغم جوهره الإلهي محبوسًا ومستغرقًا في البدن الإنساني ومحتاجًا إلى مذكر له بجوهره الإلهي وموجه له لمنبع هذا الجوهر... فتعين أن يكون بين الموسيقى وبين النغمات الفلكية ونغمات الجنة ارتباط وجودي لأن كل نغمة من هذه النغمات تجل من تجليات صفة الكلام ومُذكرة لهذه الصفة الفعلية.
[الموسيقى ما يسبق الكلام وما يتجاوزه عندما يعجز هذا الأخير عن التعبير] لذا، فإنه إذا كانت للأصوات الموزونة والنغمات تأثيرها في النفس؛ فذلك لأنها تذكرها بحياتها السابقة في عالم الذر قبل أن تتصل بالبدن بقولهم:
أن تأثير الموسيقى والنغمات الموزونة لحركات السموات في عالم الذر عالم ما قبل الولادة كنا قد اعتدنا عليه ومعنى ذلك أن أرواحنا كانت قبل أن تنفصل عن الله تستمع إلى الألحان السماوية وكنا مؤتنسين وكانت الموسيقى تثير فينا وجد الكون وتثير تلك الذكريات في خواطرنا. (تاريخ التصوف الإسلامي، ص 560).
ونذكر هنا بالفرق بين النفس والروح، فلكل إنسان نفسان: نفس العقل الذي به التمييز ونفس الروح الذي به الحياة، كقوله تعالى: "ونفخت فيه من روحي"، ولم يقل من نفسي. وقوله تعالى: "تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك" ولم يقل روحي. فالله عز وجل، خلق آدم وجعل فيه نفسًا وروحًا (فمن الروح عفافه وفهمه وحلمه وسخاؤه ووفاؤه؛ ومن النفس شهوته وطيشه وسفهه وغضبه، والله تعالى أعلى وأعلم).
وهذا الاعتقاد الذي استغلَّته المدرسة الصوفيَّة الإسلامية استغلالاً واسعًا، يرفُض أن ينسب للموسيقى دور استهداف تشنيف الآذان فقط أو تسلية الروح وإمتاعها. فالموسيقى عندهم، علم يرمي قبل كلِّ شيء إلى السموِّ بالأرواح إلى عالم القدسيَّة، وهي واسطة بين الإنسان والعالم العلوي، فقوَّتها السحريَّة والعاطفيَّة والعلاجيَّة عظيمة، وفيها ينبغي تلمُّس أسباب العلاقة الدائمة الغموض القائمة بين الموسيقى والآداب الإسلاميَّة. فالنغم - عند الفلاسفة – "فضلٌ بقي من المنطق لم يقدر اللسان على استخراجه، فاستخرجته الطبيعة بالألحان" [الأبشيهي: المستطرف...، II، ص 146]. والغرض من استخراج قواعد هذا الفنِّ في رأي بعض المنظِّرين مثل عبد الحميد اللاذقي (التاسع الهجري/السادس عشر الميلادي):
تأنيس الأرواح والنفوس الناطقة إلى عالم القدس لا مجرَّد اللهو والطرب فإنَّ النفس قد يظهُر فيها باستماع واسطة حسنة التأليف وتناسب النغمات فتتذكَّر مصاحبة النفوس العالية ومجاورة العالم العلوي وتسمع نداء: "أرجعي أيتها النفس الغريقة في الأجسام المدلهمَّة المنغمسة في فجور الطبع إلى العقول الروحانية والذخائر النورانيَّة والأماكن القدسانيَّة في مقعد صدْق عند مليك مقتدر"[1].
وفي نفس السياق، فإنّ الموسيقى تضطلع بدورين إيجابيين، فهي:
تعزِّي النفوس وتخفِّف ألم المصائب وبالتالي تجنِّب اليأس والقنوط – أعظم خطايا الإنسان أمام الله – وهي عن طريق ألحانها "المحزنة" عند الدُّعاء والتسبيح والقراءة، ترقق القلوب، وتُبكي العيون، وتُكسب النفوس الندامة على سالف الذنوب، وإخلاص السَّرائر وإصلاح الضمائر، والله سميع مجيب لمثل هذا الورع والخشوع[2].
ويلاحظ إخوان الصفاء:
أن كل صناعة تُعمل باليدين فإن الهيولى الموضوعة فيها إنما هي أجسام طبيعية، وموضوعاتها كلها أشكال جسمانية، إلا الصناعة الموسيقية فإن الهيولى الموضوعة فيها، كلها جواهر روحانية، وهي نفوس المستمعين، وتأثيراتها فيها مظاهرٌ كلها روحانية أيضًا.
وبالتالي فكل صوت له نغمة وصفية وهيئة روحانية، خلاف صوت آخر [...] ولكلِّ مزاج وكلِّ طبيعة نغمة تشاكلها، ولحن يلائمها لا يُحصي عددها إلاَّ الله عزَّ وجلَّ. والدليل أنَّك تجد إذا تأمَّلت لكلِّ أمَّة من الناس ألحانًا ونغمات يستلذُّونها ويفرحون بها، لا يستلذُّها غيرهم ولا يفرح بها سواهم [...] ومن الألحان والنَّغمات ما ينقل النفوس من حال إلى حال ويُغيِّر أخلاقها من ضدٍّ إلى ضدٍّ...[3]
ويرى الغزالي: "أن هذا التأثر موجود في الإنسان بالفطرة، وهو لا يجعل في القلب ما ليس فيه، ولكن يحرك ويهيج ما هو فيه"[4].
"وقد يتوصل بالألحان الحسان – حسب ابن عبد ربه - إلى خير الدنيا والآخرة. فمن ذلك أنها تبعث على مكارم الأخلاق واصطناع المعروف، وصلة الأرحام، والدفاع عن الأعراض، والتَّجاوز عن الذنوب. وقد يَبكي بها الرجل على خطيئته، ويُرقَق القلب من قسوته، ويتذكَّر نعيم الملكوت ويُمثله في ضميره"[5]. لذا، بقيت الموسيقى تلك الصناعة التي هي: "مراد السَّمع، ومرتع النفس، وربيع القلب، ومجال الهوى، ومسلات الكئيب، وأنس الوحيد، وزاد الراكب؛ لعظم موقع الصوت الحسن من القلب، وأخذه بمجامع النفس".
ب. المنحى العلاجي (الموسيقى والطب):
توفرت مراجع عدة (راجع: حاجي خليفة، كشف الظنون) تضمنت تفاصيل حول الاعتقاد في المعالجة بالموسيقى، وقد شمل نواح كثيرة من نظريات الطب والموسيقى والعلاقات الرابطة بينهما. هذا ما يؤكده ابن هندو (ت. 1019) في موسوعته مفتاح الطب، والتي ورد في أحد فصولها بأن الموسيقى: "من العلوم التي يجب على الطبيب أن يعرفها ليكون كاملاً في صنعته". وهو يعترف بأن الأطباء يلجأون في علاج أمراض معينة إلى أساليب موسيقية، تنسجم مع حالة المرض وتُسهم بذلك في شفائهم (يمكن أن يكون الطبيب موسيقيًا، لكن ليس شرطًا، فيلجأ إلى خدمات خبراء ومساعدين ومهنيين آخرين).
وورد في إحدى قصص ألف ليلة وليلة (II/ 87): "الموسيقى لقوم كالغداء ولقوم كالدواء"، ويقول الأبشيهي: "زعم أهل الطب أن الصوت الحسن يسري في الجسم ويجري في العروق، فيصفو له الدم، ويرتاح له القلب، وتهش له النفس، وتهتز الجوارح، وتخف الحركات"[6].
هكذا، حظيت علاقة الموسيقى بالطب، والتداوي بالموسيقى، باهتمام كبير (الرازي، وابن سينا، وابن الهيثم، وابن زهر، وابن رشد وغيرهم). تبعًا لذلك، تم توسيع وتطوير النظرية التي يُعتقد بموجبها وجود أربعة أخلاط في الجسم البشري (الدم – الصفراء – السوداء – البلغم)، مشابهة للعناصر الكونية الأربعة (الأرض – الهواء – النار – الماء)، مع تصور وجود أربع خصائص للمادة (الحرارة والجفاف والرطوبة والبرودة)، أي أنها مكونة من زوجين من الأضداد. هذا مع التأكيد على أهمية عنصر البيئة، أي المناخ والواقع الجغرافي، في تفسير نوعية الموسيقى والأنظمة الموسيقية، الخاصة بالمجموعات والأمم المختلفة، وما بينها من الفوارق الطبيعية في الأمزجة والسلوك والأذواق والعادات والتصورات، أسبابها جوية تنجيمية – وبالتالي، فإن هذه العلامات الفارقة ليست نتيجة للوراثة، بل سببها البيئة والمناخ. طبيًا، ملخص هذه النظرية أن جميع العلل التي تنتاب الإنسان تنتُج عن فساد الأخلاط في جسمه [الدم والبلغم والسوداء والصفراء]، أو تغير مقاديرها (وهي بمثابة اضطرابات كيمياوية تحدث داخل الجسم)، وإن العلاج يكمن في عودة هذه الأخلاط إلى صفائها الأصلي، أو إزالة الأسباب المخلة بتوازنها داخل الجسم.
[ويظهر أثر هذه النظرية – كما سنرى - فيما ينسب إلى الموسيقى من تأثير على هذه الأخلاط]. لذا نرى الشيخ الرئيس ابن سينا (980-1037) في موسوعته القانون في الطب، يبتدئ الفصل الأول من القسم الأول، بتعريف علم الطب ثم بتحديد موضوعه وبعد ذلك ينتقل مباشرة إلى ذكر الأركان وعند الانتهاء من ذلك، يتعرض إلى تعريف وتفصيل الأمزجة والأخلاط. وبالرجوع إلى هذا العمل الضخم، نلاحظ أن ابن سينا، رغم دحضه لنظريات ربط الموسيقى بالتنجيم والكونية، يعمِّق النظر في العلاقة الخاصة بين الموسيقى والطب (والتي تواصلت وتكررت شرقًا وغربًا إلى حدود القرن التاسع عشر)، وهي علاقة تجمع بين الإيقاع والأنغام الموسيقية المتفقة والنبض باعتبارها مؤشرات أساسية للصحة الجيدة أو المرض... وفي الطب النفسي انتبه الأطباء العرب إلى فائدة الموسيقى في الشفاء من بعض الأمراض النفسية والعصبية والعقلية. الرازي (وكان موسيقيًا وعازفًا على العود) درس فائدة الموسيقى في شفاء الأمراض وتسكين الألم، واعتمدها في العلاج الطبي وأوصى بها أسلوبًا مهمًا من أساليب علاج الأمراض النفسية والعصبية والعقلية. وقد حقق نتائج ملحوظة بفضل التجارب التي قام بها، وقد ألف عدة كتب في الطب والسلوك والنفس الإنسانية فضلاً عن إنتاجه في سائر العلوم الأخرى (نذكر منها، الحاوي في الطب، والجامع الكبير). كما برع ابن سينا نظريًا وعمليًا، في هذا الشأن، وهو أول من تكلم عن الطب النفسي الجسدي psychosomatic وطبق مبادئ هذا الطب وأساليبه في المعالجة، كما كان أول من تحدث عن القلق والاكتئاب والميول الانتحارية والانفعالات وتأثيرها في الجسد، وتحدث أيضًا عن تأثير البيئة في المرض العقلي والنفسي، ورأى أن الموسيقى هي أسلوب علاجي مهم ومؤثر في الأمراض العقلية. شرح ذلك في مصنفاته، خاصة كتابه القانون في الطب. كما أن المعالجة النفسانية مثلت دورًا مهمًا في مداواة الآلام الجسدية، ووُضعت كتب خاصة في شأنها ككتاب تأثير الموسيقى في الإنسان والحيوان لابن الهيثم العالم الفيزيائي الموسوعي (965-1040) الذي يمْكن اعتباره مؤسس علم النفس التجريبي. كتابه هذا، يُعد أقدم مخطوطة تتعامل مع تأثير الموسيقى على الحيوانات أو تأثير الأنغام على أرواح الحيوانات، من جملة ما جاء فيها: ان سرعة الجمل تزداد وتقل مع استخدام الحداء، وضرب أمثلة أخرى حول كيفية تأثير الموسيقى على سلوك الحيوان وسيكولوجيته، وقد أجرى تجاربه على الطيور والخيول والزواحف (علمًا وأنه حتى القرن التاسع عشر، اعتقد معظم العلماء بأن الموسيقى لها تأثير واضح على ظاهر الإنسان، ولكن التجارب أثبتت وجهة نظر ابن الهيثم بأن الموسيقى لها تأثير على الحيوانات أيضًا).
في نفس السياق طالب الشيخ الرئيس ابن سينا الذي عرف بتقديره لقوة الموسيقى العلاجية، بضم الوسائل النفسانية إلى التداوي بالعقاقير لزيادة مفعولها وإزالة الخوف عن المريض قائلاً:
وعلينا أن نعلم أن أحسن العلاجات وأنجعها هي العلاجات التي تقوم على تقوية قوى المريض النفسانية والروحية، وتشجيعه ليحن مكافحة المرض، وتجميل محيطه وإسماعه ما عذُب من الموسيقى وجمعه بالناس الذين يحبهم.
جانب آخر حري بالإشادة هنا، مسألة "الترييض الموسيقي الذي يجمع ترييض الجسم والنفس". ونشير هنا إلى كتاب طب المشائخ للطبيب أحمد بن الجزار القيرواني (898-980) الذي جاء فيه: "وقد صح عندي أن الموسيقى والرياضة ملائمان ومُربيان للطبيعة، والذي يمكنه استعمال هاتين الصناعتين استعمالاً جيدًا فإنه يورث بدنه أدبًا، ونفسه حُسنًا وسلامة"؛ أي هو يحرِّض على العناية بالموسيقى والرياضة البدنية معًا، واعتبارهما من أصول المُقوِّمات لطبيعة بني الإنسان.
حافظت نظرية العلاج بالموسيقى على مكانة بارزة لها في الأدب الخاص بالطب والموسيقى بعد القرن الخامس عشر، من ذلك الطبيب داوود الأنطاكي (ت. 1599)، من خلال موسوعته تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب والعجاب. فهو إضافة إلى الأفكار العديدة التي نقلها عن رسالة إخوان الصفا في الموسيقى، اعتنى بما جاء في التنظير الموسيقي في عصره القائم على تعداد وتسميات للمقامات المختلفة وفق خصائصها وتوافقاتها الصحية مشيرًا إلى تأثيراتها الرئيسية (مثلاً الراست ينفع في الشلل النصفي، العراق يساعد على شفاء حالات الأخلاط الحادة، مثل أمراض المخ والدوار وذات الجنب والاختناق وما إلى ذلك).
نختتم هذا القسم، بالتذكير أن مختلف هذه التوجهات لم تكن مجرد تنظير، بل واكبتها تطبيقات وتجارب ملموسة، وصلت أخبارها حتى القرن التاسع عشر. أذكر هنا مثالين تونسيين:
- أولهما خاص بمعالجة الأمراض العقلية والعصبية: خلال الدولة المرادية (1613-1702) حيث قامت الأميرة عزيزة عثمانة زوجة حمودة باشا، بجملة تحبيسات خيرية شملت المارستان المحدث بحومة العزَّافين (القصبة اليوم) بمدينة تونس، وكان له قسم خاص معد لإيواء المصابين باختلال الأعصاب، وكان يسمَّى قديمًا بـ"دار الدراويش" بدلاً من لفظ "المجانين" – من أوقافها على هذه الدار، ريع معتبر يعرف "بحُبُس العود والرباب" رتبته لجراية مطربين ماهرين بالآلات المشار إليها يقومون صباح كل يوم – بدار الدراويش – بعزف نوبة من الموسيقى التقليدية (المالوف) مدة ساعتين، ترويضًا لأولئك المصابين وتهدية لأعصابهم المضطربة (ح. ح. عبد الوهاب: ورقات...).
- الثاني دور الموسيقى في تشخيص المرض: إذ كان حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر (خلال العهد الحسيني) يوجد بسوق الخضارين (سوق الشواشين الآن الواقع شرق جامع الزيتونة بمدينة تونس العتيقة)، ركن خاص بالأطباء، وكان إذا ذهب مريض إلى طبيب منهم أدخله الطبيب إلى مقصورة في عيادته وأسمعه "الطبوع الأصول" وهو ينظر إليه في حال السماع. فإذا ما حركه طبع منها، عرف الطبيب طبيعته فعرف إذ ذاك كيف يدخله طبيًا"[7].
هذه قطرة من بحر مما ورد في المصادر العربية الإسلامية، حول أثر الموسيقى وتأثيرها في النفس، وقد تم تناولها - كما أسلفنا - من أوجه نظر مختلفة تداخل فيها الواقع بالأسطورة والعلم بالتخمين.
غير أن الصورة لا تكتمل دون معرفة الكيفية التي تفاعل بها المنظرون والموسيقيون أنفسهم مع هذه الظاهرة. وكيف وقعت ترجمتها في نظرياتهم ومؤلفاتهم الموسيقية. وهو المحور الثاني من هذه المداخلة.
الموسيقي ومبدأ التأثير
أ. العود آلة مرجعية للموسيقى العربية
في إطار الحضارة العربية، يجد كل من التأثير الموسيقي والعلاج الموسيقي تعبيرهما بوضوح في الخصائص التي ينسبها المنظِّرون لأوتار العود ومن خلاله للمقامات والإيقاعات. في هذا المجال، شكلت آلة العود وسيلة مرجعية أساسية، نظريًا وتطبيقيًا، باعتبارها "أتمّ وأحسن ما صنع من الآلات"، وربطوا نغماتها بعوالم الأرواح والكون والأجساد.
أهمية الآلة
منذ الفترة الأموية، احتل العود لدى الموسيقيين العرب، مكانة مرموقة واستخدمه المحترفون للمسايرة، واعتمده الروَّاد الأوائل لإرساء أسس تنظير موسيقاهم باعتباره – كما يفيد الفارابي – "من الآلات الوترية المألوفة منذ القدم، عند الأمم الشرقية، لا تضارعها آلة أخرى".
وقد تُوجت هذه المكانة مع الفترة العباسية الأولى (القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي)، حيث بلغ الفن الموسيقي عصره الذهبي ليشكل أحد أركان العلوم الرياضية وعنصرًا هامًا في الحكمة الرباعية (إلى جانب الحساب والهندسة والفلك)، وجزءًا أساسيًا في الثقافة العربية باتجاهيها:
- التجريدي المعتمد على التأثير الموسيقي في علاقة مع نظريتي العناصر الأربعة والأخلاط.
- الطبيعي الرياضي والتجريبي في نفس الآن، والذي يركز أساسًا على فيزيائية الصوت وتحديد النسب.
وسوف نكتفي في هنا، بالتركيز على التوجه الأول الخاص بالبعد التأثيري للموسيقى، محور هذا المنتدى.
العلاقة مع مبدأ التأثير
في هذا الإطار، صار العود باعتراف الجميع، "أشهر الآلات وأثمنها"، والمرجع الرئيسي دون سواه، في معالجة الصناعة الموسيقية وشرح نظرياتها ودراسة أبعادها الفيزيائية والفلسفية والفلكية؛ حتى اعتبرت معرفة العود ونسب دساتينه "من تمام علم الموسيقى" (الكندي). ومن هذا المنطلق، اعتنى به الفلاسفة والمنظرون وجعلوه يحتل صفحات طويلة من مؤلفاتهم.
وفي سياق العناية بمعالجة تأثير الموسيقى في نفوس الكائنات الحية، وكذلك في الجسم، والخوض في موضوع الموسيقى من ناحية علاقاتها بالفلك والأجرام السماوية، يبيِّن المنظرون العرب، أمثال الكندي وإخوان الصفا ومن نحى نحوهما: "كيف رُكبت على العود أربعة أوتار بعشر طاقات (4+3+2+1)، ثم صُبغت بألوان النقوش السحابية التي تُرى قبالة الشمس، والتي تُرينا ألوان العناصر الأربعة: "فالزير يشبه بالصفراء، والمثنى بالحمرة والدم، والمثلث ببياض البلغم، والبم بسواد السوداء".
وانطلاقًا من أوتار العود والنغم المستخرجة من دساتينه، تُشرح العلل النجومية التي وُضع عليها العود، ومشاكلة أوتاره الأربع لأرباع الفلك، وأرباع البروج، وأرباع القمر، وأركان العناصر، ومهب الرياح، وفصول السنة، وأرباع الشهر، وأرباع اليوم، وأركان البدن، وأرباع الأسنان، وقوى النفس المنبعثة في الرأس، وقواها الكائنة في البدن، وأفعالها الظاهرة في الحيوان... ذلك تماشيًا مع رمزية الأرقام (مثل أربعة وسبعة واثنى عشر) وما يُنسب لها من معان ورموز - يقترن بمبدأ التأثير الموسيقي. وهو مبدأ جذوره ضاربة في القدم، يرى بأنَّ كلَّ كائن أرضي يكون "متأثِّرًا" بكائن آخر سماويٍّ. فنغمات الديوان السبعة تطابق السماوات والكواكب السيَّارة السبع. وصور البروج الاثني عشر تقرن إلى ملاوي العود الأربعة ودساتينه الأربعة وأوتاره الأربعة. وعلاقة أوتار العود الأربعة بالطبائع والعناصر الكونيَّة والرياح والفصول، والأمزجة وقوى النفس وأركان البدن، والألوان والعطور، وأرباع دائرة البروج وأرباع الفلك والقمر، الخ.
وهم في إطار حكمة رباعيَّة الأبعاد، تطرقوا للموسيقى بأن أخضعوا لها آلة العود في جميع عناصرها النغميَّة الصادرة من أوتارها الأربعة "لا أقلَّ ولا أكثر" (يقول الكندي)، وربطها بالحركات الفلكيَّة والفصول الزمنيَّة والأطوار المتتابعة في عمر الإنسان.. ومزجها مع عناصر الطبيعة ومصادر قوى البدن ومعاني النفس في مشاعرها وعواطفها. وهم يرون بأنَّ هذه النَّغمات إذا ما أُلِّفت في الألحان المشاكلة لها، ثمَّ استعملت في أوقات الليل والنهار المُضادَّة طبيعتها طبيعة الأمراض الغالبة والعلل العارضة، سكَّنتها وكسرت سوْرتها، وخفَّفت على المرضى آلامها، لأنَّ "الأشياء المُشاكلة في الطباع إذا كثرت واجتمعت، قويت أفعالها وظهرت تأثيراتها، وغلبت أضدادها"[8].
(شكل العود القديم)
العود الكامل عن "الأدوار" لصفي الدين الأرموي البغدادي
(مخ. بتاريخ: 1333-1334)
العود في مخطوط كشف الهموم
(القرن التاسع ه/الخامس عشر م)
البعد الدلالي للأوتار
حسب التوجه المذكور، فإنَّ الأوتار الأربعة المقابلة للطبائع الأربع تقضي طبائعها بالاعتدال، فـ البمُّ حار يابس يقابل المثنى وهو حار رطب وعليه تسويته، والزير حار يابس يقابل المثلث وهو حار رطب. قوبل كل طبع بضدِّه حتى اعتدل واستوى كاستواء الجسم بأخلاطه. إلاَّ أنَّه عطل من النفس، والنفس مقرونة بالدم، لتدارك ذلك، أضاف زرياب (789-857)، في مرحلة وجوده بالأندلس، إلى الوتر الأوسط الدَّموي وترًا خامسًا، أحمر داكن. وضعه تحت المثلث وفوق المثنى، فكمل في عوده قوى الطبائع الأربع، وقام الخامس المزيد مقام النفس في الجسد.. واكتسب عوده بذلك - كما تقول المصادر – "ألطف معنى وأكمل فائدة"[9].
واضح أنَّ مبادرة زرياب في إضافة وتر خامس لم تأت – كما ظنَّ البعض - لتوسيع المساحة الصوتيَّة للآلة، بل لتلبية غرض تجريدي بحت، وهي بالأساس، تتويج للنظرة الصوفيَّة-التجريدية التي ميَّزت توجُّهات المدرسة العربيَّة التقليديَّة، وقد أستمرَّ أثرها متفشيًّا على مرِّ العصور.
وعلى غرار الروَّاد الكبار، أعطى زرياب للموسيقى طابعًا سحريًا–روحيًا مؤكِّدًا أكثر من مرَّة "أنَّ الجنَّ كانت تعلِّمه كلَّ ليلة ما بين نوبة إلى صوت واحد، كان يهبُّ من نومه سريعًا فيدعو بجاريتيه غزلان وهنيدة، فتأخذان عودهما، ويأخذ هو عوده، فيطارحهما ليلته ويكتب الشعر ثمَّ يعود عاجلاً إلى مضجعه. وكان جمهوره المأسور بروعة أغانيه يدَّعي "أنَّ الجنَّ يزور بيته ليلاً ويعلِّمه ألحانًا عجيبة".
وفيما يلي جدول يلخص هذه نظرية المتعلقة بمشاكلة أوتار العود لأركان العناصر الكونية والطبائع البشرية:
جدول: في مشاكلة أوتار العود لأركان العناصر الكونية والطبائع البشرية
|
الأوتار |
اللون |
الأركان |
التناسب / الصفة |
الطبائع / الأخلاط |
المفعول |
المضادة |
|
الزير |
أصفر |
النار |
حرارة النار وحدتها |
تقوي خلط الصفراء |
تزيد في قوتها وتأثيرها |
تضاد خلط البلغم وتلطفه |
|
المثنى |
أحمر |
الهواء |
رطوبة الهواء ولينه |
تقوي خلط الدم |
تزيد في قوتها وتأثيرها |
تضاد خلط السوداء وترققه وتلينه |
|
* وتر زرياب |
*أحمر داكن |
* الحياة |
------- |
* الروح |
------- |
------- |
|
المثلث |
أبيض |
الماء |
رطوبة الماء وبرودته |
تقوي خلط البلغم |
تزيد في قوته وتأثيره |
تضاد خلط الصفراء |
|
البم |
أسود |
التراب |
ثقل الأرض وغلظها |
تقوي خلط السوداء |
تزيد في قوتها وتأثيرها |
تضاد خلط الدم وتسكِّن فورانه |
خصوصية العود التقليدي المغاربي
احتلَّ هذا البعد السحري العقائدي للموسيقى مكانة مرموقة في المدرسة الموسيقيَّة للغرب الإسلامي، حيث أعطيت أهميَّة كبيرة للقدرة التعبيريَّة والعلاجيَّة للموسيقى ولآثارها على النفس الإنسانيَّة. وبعد ما كان هذا التصوُّر للموسيقى قد وقع في مزايدات نظريَّة عميقة في المشرق بعد الكندي وإخوان الصفا، فقد تجذَّر في الغرب الإسلامي حيث أصبح الأساس الحقيقي لبناء موسيقي يقوم على رمزية عدد للطبوع (والنوبات): أربع وعشرين طبعًا لكلٍّ منها نوبته الخاصة، وذلك باعتبار أنه لكل طبع ونوبة ساعة محددة من الساعات الأربع وعشرين. وهذا يحيلنا إلى الاعتقاد القائل بأن الموسيقى تعكس جمال التناغم للكون، وأن فهم القوانين الأساسية للتأليف الموسيقي، هو السبيل إلى فهم أسرار الخليقة. وبالتالي فإن الاستخدام المناسب للموسيقى في الوقت المناسب، له تأثير شاف على الجسم.
غير أنه عمليًا، يبقى هذا العدد ذو أبعاد رمزية بحتة، ذلك لأن المصادر تفند هذا العدد سواء بالنسبة للطبوع أو النوب [التيفاشي: متعة الأسماع في علم السماع]: "يوجد من مغنِّي الأندلس رجالاً ونساء من يغنِّي خمسمائة نوبة ونحوها، والنوبة عندهم: نشيد، وصوت، وموشح، وزجل". وهو عدد يبعدنا تمامًا عن 24... وعلينا أن نذكر بأن هذا التوجه المغاربي، يرتكز هو أيضًا بالأساس على آلة العود، لكنه عود رُباعي من نوع خاص بالتقاليد الموسيقية المغاربية. يعرف بـالعود ["عربي"-"رمال"- "صويري"-"كويترة"]. كما تتماشى تسميات أوتاره الأربعة مع المصطلحات المألوفة في التراث الموسيقي المغاربي. وتعتمد تسوية تداخل الخامسات، وهي من القرار إلى الجواب: [الذيل - الماية - الرمل – الحسين]، والتي هي في نفس الوقت تسميات الطبوع الرئيسية الأربعة، التي تقوم عليها شجرة طبوع النظام الموسيقي المغاربي. تختلف هذه التسميات عن الاصطلاح القديم [بم - مثلث - مثنى – زير] أو المشرقي الحديث: [عشيران - دوكاه - نوا – كردان]. وفيما يلي جدول يلخص النقاط المذكورة:
جدول 1: تسوية العود المغاربي
|
الأوتار (1) (من القرار إلى الجواب) |
الرمز [ذمْرحْ] |
الأوتار (2) (حسب تسلسلها على الآلة) |
الرمز [ذحْمرْ] |
مطلق |
سبابة (شاهد) |
بنصر (ضامن) |
|
الذيل |
الذال |
لذيل |
الذال |
أ (دو) |
||
|
الماية |
الميم |
حسين |
الحاء |
ب (ري) |
ج (مي) |
د (فا) |
|
الرمل |
الراء |
الماية |
الميم |
ه- (صول) |
||
|
حسين |
الحاء |
الرمل |
الراء |
و (لا) |
ز (سي) |
ح (دو) |
*استعمالنا للنوتة الغربية نسبي، فالمهم – كما هو الحال في النظام المقامي – مراعاة النسب الكائنة بين النغمات. وهو ما يمكن ترجمته بالرسمين التاليين:
تسوية العود التقليدي المغاربي
جدول 2: مقارن للتسويتين المشرقية والمغاربية
|
أوتار العود وتسويته |
|||||
|
أسماء الأوتار |
التسلسل |
المسافة الصوتيَّة |
|||
|
أ- المدرسة العربية القديمة - الحديثة |
ب- المدرسة المغاربيّة-الأندلسية |
أ |
ب |
أ |
ب |
|
بم - عشيران مثلث – دوكاه مثنى – نوا زير – كردان |
ذيل ماية رمل حسين |
الأوّل الثاني الثالث الرابع |
- الأول رباعية تامة - الثالث رباعية تامة الرابع رباعية تامة - الثاني |
ثنائيّة كبيرة رباعية تامة ثنائيَّة كبيرة |
|
ب. المقامية نظريًا ودلاليًا
محاولات تصنيف المقامات والطبوع
المقام بالمشرق العربي
من الملاحظ أن مصطلح "مقام" (ج. مقامات) الذي حل محل الاصطلاحات [إصبع- طنين - لحن - شد - جمع] و[طريقة - بحر - دور - برده - أواز]، لم يعمّ استعماله إلا مع القرن الثامن الهجري/الرابع عشر ميلادي. ولمصطلح "مقام" علاقة مؤكدة بالأدب الصوفي والمقامات الصوفية، وقد اقترن استعماله بانتشار الحركة الصوفية.
أقدم من ذكر مصطلح المقام، قطب الدين الشيرازي (1236-1311): درة التاج لغرة الديباج؛ وصلاح الدين الصفدي (1296-1362) رسالة في علم الموسيقى - يبدو أنه منقول بتصرف عن الميزان في علم الأدوار والأوزان، المنسوب لصفي الدين الحلي (1278-1349) وهو يقترب في مضمونه إلى الشجرة ذات الأكمام.
ويفيد اللاذقي (ت. 1495) بأن المتأخرين سمّوا بعض الألحان المشهورة في زمانهم "مقام" (12) وبعضها "أواز" (7) وبعضها "شعبة" (24) وبعضها "تركيب" (30). ويوجد البعض الآخر منها لا اسم له عندهم. أما الآن فيسمون تلك الألحان بـ مقام فقط.. وهي في عصره، إحدى وتسعون دائرة (على غرار دوائر صفي الدين) حاصلة من إضافة أقسام الطبقة الثانية إلى أقسام الطبقة الأولى[10].
توجد تصنيفات عدة للمقامات، وذلك حسب:
- الأصول والفروع
- درجات الاستقرار/الركوز
- المقامات الأصلية وفصائلها
- الأجناس الرئيسية
- مبدأ التأثير
الأصول والفروع:
وهو امتداد لمذهب المتوسطين عند المتأخرين (بداية من العاشر ه- السادس عشر م)، الذين توسعوا بدورهم في فروع الأصول واستخراج ما يتشعب منها. وهذه القائمة كما وردت لدى قدماء المنهجيين (صفي الدين) والمتأخرين منهم (ابن غيبي واللاذقي):
|
المقامات |
الأوازات |
الشعب |
التراكيب |
|
راست |
كواشت - كواشت |
دوكاه - يكاه |
--- - سنبلة |
|
عراق |
نوروز - نوروز |
سيكاه - دوكاه |
--- - عزال |
|
أصفهان |
سلمك - سلمك |
جهاركاه - سيكاه |
--- - نهفت |
|
زيرافكند |
شهناز - شهناز |
بنجكاه - جهاركاه |
--- - نيريز صغير |
|
بزرك |
كردانية - حصار |
عشيران |
--- - نيريز كبير |
|
زنكولة |
ماية - كردانية |
نوروز عرب |
--- - هاوند صغير |
|
راهوي |
---- - ماية |
ماهور |
--- - قرجغار |
|
حسيني |
نوروز خارا |
--- - عجم |
|
|
حجازي |
نوروز بياتي |
--- - اصفهانك |
|
|
أبوسليك |
حصار |
--- - راحة الأرواح |
|
|
نوى |
نهفت |
--- - زوالي سه كاه |
|
|
عشاق |
عزال |
--- - زوالي اصفهان |
|
|
أوج |
--- - نمار |
||
|
نيريز |
--- - نيشابورك |
||
|
مبرقع |
--- - خوذي |
||
|
ركب |
--- - حجست |
||
|
صبا |
--- - زمزم |
||
|
همايون |
--- - همايون |
||
|
اصفهانك |
--- - مستعار |
||
|
زاولي |
--- - نكانيك |
||
|
بستة نكار |
--- - بنجكاه أصل |
||
|
نهاوند |
--- - بنجكاه زايد |
||
|
خوذي |
--- - محيّر |
||
|
محيّر |
--- - أوج |
||
|
--- - ماهور كبير |
|||
|
--- - ماهور صغير |
|||
|
--- - بستة نكار |
|||
|
--- - عشيران |
مذاهب هذه القسمة من أصول وفروع ومركبة توسعت وتنوعت على مر العصور، مع اختلاف في هيئات الشعب والأوازات. وتوجد روايات تبلغ فيها المقامات الأساسية والفرعية ستة وثمانين (86) مقامًا، تم اختيارها من مائتين وخمسة وثلاثين (235) مقامًا. ويصل المجموع حوالي 360 مقامًا عند العرب والأتراك والفرس، بين أساسية وفرعية وفرعية مركبة (341) [مؤتمر 1932 وسليم الحلو، ص 88-133]؛ المشهور منها 32 عند عرب المشرق والأتراك، دون احتساب الطبوع المغاربية. إن توليد المقامات ليس له نهاية، لكنها عمليًا تنحصر في خمسة وتسعين مقامًا، استعمل منها زمنًا طويلاً لدى الممارسين، من الثلاثين إلى الأربعين مقامًا[11].
حسب درجة الارتكاز الأصلية
وتنظيمًا لهذا الكم الهائل من المقامات، اجتهد بعضهم في تصنيفها بطريقة تبسط سبل التعامل معها، من ذلك ترتيبها بحسب درجات استقرارها الأصلية؛ أو بحسب المقامات الأصلية وفصائلها، على النحو التالي[12]:
|
درجة الارتكاز |
المقامات |
درجة الارتكاز |
المقامات |
|
- اليكاه
- العشيران
- عجم عشيران
- العراق
- الراست |
اليكاه – شد عربان – فرحفزا – سلطان يكاه – طرز جديد – نهوفت العرب. (حسيني عشيران) – سوزدل – شوق طرب. عجم عشيران – شوق آور – شوق أفزا - عجم مرصع . العراق – (أوج) – بستة نكار - راحة الأرواح – فرحناك – أويج آرا. الراست – ماهور – ( كردان) - رهاوي – سوزدلارا – زاويل – سازكار – (زنكلاه) - دلنشين – بسنديدة - سوزناك – نهاوند – نهاوند كردي – نهاوند كبير – نهاوند مرصع – نوأثر – نكريز – بسنديدة - حجاز كار – حجاز كار كرد – زنجران – سوزناك جديد – طرزنوين. |
- الدوكاه
- السيكاه
- الجهاركاه - نوى |
بياتي – عشاق تركي – حسيني- طاهر - عرضبار – (حسيني) –محير- (قارجغار / شوري) - كلعزار – بياتين – صبا- صبا زمزمة – صبا بوسليك – قارجغار – كرد – شاهناز كردي – حجاز – حجاز عجمي – شاهناز – (بوسليك) – بوسليك جديد – (عشاق مصري) – نيشابورك – أصفهان - حصار. السيكاه – ماية – شعار – مستعار – هزام. جهاركاه – جهاركاه تركي. نوى – نوى كرد – نوى عجم – نوى بوسليك – حجاز نوى |
المقامات بحسب فصائلها[13]
|
مقام |
الفصائل |
المقام |
الفصائل |
|
- عجم
- راست
- سيكاه - هزام - عراق - نهاوند
|
عجم عشيران - شوق أفزا – عجم مرصع – جهاركاه . راست كردان – رهاوي – ماهور – سوزدل آرا – زاويل – سازكار – دلنشين – سوزناك – يكاه – نوى – نيرز راست – نيشابورك – أصفهان. ماية – شعار- أويج – مستعار – فرحناك. راحة الأرواح. بسته نكار. نهاوند كرذي – نهاوند كبير – نهاوند مرصع – فرحفزا – سلطاني يكاه – طرز جديد – نوى عجم – بوسليك – بوسليك جديد – عشاق مصري – شوق آور. |
- نوأثر - حجاز
- كرد
- بياتي
- صبا |
حصار – نكريز – بسنديدة – حجاز كار – شد عربان – سوزدل – أويج آرا – شاهناز- جهاركاه تركي - نهوفت العرب – حجاز النوى – حجاز عجمي – زنجران – سوزناك جديد. حجاز كار كرد – شوق طرب – طرزنوين – شاهناز كردي – حصار كردي . حسيني – محير – طاهر – عرضبار – عشاق تركي – حسيني عشيران – بياتين – قارجغار. صبا زمزمة – صبا بوس |
تبسيط المقامات واختصارها في 11 جنسا رئيسية (بحجة تماثلها)
|
الجنس الأساسي |
الارتكاز الأصلي |
النسب (تقريبية) |
الجنس المماثل |
الارتكاز |
|
العجم عشيران |
عجم عشيران |
(1) (1) (½) |
الجهاركاه |
جهاركاه |
|
الراست |
راست |
(1) (¾) (¾) |
اليكاه |
يكاه |
|
نهاوند |
راست |
(1) (½) (1) |
البوسلك - العشاق |
دوكاه |
|
نوأثر |
راست |
(1) (½) (1½) |
الحصار |
دوكاه |
|
بياتي |
دوكاه |
(¾) (¾) (1) |
||
|
حجاز |
دوكاه |
(½) (1½) (½) |
الحجاز كار السوزدل الشاهناز الشدعربان الأوج آرا |
راست عشيران دوكاه يكاه كوشت |
|
الصبا |
دوكاه |
(¾) (¾) (½) |
||
|
الكرد |
دوكاه |
(½) (1) (1) |
العجم كرد |
دوكاه |
|
السيكاه |
سيكاه |
(¾) (1) |
الفرحناك |
عراق |
|
العراق |
عراق |
(¾) (1) (¾) |
||
|
الهزام |
سيكاه |
(¾) (1) (½) |
راحة الأرواح |
عراق |
الطبع بالمغرب العربي
ظهر مصطلح "طبع" (ج. طبوع) بالمغرب العربي، مع القرن العاشر الهجري/السادس عشر ميلادي. وهو دليل يؤكد على المنحى التجريدي الصوفي لهذه المدرسة. أقدم وثيقة وصلتنا تتعلَّق بالطبوع، تعود إلى العهد الحفصي من خلال قصيد في 56 بيت من بحر البسيط، في ذكر الرسول (صلعم) للشاعر الصوفي محمد الظريف (ت. 1385) مطلعه: "من سفك دمعي ومن تحبير أجفاني". ست أبيات منه [15-20] تتضمَّن مجموعة تسميات، دون ذكر مصطلح الطبع. وهي على التوالي: [الرهاوي – الذيل – الرمل – الإصبهان – الصيكة – المحير – المزموم – العراق – الحسين – النوى – (رصد الذيل) – الماية – الرصد – الأصبعين]. كما ورد مصطلح الطبع مع أربع تسميات: [ذيل - عراق عرب - رمل ماية- رمل] في هامش لمقطوعة زجلية لـ لسان الدين ابن الخطيب[14] (1313- 1374). ولا ندري بالتحديد إذا كان هذا التعليق هو من إضافة أحد ناسخي المخطوط، أو يعود إلى المؤلِّف نفسه الذي وضع مصنَّفه بعد صرفه عن الأندلس واستقراره بالمغرب.
عدد الطبوع وكيفية تصنيفها:
لم تتوضح مسألة الطبوع إلا مع أوائل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، وذلك من خلال قصيد في إحدى عشر بيتًا من بحر الطويل للقاضي عبد الواحد الونشريسي (1478-1548)، أواخر عهد الوطاسيين بالمغرب الأقصى، مطلعه: "طبائع ما في الكون أربعة"، يذكر فيه مصطلح الطبع مع 17 تسمية: 5 أصول (ذيل - ماية - زيدان – مزموم)، و12 فروع (أصل: الغريبة المحررة، وهو دون فرع). علمًا وأن تسميات الطبوع تحاكي أسماء الأوتار الأربعة للعود التقليدي وكذلك بالنغمات الأصول السبعة للسلم التي تتلخص في الجمل التالية:
|
ذ |
م |
ســـ |
ــــمـــ |
ـــر |
حـــ |
ــــس |
|
ذيل |
ماية |
سيكة |
مزموم |
رمل |
حسين |
سيكة حسين |
توسع عدد الطبوع فيما بعد، مع كل من (الوجدي XVII = 23) - (البوعصامي والحائك (XVIII = شجرة بها 26 طبعًا: 5 أساسية و21 فرعية، غير أن الصيكة والمشرقي خارجان عن الشجرة:
|
طبع أساسي |
طبوع فرعية |
|
- ذيل |
رصد الذيل - رمل الذيل عراق [العرب/العجم - مجنب الذيل – استهلال الذيل]. |
|
- ماية |
رصد – حسين – رمل [الماية – انقلاب الرمل] |
|
- زيدان |
أصبهان – عشاق– حصار - زوركند – حجاز[الكبير/المشرقي] |
|
- مزموم |
غريبة الحسين [حمدان] |
|
- غريبة المحرّرة |
أصل دون فرع.. |
|
- خارج الشجرة |
الصيكة (تابع الماية) - المشرقي (تابع المزموم) |
هكذا تزايد عدد الطبوع من 13 (الظريف ت. 1385) إلى 17 (الونشريسي ت. 1549)، 23 (الوجدي XVII)، ثم مع البوعصامي والحائك (XVIII) شجرة بها 26 طبعًا: 5 أساسية و21 فرعية. يوجد نفس الشيء لدى إبراهيم التادلي (ت. 1894) في كتابه أغاني الصكا في علم الموسيقى.
عمليًا، تتخذ الطبوع خاصيات تختلف باختلاف الأرصدة المغاربية، نحوصلها في الجدولين التاليين (علمًا وأن تماثل التسميات لا يعني تماثل خاصيات الطبوع أو الأجناس المكونة لها). وفيما يلي نورد جدولين[15]:
- جدول مقارن للطبوع المغاربية بحسب الاصطلاحات المتداولة
- جدول الأجناس المستعملة
[عادة ما يرتبط طبع بالنوبة التي تسمى باسمه؛ والنوبات المعروفة، هي 11 في رصيد الآلة المغربية – 12 بالغرناطي ، الصنعة أو المالوف بالجزائر – 13 بالمالوف التونسي – وعدد موزع على 24 مجموعة تقريبا بليبيا. راجع محمود قطاط: التراث الموسيقي العربي / المدرسة المغاربية الأندلسية، المجمع العربي للموسيقى – جامعة الدول العربية، عمان / بغداد 2002.
Mahmoud Guettat: La musique arabo-andalouse / L'empreinte du Maghreb, Montréal-Paris, 2000
- جدول مقارن للطبوع المغاربية بحسب الاصطلاحات المتداولة
|
ع |
ليبيا |
تونس |
الجزائر |
المغرب |
|
الطبوع |
ليبيا |
تونس |
الجزائر |
المغرب |
|
ـ ذيل |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- رمل الكبير |
|
+ |
|
|
|
مجنب الذيل |
|
+ |
|
+ |
|
- رمل الماية |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- رصد الذيل |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- الماية |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- رمل الذيل |
|
|
|
+ |
|
- انقلاب الرمل |
|
|
|
+ |
|
- استهلال الذيل |
|
|
|
+ |
|
- صيكة |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- ذيل قسنطيني |
|
|
+ |
|
|
- صيكة حسين |
|
|
+ |
|
|
- ذيل براني |
|
|
+ |
|
|
- أصبهان |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
ـ ماية |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- عشاق |
|
|
|
+ |
|
ـ زيدان |
|
|
+ |
+ |
|
- حصار |
|
|
|
+ |
|
ـ مزموم |
|
+ |
+ |
|
|
- زوركند |
|
|
|
+ |
|
- مزموم محير |
+ |
|
|
|
|
- حجاز الكبير |
|
|
|
+ |
|
- مزموم صنعة |
|
|
|
+ |
|
- حجاز المشرقي |
|
|
|
+ |
|
- مزموم مُوال |
|
|
|
+ |
|
- مشرقي |
|
|
|
+ |
|
ـ غريبة المحرّرة |
|
|
|
+ |
|
- مشرقي صغير |
|
|
|
+ |
|
- غريبة الحسين |
|
|
+ |
+ |
|
- نوى |
+ |
+ |
+ |
|
|
- عراق |
+ |
+ |
+ |
|
|
- أصبعين |
+ |
+ |
|
|
|
- عراق العرب |
|
|
|
+ |
|
- انقلاب أصبعين |
|
+ |
|
|
|
- عراق العجم |
|
|
|
+ |
|
- محير |
|
|
+ |
|
|
- رصد |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- محير عراق |
|
+ |
|
|
|
- رصد قناوي |
|
|
|
+ |
|
- محير صيكة |
|
+ |
|
|
|
- رصد عبيدي |
|
+ |
|
|
|
- رهاوي |
|
+ |
+ |
|
|
- حسين |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
- ساحلي |
|
|
+ |
|
|
- حسين عجم |
+ |
+ |
|
|
|
- جاركه |
|
|
+ |
|
|
- حسين صبا |
+ |
+ |
|
|
|
- مُوال |
|
|
+ |
|
|
- حسين نيرز |
|
+ |
|
|
|
- غريب |
|
|
+ |
|
|
- حسين عشيران |
|
+ |
|
|
|
- مجنبة |
|
|
+ |
|
|
- رمل |
+ |
+ |
+ |
|
|
- حمدان |
|
|
|
+ |
|
- رمل العشية |
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
الأجناس المستعملة
|
الأجناس المستعملة |
المصطلحات المحلية |
|
(1) (1) (½) |
غريبة الحسين (المغرب) |
|
(1) (½) (1) |
حسين (المغرب) |
|
(½) (1) (1) (1) |
صيكة (المغرب- الجزائر) |
|
(1) * (¾)* (¾) (1) |
ذيل (تونس – ليبيا) |
|
* (¾)* (¾) (1) |
حسين (تونس-ليبيا) |
|
*(¾) (1) |
صيكة (تونس – ليبيا) |
|
(1) * (¾)* (1 4/1) (½) |
رصد الذيل (تونس – ليبيا) |
|
(1) * (¾)(1) * (¾) |
رصد الذيل (تونس) |
|
(½) (1½) (½) |
مجنبة، رمل، زيدان (الجزائر) زيدان، حجاز كبير، حجاز مشرقي، رمل الذيل (المغرب) |
|
(1) (1½)(1) |
رصد (المغرب – تونس) |
|
(1) (½)(½)(½) |
الرصيد الشعبي |
*** *** ***
التأثير الموسيقي عند العرب 2
مقاربة تاريخية - نظرية - فنية
مبدأ التأثير:
تقليديًا - إضافة إلى الخصائص النظرية - ينفرد كل مقام أو طبع (حتى مع تطابق السلالم) بملامح معيَّنة تبرز من خلال تراكيبه اللحنية (وأحيانًا اللحنية–الإيقاعية)، تعرف بـ "روح المقام/الطبع"، يستمد منها قدراته التعبيرية والتأثيرية. لهذا الإحساس المقامي المميَّز، أبعاد أربع:
- نظري: تتحدد عن طريقه مكونات السلم (درجاته، أبعاده، أجناسه، الخ).
- فنِّي: ثابت يتم من خلاله، التعرف على المقام (خصوصية درجاته، قفلاته، الخ).
- تأثيري: يختلف وقعه حسب الإدراك الحسي والمزاج النفسي للمؤدي وكذلك للمتلقي.
- ماورائي: حيث كان يُنسب لكل مقام أو طبع قدرة تأثيرية خاصة.
من هذا المنطلق، حُدد لكل مقام أو طبع وقتًا معينًا لإجراء العمل به، وبنيت بالتالي، نظرية ما يعرف بـ شجرة المقامات أو الطبوع (الأصلية والفرعية)، في علاقة بنظريتي العناصر الأربعة والأخلاط، وما يتبعها من علاقة الأنغام بالأجرام، وتأثيرها في النفس، والأوقات المناسبة للعمل بها (من ذلك جاء الحديث على 24 طبع/مقام بعدد ساعات اليوم).
وهي أيضًا طريقة من طرق التصنيف إلى جانب تصنيفات أخرى تم ذكرها (التصنيف بحسب الأصول والفروع، درجة الارتكاز أو الأجناس الرئيسية).
هذا الاتجاه القائل بارتباط مبدأ التأثير الموسيقي بالظواهر الطبيعة، كان – كما بيَّنا - من مميزات المدرسة التأسيسية/العودية، اهتم به روادها انطلاقًا من الكندي ثم زرياب وإخوان الصفا ومن نحى نحوهم.
ومع القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، تقلص الاهتمام به، واختار كل من الفارابي وابن سينا من بعده، عدم المبالغة فيه معتمدين في المقابل توجهًا طبيعيًا رياضيًا وتجريبيًا في نفس الوقت، يعتمد أساسًا على فيزيائية الصوت الموسيقي وتحديد النسب الرابطة بين مختلف الأصوات. غير أن هذا، لم يمنع تواصل الاهتمام بالمنحى التجريدي في المراحل اللاحقة (وحتى من قبل الفارابي وابن سينا). يقول الفارابي:
والألحان بالجملة صنفان: صنف أُلِّف ليلحق الحواس منه اللذة فقط، من غير أن يوقع في النفس شيئًا آخر، ومنها ما ألف ليفيد النفس مع اللذة شيئًا آخر من تخيلات أو انفعالات، ويكون بها محاكيات أمور أخر، والصنف الأول أقل غناء، والثاني هو النافع منها، وهو الألحان الكاملة، وهي أيضًا التابعة للأقاويل الموزونة، أعني الشعر [...] والألحان الكاملة ثلاثة أصناف: منها الألحان المقوية، ومنها الملينة ومنها الألحان المعدلة، وقد تسمى الاستقرارية أو الحافظة...
ويستمر هذا المنحى مع المتأخرين وهذا صفيِّ الدين (1230-1294) رائد المدرسة النظاميَّة، في كتاب الأدوار، يستهلُّ الفصل الرابع عشر في تأثير النغم بقوله: "أعلم أنَّ كلَّ شدٍّ من الشدود (أي مقام من المقامات) له تأثير ملذ إلاَّ أنَّها مختلفة"[1].
نظرية الشجرة:
تواصل هذا التوجه بعد صفي الدين وابن غيبي واللاذقي، وأصبحت هيئات الأصول (المقامات) والفروع (برداوات-شعب–أوازات-بحور)، تتنزل على البروج الاثنى عشر (وإن اختلفوا في هيئات الفروع) وذلك في إطار ما صار يعرف بـ "الشجرة" الحاوية لمجمل المقامات (الأًصول والفروع). من ذلك:
"شجرة المقامات": أربعة أصول (راست–عراق–زيرافكند–أصفهان)، تستخرج منها 8 فروع (اثنان من كل أصل) وهي التي كانت تعرف بالأدوار؛ ثم 24 شعب (اثنان في كل دور)، و6 أوازات من بين كل اثنين من الأدوار، أي ما مجمله 42[2].]
جدول: المقامات الاثنى عشر (الأصول والفروع وما يقابلها من الأمزجة والعناصر والبروج)
|
المقامات |
الأمزجة الغالبة في الإنسان (4) |
العناصر الطبيعية (4) |
الأخلاط (4) |
البروج الفلك (12) |
|
الراست (الزنكلاه – العشاق) |
حار يابس |
النار |
الصفراء |
الحمل الأسد القوس |
|
العراق (الحجاز – أبوسليك) |
حار رطب |
الهواء |
الدم |
الجوزاء الميزان الدلو |
|
الزيرفكند (الرهاوي – البزرك) |
بارد رطب |
الماء |
البلغم |
السرطان العقرب الحوت |
|
الأصفهان )الحسيني – النوى) |
بارد يابس |
التراب |
السوداء |
الثور السنبلة الجدي |
"شجرة الطبوع": وكذلك الأمر بالنسبة لموسيقى المغرب العربي، حيث اتخذت مجموعة الطبوع المذكورة ضمن قصيدة الونشريسي، كقائمة أولية، أساسًا لما صار يعرف بـ "شجرة الطبوع"، اعتمدها فيما بعد وتناولها بالتعديل والتنقيح والإضافة، أهم منظري الموسيقى بالمغرب العربي [ومن بينهم: البوعصامي والوجدي/ الغماد، وأحضري، والحائك، وسيالة، وبن عبد ربه وغيرهم...].
وإذا ما تجاوزنا اختلاف الروايات، يمكن حوصلة هذه الشجرة في أربعة أصول: ذيل - ماية - زيدان – مزموم (انطلاقًا من الأوتار الأربعة للعود المغاربي التقليدي السالف الذكر)، تستخرج منها 21 فرع (مع أصل خامس: الغريبة المحررة، وهو دون فرع). وذلك على النحو التالي:
جدول: في مشاكلة أوتار العود لأركان العناصر الكونية والطبائع البشرية
|
الطبائع البشرية |
العناصر الكونية |
طبع أساسي |
مطلقات |
طبوع فرعية |
|
السوداء |
التراب |
ذيل |
ذيل |
رصد الذيل - رمل الذيل عراق [العرب/العجم - مجنب الذيل – استهلال الذيل]. |
|
الصفراء |
النار |
مزموم |
حسين |
غريبة الحسين [حمدان – مشرقي] |
|
الدم |
الهواء |
ماية |
ماية |
رصد – حسين – رمل [الماية – انقلاب الرمل – صيكة] |
|
البلغم |
الماء |
زيدان |
رمل |
أصبهان – عشاق– حصار - زوركند – حجاز [الكبير / المشرقي] |
|
غريبة المحرّرة |
....... |
وهذه بعض الجداول التوضيحية الإضافية
ارتباط الطبوع بالأبراج والطبائع
|
الطبع |
البرج |
الطبيعة |
|
الطبع |
البرج |
الطبيعة |
|
الذيل |
الحمل |
نارية |
أبو سليك |
الجدي |
ترابية |
|
|
العراق |
الثور |
ترابية |
نوى |
الدلو |
هوائية |
|
|
الأصبهان |
الجوزاء |
هوائية |
عشاق |
الحوت |
مائية |
|
|
زيرفكند |
السرطان |
نارية |
كوشت |
زحل |
ترابية |
|
|
بزروك |
الأسد |
نارية |
نيرز |
المشتري |
نارية |
|
|
زنكولة |
السنبلة |
ترابية |
سلمك |
المريخ |
نارية |
|
|
رهاوي |
الميزان |
هوائية |
شهناز |
الشمس |
نارية |
|
|
حسيني |
العقرب |
مائية |
حصار |
عطارد |
نارية |
|
|
حجازي |
القوس |
نارية |
ماية |
القمر |
هوائية |
تأثيرات الطبوع وتوقيت أدائها (أ)
|
التوقيت |
الطبع / النوبة |
الطابع التأثيري |
|
النهار الفجر الزوال |
عشاق عراق العجم حجاز المشرقي استهلال رصد غريبة الحسين |
الأمل والحياة الخيبة والإحباط اللطف، الحب، الشفقة الحلم، الخيال والوصف به حنين الكرامة والسمو الألم، الحزن والخوف بالمعنى الصوفي |
|
الليل المغرب العشاء نصف الليل |
ماية حجاز الكبير أصبهان رصد الذيل رمل الماية (في هذه النوبة تؤدة نصوص المديح، وفي أي وقت) |
الفراق والحزن الفرح والمرح التعاطف والاستجداء الصبر والاستسلام الحنين، الحب والعشق (بالمعنى الدنيوي والصوفي) |
توقيت أداء الطبوع / النوبات (ب)
|
النهار |
الطبع |
الليل |
الطبع |
|
|
الفجر |
الحسين |
المغرب |
زنكولاه / مزموم |
|
|
الصبح |
الرهاوي |
قبل العشاء |
ذيل |
|
|
الشروق |
الماية |
العشاء |
الرمل |
|
|
الضحاء |
العراق |
نصف الليل |
الصيكة |
|
|
الزوال |
الأصبهان |
بعد نصف الليل |
رصد الذيل |
|
|
بداية الظهر |
المحير |
قبل الفجر |
نوى / ماية |
|
|
بعد الظهر |
أصبعين |
|||
|
العصر |
عُشاق |
***
الوضع المعاصر
وختامًا، يمكننا القول أن المحدثين اليوم في كل من المشرق والمغرب، حسموا مسألة التأثير وذلك بتعريف المقامات والطبوع قياسًا إلى فصائلها في جماعاتها المختلفة النغم، دون الاهتمام بالعلاقة بين الأنغام وبين عناصر البروج والطبائع... هذا علاوة على تقلص عدد المقامات والطبوع والتغييرات التي أدخلت على بعضها تحت وطأة تأثير النظام الموسيقى التونالي الغربي بدعوى التطور ومواكبة العصر!
جداول ولوحات توضيحية إضافية
الشجرة
في المشرق
"دائرة الأنغام: الأصول والفروع المستخرجة من البروج الاثنى عشر"،
مخ. الإنعام في معرفة الأنغام، الصيداوي الدمشقي (تـ حوالي
1505).
"دائرة الأنغام"، مخ. [الإنعام في معرفة الأنغام ] - الصيداوي
الدمشقي (تـ حوالي 1505)
الأصول والفروع والشعب
-
الشجرة ذات الأكمام –
XVII))
الأوزات الستة الناتجة من الأدوار الاثني عشر-
الشجرة ذات
الأكمام – (XVII)
الدائرة العربية عند المحدثين: دائرتان الواحدة (داخلية) ضمن أخرى
(خارجية). تقسيم الديوان إلى 24 ربعًا متساوية، وتفرعه إلى أبراج كبرى
(4 أرباع) وصغرى (3 أرباع) وهي هنا في حدود الديوانين (من اليكاه إلى
جواب النوى / الرمل توتي) مشاقة (1800-1888)
أرجوزة ابن الخطيب الإربلي تـ 755 هـ/ 1354 م حسب رواية جواهر النظام
في معرفة الأنغام (نظمها سنة 729 هـ / 1328 م)
نسخة بتاريخ 1120 هـ / 1708 م، أولها:
الحمد لله على أنعامه حمدا يكافي الفضل في أقسامه
- (البيت 12- 14 في معرفة أصول النغم):
واعلم بأن الرست أصل
الكل عنه تفرعت بحكم العقل
الرست والعراق ثان تابــــــــــع وزروكند وأصبهان رابع
- (البيت 15 – 20: المناسبة بين الأصول والأركان والأخلاط)
- (البيت 21 – 24: ذكر أبحر الأنغام الأصولية الأربعة)
- (البيت 25 – 28: ذكر الأبحر الثمانية المتفرعة عن الأصول الأربعة)
- (البيت 29 – 35: ذكر كيفية ترتيب الأنغام الاثنى عشر)
- (البيت 36 – 43: ذكر الأوازات الستة)
- (البيت 44 – 47: ذكر الشواذ (الشازات) الثلاثة المفرعة عن الأوازات الستة)
- (البيت 48 – 52: ترتيب الأنغام الاثنى عشر كما ذكر الأستاذ صفي الدين عبد المؤمن)
- (البيت 53 – 60: ذكر الأنغام الزوائد)
- (البيت 61 – 66: وصية الأستاذ المصنف)
- (البيت 67 – 72: بيان تأثير الأنغام في الأمزجة من الأخلاق)
- (البيت 73 – 77: بيان الضروب السبعة ووجوب مراعاتها)
- (البيت 78 – 99: وصية للمطرب)
- (البيت 100 – 105: خاتمة الرسالة)
أرجوزة في الأنغام لـ جمال الدين أبي محمد عبد الله المارديني القاهري الشافعي: تـ 884 هـ / 1479 م (مؤرخة سنة 847 هـ / 1443 م). وهي في ثلاثة فصول: الأول 23 بيت / الثاني 25 بيت / الثالث 8 أبيات.
جاء في الفصل الأول، أوله:
الحمد لله الحكيم العالــــــــم مقسم العقول بين
العالــــــــــم
مميز الألسن واللغـــــــــات وواهب الأنغام والأصـــــوات
(بين البيت 7 - 23)
وإنني أذكر أسماء النغــــــــم مختلفا على قوانين
العجـــــــم
أولها راست عراق لا تُعٍــــدْ وأصفهان ثم بُرْدُ
الزرفكـــــــند
فأنتج الراست نتاجـــــــــــا أولا أصلين عُشاق وبرد
الزنكـــــلا
وأنتج العراق ثانـــي هنْـــــــــك ماياه ثم بوسليك
التركـــــــــــي
وما أتى من أصفهان يُذكــر وهو النوا ثم الحسيني الأصغـر
والزيرفكند ذو نتاج مُستوي وهو البُزرك ثم برد
الرّهــــوي
فتمت الأصول اثنى عشرا وما الحجازيّ بأصل قـــــــــررا
ثم لكل اثنتين فرع مركــــــــز فـ الراست والعراق أصل
النــورز
والأصفهان ثم الزيرفكنــــــــــد فرعهما الشهناز إذ
يُحـــــــــــــــد
ثم أواز سلمــــــــــك قد نقــــــــــــــــلا
عن نغم العشاق ثم الزنكــــــــــــــلا
ثم الحجازي لدوي السلوكي أواز ماياه
وبوسليــــــــــــــــــــك
ورُب قوم أثبتوا الحجــــــازي أصلا ما عدوه
فــــــــــــي الأواز
وجعلوا المايا وبوسليكـــــــــــــــا متحدا إذ عدموا
التهنيكــــــــــــا
ولم يعدوا الزراكشي البتـــــه بل أثبتوا الكردانيا في
الستـــــــة
والزركشي فأواز اثنيـــــــــــــــــن
هما النوا وصنْوُه الحسينــــــــي
فللـ بزرك عندهم والرهــــوي من الأوازات الكوشت قــــد
رُوي
فهذه الأصول والفــــــــــــــــــروع
وسوف تــــــــــأتي لا تكن نزوع
منظومة لجميع الألحان: محمد بن أحمد بن النصحان:
- ذكر أسماء الألحان المسماة بحور (1-3)
- ذكر الألحان الاثنى عشر (4-5)
- ذكر أسماء الستة المسماة بالأواز (6-7)
- ذكر الألحان المسماة بالشواذ (8-9)
- ذكر الألحان المسماة بالبحور (10-13) - دوكاه (14-17) – سيكاه (18-21) – جاركاه (22-25)
- ذكر الألحان الاثنى عشر مقدم عراق (26 – 29) – زيرافكند (30-33) – أصفهان (34 – 37) – رهاوي (38 – 41) – حسيني (42-45) – زنكلاه (46-49) – بوسليك (50- 53) – نوى (54 – 57) – عشاق (58 – 61) – بزرك (62 – 65)
- ذكر الألحان الستة المسماة بالأواز نيرز (66-69) - شهناز (70-73) – سلمك (74 – 77) – حجاز (78 – 81) – كوشت (82-85) – زركشي (86-89)
- ذكر اللحان المسماة بالشواذ كردانيا (90-93) - عكبري (94-98)[3]
***
الشجرة
في المغرب
شجرة الطبوع - الحائك (XVIII)
رسالة في معرفة الأنغام – شجرة الطبوع
(من كنش باش مملوك – دار الكتب الوطنية التونسية: عدد 3634)
شجرة الطبوع
مخ الحزانة الملكية الرباط – عدد 650
شجرة الطبوع - التادلي (XIX)
من منظومة الطبوع لـ الشيخ محمد الظريف (تـ. 1385)
حسب رواية الشيخ محمد النيفر (1860 – 1912)
من منظومة الطبوع لـ الشيخ محمد الظريف (تـ. 1385)
حسب الرواية القسنطينية
من منظومة الطبوع لـ الشيخ محمد الظريف (تـ. 1385)
حسب الصادق الرزقي (1874- 1939)
نعورة الطبوع – زجل برول من نوبة النوى
(المالوف التونسي)
موشح – بطايحي نوبة الأصبهان (المالوف التونسي)
من سفينة بن عبد ربه (1886)
منظومة في الطبائع والطبوع للونشريسي (1478 – 1549)
مع إضافة الوجدي (تـ. 1622)
***
الدوائر
دائرة العشاق – جامع الألحان
(عبد القادر ابن غيبي: 1354- 1434)
من كتاب الأدوار لـ صفي الدين الأرموي (1216-1294)
الأدوار لـ صفي الدين
الأرموي (1216-1294)
رسالة في الموسيقى (فارسي)
من كتاب الأدوار لـ صفي الدين الأرموي (1216- 1294)
من كتاب الأدوار لـ صفي الدين الأرموي (1216- 1294)
***
أبعاد وسلالم
تسوية العود التقليدي + السلم الموسيقي (المغرب العربي)
دائرة الأنغام (دائرتان الواحدة ضمن الأخرى مكتوبًا على استدارة كل
منهما أسماء النغمات والأنصاف والأرباع مع تقسيمهما أقسامًا متساوية،
وذلك لتسهيل عملية تصوير الألحان). الخلعي (1881-1938)
دائرة لديوانين، تحتوي على أسماء الدرجات (بردة) الأنصاف (عربة)
والأرباع (نيم للربع الأدنى/تيك للربع الأعلى من النصف درجة) وفق قسمة
الديوان إلى 53 كوما/ أي أرباع غير متساوية. توفيق الصباغ (1892 –
1964)
سلم مقام الراست على النغمات السبعة الأصول، حسب نظرية الأرباع
المتساوية (الأبراج الكبرى = 4 أرباع، والصغرى = 3 أرباع). الخلعي
(1881-1938)
السلم الموسيقي العربي حسب نظرية الأربعة وعشرين ربعًا متساوية.
محمد صلاح الدين
علامات التحويل بحسب الكوما والليما والمجنب الكبير والمجنب الصغير
[شكل مأخوذ من مرجع تركي - فؤاد محفوظ (1900- 1976)]
علامات التحويل بحسب الكومات والليمات صعودًا ونزولاً. فؤاد محفوظ
(1900-1976)
طريقة المؤلف التركي السيد عبد القادر كاشغري في استعمال علامات
التحويل.
عن فؤاد محفوظ (1900- 1976)
*** *** ***
سلم مقــام الحجاز كار كرد بين النظرية والتطبيق*
المقــــدمـــة
يعد المقام العراقي شكلاً غناسيقيًا[1] تراثيًا ثـُبـِّتتْ أسسه وعناصر تكوينه تدريجيًا عبر القرون التي مرَّت، بل عبر آلاف السنين من التاريخ. فهو يمثل التراث الغناسيقي لمدينة بغداد خصوصًا والعراق عمومًا، يتميـَّز ببناء مقامي متعدد الأنغام والسلالم، التي تشكل بمجموعها عائلة فنية لكل مقام من المقامات على حدة، وأصبح لكل منها اسم تعرف به، تعلـَّمها المؤدون تباعًا وتوارثًا عبر الأجيال أبًا عن جد دون تحوير أو تغيير يذكر، إلا ما يقع أحيانًا من قبل مشاهير المغنين وكبارهم من زيادات وإضافات.
إن تاريخ هذه المقامات الغنائية يعود إلى عهود سحيقة في القدم، حيث نشأت منذ أن عاش الإنسان العراقي على هذه الأرض لأول مرة بصورة مستمرة دون انقطاع. فهو تاريخ قديم قدم الحضارات في العراق، وليس ثمة مصدر تاريخي موثوق به أو أي مصدر كان، حتى لو كان غير موثوق به..!، نوه أو ذكر أن هناك انقطاع للحياة على هذه الأرض منذ بدء الحضارات وحتى الآن في العراق، وبذلك يظل المقام العراقي متواصلاً عبر التاريخ ينتقل إلى الأجيال اللاحقة شفاهًا أبًا عن جد، وبصيغ ادائية متطورة باستمرار نسبة لثقافة كل عصر من العصور.
أن هذا النوع الفني من التراث الغناسيقي (المقام العراقي) الذي يستثيره بإلحاح الواقع المحيط وانعكاسات البيئة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.. الخ والواقع الذي نحمله داخل أنفسنا، والذي يتنازعه خلق الخيال والتأملات والأحلام، واستقصاء الواقع، وهو لا يكف عن إنتاج أشكال غناسيقية ثابتة وابتكارات أخرى ممكنة؛ هذا النوع الغناسيقي التراثي – المقام العراقي – هو على صورة المسارات اللحنية التي تدل عليه، أي أنه في تطور وتوسع دائمين.
وهكذا أمسى الإبداع المقامي في- حقبة التحول[2] - وواقعها الثقافي مع ظهور محمد القبانجي، واقعًا ملموسًا ومنحىً حذا حذوه الكثير من المغنين اللاحقين لأستاذهم القبانجي بعد تسجيلاته المقامية التي سجلها منذ العقد الثالث من القرن العشرين. ورغم المحاولات الكثيرة من قبل مغنين مقاميين كثيرين في شأن الإبداع والتطوير خلال القرن العشرين، لكننا نستطيع أن نشخص أبرزهم في هذا الشأن، ونقصدُ بهم الأربعة المبدعون الكبار[3]: حسن خيوكة، يوسف عمر، ناظم الغزالي، وعبدالرحمن العزاوي، الذين حذوا حذو أستاذهم محمد القبانجي ونحوا منحاه التجديدي الإبداعي.
ماهو المقام العراقي؟ وماهو جوهره!؟ اعتقد أن هذا الموضوع من أعقد مواضيع البحث وأصعبها، وربما أسهلها في نفس الوقت، لأنه في الحقيقة لا يوجد أي رأي ثابت أو موحَّد يبيِّن جوهر هذا الموضوع، فقد صاحب تعريف المقـام العراقي اجتهاد شخصي تأثر بمؤثرات متنوعة، لذا رأى البعض أن (تعريف المقام العراقي) يعد موضوعًا معقدًا وصعبًا، بينما رأى البعض الآخر أنه سهل يسير. لا داعٍ للإيغال في فلسفة لا يحتملها هذا التراث العريق.. ولسنا هنا في معرض استعراض تفاصيل وتعاريف تبيِّن ما كتب وما تحدث به النقاد والمتخصصون... بل سنحاول فقط أن نعطي بعض التعاريف لبعض المتخصصين المقاميين في هذا التراث الغنائي.
يقول الحاج هاشم محمد الرجب في كتابه المقام العراقي معرِّفًا إياه بما يلي:
هو مجموعة أنغام منسجمة مع بعضها له ابتداء يسمى بالتحرير أو البدوة وانتهاء يسمى التسليم، وما بين التحرير أو البدوة والتسليم مجموعة من القطع والأوصال والجلسات والميانات والقرارات يرتلها البارع من المغنين دون الخروج على ذلك الانسجام المطبوع[4].
يقول جلال الحنفي:
المقام العراقي هو نمط من الغناء عرف في بغداد وبعض المدن الشمالية ومنها الموصل وكركوك على اختلاف يسير بين مغني هذه المدن في تعاطيه وفي بعض تسمياته وكيان هذا النمط من الغناء يظهر في تجمعات نغمية يتحقق تجمعها وتأليفها وفق قواعد وأسس اصطلح عليها أصحاب هذه الصناعة بحيث تبدو سليمة المنحى وذات محتوى مستساغ وإطار جامع[5].
أما المرحوم شعوبي ابراهيم:
هو مؤلفة غنائية لها قواعد محدودة لانتقال المغني من نغم إلى آخر ليكــون للارتجال الغنائي نصيب فيه[6].
وفي تعريف المرحوم عبد الوهاب بلال نجد أن:
المقامات العراقية هي لون من ألوان الغناء الشعبي العربي في العراق التي ضيفت ألحانها في العراق.. فغناها المطربون البغداديون.. والمقامات العراقية هي عبارة عن مجموعة من الألحان الشعبية المنسجمة، والتي تعددت أنغامها وتنوعت ألوانها مما أصبح له الأثر الكبير في الغناء العراقي. والذي له الصدارة على جميع أنواع الغناء في البلاد. وقد غدت أصولها وقواعدها ثابتة بما يسمى بـ (المقامات العراقية) وهذه المقامات كانت ولا تزال تغنى في العراق[7].
يشير الأديب الموسيقي أسعد محمد علي إلى أن المقام العراقي:
هو فن كلاسيكي له ضوابطه ومقوماته[8].
ويقول الباحث كمال لطيف سالم:
إن أهم ما يميز الغناء عندنا المقام العراقي الأصيل الذي لا يغنيه سوى أهل العراق وإن كانت أنغامه ذات صلة بالأنغام الموجودة في الموسيقى العربية[9].
من ناحية أخرى فإن شكل form المقام العراقي يتكون من عناصر وأسس هيكلية توضح أبعاده الأدائية وتشكل بنفس الوقت عاملاً مشتركًا لكل مقام من المقامات، أي أن هذه العناصر وعددها خمسة حسب اتفاق الأغلبية الساحقة من المؤرخين والمتخصصين في شؤون المقام العراقي، أو ستة حسب راي الحاج هاشم الرجب، حيث يضيف عنصر القرار ضمن عناصر المقام الرئيسية، وهذه العناصر الخمسة موجودة في كل مقام على حدة، وهي:
- التحـــرير: يقصد بهذه المفردة البداية أو الاستهلال لغناء أحد المقامات، ويأتي هذا الاستهلال غالبًا بكلمات أو ألفاظ خارجة عن النص الشعري المغنى مثل أمان.. أمان.. أو ويلاه.. ويلاه.. الخ، ويعتبر التحرير نموذجًا لحنيًا متكاملاً لروحية وتعابير وثيمة[10] المقام المغنى.
- القـِطَعْ والاوصال: ويقصد بهاتين المفردتين اصطلاحًا التنوع السلَّمي أي التحولات السلَّمية أو الأجناس الموسيقية ضمن علاقات لحنية متماسكة والعودة دائمًا إلى سلَّم المقام المغنى (السلَّم الأساس - الميلودي) وهذه التحولات أو القطع ذات أشكال ثابتة ومحدده في مساراتها اللحنية في غالب الأحيان.
- الجلـــسة: وهي النزول إلى الدرجات الموسيقية المنخفضة بأسلوب القرار، ولكن بمسار لحني محدد ذو شكل معين يكاد أن يكون ثابتًا، أي ليس أي نزول أو أي قرار يعني الجلسة بالضرورة، حيث تشير هذه الجلسة للموسيقيين أو توحي للمستمعين أيضًا أنه ستأتي طبقات عالية من الغناء أي الجواب أو أكثر من الجواب مثل فعل ورد الفعل، أي لابد من حدوث هذه الجوابات التي تأتي أيضًا بمسارات لحنية محددة وبشكل معين ليس أي جواب أيضًا. وتسمى هذه الجوابات بـ "الميانة" وهي العنصر الرابع.
- الميـــانة: ويأتي غناؤها بطبقة صوتية عالية بعد الجلسة مباشرة ذات شكل ومسار لحني معين ثابت، على أن هذه الجوابات أو هذه الميانات ليس من الضروري دائمًا أن تسبقها جلسة من حيث هي عنصر من عناصر شكل المقام العراقي، فقد تأتي صيحات غنائية عالية لها مقومات الميانة وأهم هذه المقومات ثبات هذه الصيحة في المقام المغنى دون الحاجة إلى أن تسبقها جلسة، في حين أن النزول إلى الجلسة في العنصر الثالث يجب أن يتبعه ميانة في كل الأحوال، إضافة إلى أن هناك صيحات عالية من الغناء حرة يستسيغها المغني حسب مزاجه الآني لا علاقة لها بموضوع الميانة خلال غنائه للمقام لأنها لا تمتلك مقومات الميانة.
- التســليم: وهو نهاية المقام ويأتي غالبًا بألفاظ أو كلمات غنائية خارج النص الشعري، شأنه في ذلك شأن ما يحدث في العنصر الأول "التحرير"[11].
من هذه الناحية يختلف المقام العراقي عن الأغنية المقصودة أو التي نسميها الأغنية الحديثة، التي تعكس ثقافة الفرد في المجتمع لأنها تجارب محدودة لا تتعدى حدودها الفردية، وفي حيز زمني محدد، سواء أكان شاعرًا للأغنية أو ملحنًا أو مؤديًا لها، فكلهم أفراد معلومون في المجتمع. في حين أن التراث انعكاس لثقافة المجتمع كله وعلى مدى التاريخ وهو ما تعوِّل عليه كل الدراسات الأكاديمية لمعرفة قيمة تراث هذا البلد أو ذاك. فمهما كانت قيمة الفرد الثقافية فإنها تبقى ضمن حدودها التأثيرية الفردية ويبقى المجتمع صاحب كلمة الحسم في أيه دراسة بحثية أكاديمية.
هناك اداءات أخرى، مثل القرارات والجوابات التي لا يعتمدها الباحثون المقاميون ضمن العناصر الرئيسة المكونة للمقام، على أساس أن القرار قد يأتي خلال حرية المؤدي في الارتجال والتصرف منطلقًا من جمالياته ومزاجه الأدائي، وكذلك الشأن مع الجواب. وبتعبير آخر، إن هذه القرارات والجوابات التي نعنيها ليس لها مسارًا لحنيًا ثابتًا معينًا مثل قرار الجلسة وجواب الميانة.
من ناحية أخرى فإن اداءات الشعائر الدينية قد حفظت لنا هذا الموروث من الضياع في فترات انحسار مر بها المقام العراقي عبر تاريخه الطويل، ومن هذه الشعائر مثلاً قراءات التمجيد بذكر الله سبحانه وتعالى والتواشيح في الجوامع وتلاوة القرآن الكريم والمناقب النبوية الشريفة والتهاليل والأذكار وطرقها المختلفة[12].
***
الفصــــــل الأول
منهجية البحث والدراسات السابقة
مشكلة البحث
عندما استمع الإنسان إلى صوته لأول مرة، يعاد ويكرر من خلال ابتكاره العظيم – جهاز التسجيل الصوتي – وهو يودع القرن التاسع عشر ويستقبل القرن العشرين، يكون قد أعلن بذلك عن دخول البشرية منعطفًا عظيمًا جديدًا من تاريخها. الأمر الذي قاد أكثر التحولات والتطورات والتغيرات في حياة الشعوب نحو آفاق اتسمت بالسرعة المتزايدة على الدوام. وهي فعلاً حقبة تحول وانفتاح بكل ما تستطيع احتواؤه هاتان المفردتان من معان وصفات لا حدود لها!
وفي حقبة التحول الواقعة في العقود الأولى من القرن العشرين، انتشرت في بغداد بعض التسجيلات الغنائية لعدد من القوالب forms الغناسيقيه الموجودة ضمن انطولوجيه[13] غناء وموسيقى العراق من شماله حتى جنوبه، بواسطة شركات التسجيل الأجنبية التي كانت تتجول في البلدان لتسجيل تراثها الموسيقي. وفي هذا الخضم برزت تسجيلات المطرب الكبير محمد القبانجي وعلى الأخص منها التسجيلات الصوتية التي سجلتها له شركات انكليزية في بغداد عام 1925 وتسجيلات ألمانيا عام 1928 وتسجيلات مؤتمر الموسيقى العربية الأول في القاهرة عام 1932[14]، الأمر الذي أصبح منعطفًا في تاريخ تطور النواحي الفنية الأدائية وتطور في أساليب العرض فضلاً عن الإنجازات في التجديد والابتكار لمجموعة من المقامات العراقية وأمور أخرى. من هذا المنطلق تشكلت لدى الباحث تساؤلات عديدة منها:
1. هل هناك دور للمطرب محمد القبانجي في تطور وتجديد أداء المقامات العراقية في النصف الأول من القرن العشرين؟
2. هل هناك دراسة تناولت هذا الموضوع بشيء من التفصيل؟
3. هل كان الخروج عن طوق المحلية في تسجيلات محمد القبانجي لأول مرة في غناء وموسيقى العراق سببًا أو جزء من الأسباب التي أدت إلى التطورات التي حصلت بعدئذ حتى هذا اليوم؟
4. هل هناك دراسة أو كتابات نقدية تناولت موضوع ابتكار محمد القبانجي لمقام الحجاز كار كرد أو غيره من المقامات الأخرى؟
5. هل هناك اختلافات علمية فيما بين كتابة سلم مقام الحجاز كار كرد نظريًا وأدائه عمليًا، سواء في العراق أو في البلدان العربية والشرقية؟
6. إذا كان الاختلاف موجودًا بين كتابة سلم مقام الحجاز كار كرد بأبعاده المعروفة بين نغماته نظريًا والأداء العملي لهذا السلم بأبعاد أخرى مختلفة، فما هو السلم المؤدى حقيقة؟
الأمر الذي دعا الباحث إلى بذل الجهود والبحث عمن يجيب عن تساؤلاته، غير أنه لم يعثر على دراسة سابقة منهجية في هذا المجال – لذا فقد تبلورت لدى الباحث القناعة بأن هناك حاجة ماسة لإجراء دراسة علمية عما حدث من تطور في غناء المقام العراقي، وعلى الأخص موضوع سلم مقام الحجاز كار كرد.
أهمية البحث والحاجة إليه
تعد هذه الدراسة رغم إيجازها من الدراسات الرائدة لعدم وجود دراسات سابقة على المستوى المنهجي.
يمكن الإفادة من هذا البحث من قبل المختصين في مجالات الموسيقى والغناء بصورة عامة والمهتمين بالغناء البغدادي بصورة خاصة، فضلاً عن طلبة الدراسات العليا والمؤسسات الفنية والدوائر والكليات والمعاهد والمدارس ذات العلاقة.
الحفاظ على تراثنا الموسيقي والغنائي البغدادي وإلقاء الضوء على أبرز من ساهم في إغناء هذا التراث بالنتاج الغناسيقية.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى الكشف عما حدث من تطور في غناء المقام العراقي والموسيقى العراقية في بغداد ودور المطرب محمد القبانجي من خلال تسجيلاته الغنائية في بغداد 1925 وألمانيا 1928 والقاهرة 1932 عشية انعقاد المؤتمر.. وبالأخص موضوع سلم مقام الحجاز كار كرد..
حدود البحث
الحدود المكانية: مدينة بغداد – كونها تتحدث عن التطور الذي حصـل في غناء المقام العراقي المغنى في بغداد.
الحدود الزمانية: يتحدد البحث بالفترة الزمنية الواقعة في النصف الأول من القرن العشرين.
منهج البحث
لقد اتبع الباحث المنهج التاريخي والعلمي في التحليل النظري والعملي للتوصل إلى تحقيق أهداف بحثه.
تحديد المصطلحات
المقام العراقي: نعني به التراث الغناسيقي في العراق.
المطــرب: مطرب المقام العراقي.
الموسيقـى: موسيقى المقام العراقي.
الغنــاء: غناء المقام.
الدراسات السابقة
فيما يخص الدراسات السابقة ومن خلال تتبع الباحث لدراسته، والتقصي في المكتبات العراقية واستخدام الشبكة المعلوماتية (الانترنيت) لم يحصل الباحث على دراسة أكاديمية ومنهجية علمية تتناول ما حصل من تطور فني في غناء المقام العراقي في النصف الأول من القرن العشرين وعلى الأخص حول سلم ومقام الحجاز كار كرد مع الإشارة إلى دور المطرب محمد القبانجي في هذا التطور.
***
الفصل الثاني
سلم الحجاز كار كرد والمقام العراقي
خلال التاريخ الموغل في القدم للعراق عبر قرون وآلاف السنين من الحضارة العريقة، جسَّد المقام العراقي في أدائه الكثير من السلالم الموسيقية العربية والشرقية مثل الرست والبيات والسيكاه والصبا والنهاوند والحجاز والعجم وفروعها السلمية. وقد خصص الباحث جهوده في هذا البحث حول مقام (الحجاز كار كرد) - وهو من فصيلة الكرد[15] – الذي استحدث له مطرب المقام العراقي الشهير محمد القبانجي أسلوبًا أدائيًا أخضعه إلى شكل form المقام العراقي، إذ وضع له تحريرًا وقطعًا وأوصالاً ثم جلسة وميانة وأخيرًا التسليم. وقد سجله بصوته لأول مرة في ألمانيا عام 1928 (شركة بيضافون) بنص شعري شعبي يسمى في العراق بـ (الزهيري)[16] من نظم محمد الحلي المعروف بـ ابن الخلفة، ضمن أكثر من ستين اسطوانة غنائية له في ألمانيا:
جربتهم ما وفوا بالغانمات امعـــــــــاي
وامعاي خانوا على عهد التخبرة امعاي
الهم لسن كالعقارب لاسعات امعـــــاي
من لسعهن ما يطيب الجرح لو عـــــظن
جربتهم ما شفت واحد طلع عــــــــــظن
مكرود يللي تريد امن المظل عــــــــظن
وبمكرهم ذوبوا شحم الكلاي امعــــاي
ومن المهم ذكره، إن هذا السلم (الكرد) المسمى بـ الحجاز كار كرد كان موجودًا في العراق قبل هذه الفترة بصورة أغان قديمة، وليس شكلاً غنائيًا مقاميًا، حتى ظهور القبانجي الذي جعل من هذا السلم شكلاً غنائيًا مقاميًا.
إن سلم مقام الحجاز كار كرد لم يكن معروفًا في مصر وسوريا ولبنان إلا في سنة 1910 أو ما يقرب من ذلك، في حين أنه كان معروفًا في تركيا كثيرًا[17] بفضل الموسيقار الملا عثمان الموصلي الذي نقل سلمي الحجاز كار كرد والنهاوند إلى تركيا أواخر القرن التاسع عشر، أما أداء سلم الحجاز كار كرد في الغناء والعزف فيكون على طريقتين من حيث درجة استقراره، إذ يسمى (الكرديلي حجاز كار) أو الحجاز كاركرد، عندما تكون درجة استقراره على (الرست do) بعد أن تتم عملية وضع أربعة تحويلات من نوع البيمول عند دليل السلم خافضة للصوت نصف درجة لتتوافق مع أبعاد السلم (انترفالات intervals) الأساسية والتحويلات هي: سي بيمول ومي بيمول ولا بيمول وري بيمول، وفي هذه الحالة تظهر شخصية الأجناس كما يلي[18]:
1. جنس كرد رباعي على درجة الرست do.
2. جنس نهاوند متصل رباعي على درجة الجهاركاه.
3. بعد طنيني فاصل.
انظر الشكل 1
وفي الحالة الثانية يسمى سلم مقام الكرد عندما يكون استقراره على درجة الدوكاه Re مع اثنتين من تحويلات البيمول الخافظة لنصف صوت، وهي الـ سي بيمول والـ مي بيمول للمحافظة على كل أبعاد السلم في الحالتين، وفي هذه الحالة تظهر شخصية الأجناس كما يلي[19]:
1. جنس كرد رباعي على درجة الدوكاه.
2. بعد فاصل طنيني.
3. جنس كرد منفصل رباعي على درجة الحسيني.
انظر الشكل 2
أما بالنسبة إلى سلم مقام الطرزنوين وهو أيضًا من فصيلة الكرد، حيث يستقر على درجة الرست do وتقوم شخصيته على إظهار:
1. جنس كرد رباعي على درجة الرست.
2. جنس حجاز متصل رباعي على درجة الجهاركاه.
3. بعد فاصل طنيني.
مع ملاحظة أن هذا السلم تكتب تحويلاته الأربعة الخافضة (البيمولات) في دليل السلم شأنه في ذلك شأن سلم مقام الكرديلي حجاز كار كما في شكل رقم (1) ولكن يضاف إليه تحويلات أخرى تكتب داخل السلم لتغيير أبعاده والحصول على أجناس أخرى وإظهار شخصية هذه الأجناس، حيث تصبح درجة الـ La بيمول (حصار) المخفضة أصلاً بالدليل، إلى La طبيعية (الحسيني)، وكذلك تخفض درجة النوى Sol نصف درجة لتصبح Sol بيمول (حجاز)، وعند ذاك تظهر شخصية أجناس الكرد والحجاز والبعد الطنيني[20].
انظر الشكل 3
الآن وقد استعرضنا سلالم فصيلة سلم مقام الكرد، حيث كانت أهم ملاحظة فيها هي عدم وجود إبعاد (الأرباع) في أي حالة من حالات تغيير أبعاد السلم، وقد انصب هذا التوضيح فيما مر عن هذه الفصيلة من السلالم، من الناحية النظرية التي يفترض أن تطبق عمليًا من خلال الأداء العملي في الغناء أو العزف، بيد أن الأمر يختلف تمامًا في التطبيق العملي عند العزف أو الغناء بصورة أخص! فعندما كان المطرب العراقي الكبير محمد القبانجي قد استحدث لهذا السلم أسلوبًا أدائيًا مقاميًا عراقيًا كشكل مقامي form تم تسجيله بصوته في ألمانيا عام 1928 لشركة بيضافون، كان قد نحى في ذلك نفس المنحى الأدائي في أداء هذا السلم الذي نحاه المطربون العرب، أو الطريقة العربية في أداء هذا السلم، وذلك عندما يكون الجنس الأول في أدائهم يتنوع بين جنسي الكرد والبيات وفي الجنس الثاني الذي يغلب عليه أبعاد البيات بدلاً من أبعاد الكرد! وفي هذه الحالة يتحول سلم مقام الكرد من سلم خالٍ من أبعاد الأرباع أصلاً وحسب كتابته نظريًا، إلى سلم يتصف بأبعاد الأرباع لتتحول أجناسه من الكرد إلى البيات. وفي هذه الأثناء يمكن أن يستمع السادة المؤتمرون إلى مقاطع من مقام الكرد لمحمد القبانجي ومقاطع من أغنيتين لمحمد عبد الوهاب وهي: خايف اقلو، وأغنية "انت الزمان" بخصوص هذه الملاحظات.
انظر الشكل 3
هناك شيء آخر ربما يقتضي ذكره هو تسمية هذا السلَّم، حيث أن الأتراك يستهلون هذا السلم بالحجاز، وكلمة (كار) هنا تعني بالتركية (عمل) وهي ليست (كار) الفرنسية التي تعني (الربع) كما هي شائعة جدًا في دراسة النظريات الموسيقية العربية والشرقية، ولذلك فالأتراك يقصدون بتسمية سلم مقام الحجاز كار كرد بـ (عمل الحجاز في الكرد) وهو ما يلاءم أداءهم لهذا السلم فعلاً، الذي يتجسد كما يبدو في سلم مقام الطرزنوين (شكل رقم 3) في حين أن العرب لا يستهلون غناء هذا السلم بالحجاز وأبقوه على فصيلته الأصلية – الكرد – كما مدون في شكل رقم (2) نظريًا وعمليًا.
إذن فتسمية هذا السلم بالحجاز كار كرد أو الكردي لي حجاز كار في تركيا منطقية وملائمة لهم نظريًا وعمليًا، وكذلك الأمر بالنسبة للعرب فإن تسمية مقام الكرد أو مقام الكردي لي كسلم، ملائمة لهم في النظرية والتطبيق، ولكن التسمية التركية بقيت خطأ في دراستنا للنظريات الموسيقية حتى اليوم وهذا ما اتفق عليه أعلب الباحثين الموسيقيين[21].
***
الفصل الثالث
محاولة الباحث
منذ أن بدأ الباحث دراسته المنهجية في معهد الدراسات النغمية العراقي في العام الدراسي 1973 – 1974 كطالب رسمي في هذا المعهد، أثارته خلال الدراسة هذه الملاحظات، ومنذ ذلك الوقت اجتهد في البحث عن أسباب هذه الاختلافات خاصة في التطبيق الأدائي لهذا السلم، ويعترف الباحث الآن أنه لا يزال لم يعثر عن الأسباب المقنعة تمامًا لهذه الاختلافات، رغم أنه استمع إلى الكثير من الآراء ووجهات النظر من قبل أساتذة معروفين. والرجوع كذلك إلى مختلف المصادر الكتابية دون أن تتولد القناعة التامة لأسباب هذا الاختلاف، ورغم أن عدم وجود أدلة كافية حتى الآن، فإن الباحث يعتقد أن المنحى الأدائي لهذا السلم لدى المغنين العرب بصورة عامة، هو ليس سلم مقام الكرد تمامًا! وإنما يحدث تنويع، فمرة كما هو في الشكل رقم (4) أي أن درجة الـ مي عند الأداء تتراوح بين مي كار بيمول في الجواب ومي بيمول في القرار كما مدون في دليل السلم. والحالة الثانية هي أن تصبح الـ مي في الجواب والقرار مي كار بيمول لنحصل عند ذلك على سلم مقام المحير الذي يتكون من جنسين منفصلين من البيات بينهما بعد طنيني فاصل، وفي هذه الحالة يسمى سلم مقام المحير، أو محير الحسيني كما يسمى في سوريا[22]. ولكن هذه التساؤلات والاستفهامات تأتي لكون أن الأداء في كل حالات التحويل واختلاف الأبعاد يأتي بأسلوب أداء مقام الكرد أو الحجاز كار كرد، أي أنه يستهل الأداء من الجواب نزولاً إلى القرار، وهكذا الأمر في المقاطع الأدائية حتى نهاية المقام أو اللحن.
بعد محاولات تجريبية من قبل الباحث في أداء سلم مقام الكرد على درجته الأصلية (الـ دوكاه Re) ومواقع نغماته الحقيقية حيث يتضمن درجتي (الـ سي Si بيمول والـ مي Mi بيمول)، ومن ثم التأكيد على جنسي الكرد في القرار والجواب، أي كما مدون نظريًا في شكل رقم (2)، تكللت هذه المحاولات بالنجاح، وقد تم تسجيلها إذاعيًا وتلفزيونيًا من خلال الحفلة التي أقيمت في قاعة الشعب ببغداد يوم 13/6/1977 عشية الاحتفال بتخرج الدورة الأولى لطلبة معهد الدراسات النغمية العراقي برفقة اوركسترا أساتذة وطلبة المعهد. وفي تلك الحفلة، ثبَّت فيها الباحث أدائه لمقام الكرد من ناحية عملية درجتي الـ سي بيمول والـ مي بيمول كأساس علمي، نظري وعملي، لا يفترض الاختلاف فيه وكما مدون في دليل السلم، وفي حوزة الباحث الآن، التسجيل الصوتي لمقام الكرد بصوت الفنان محمد القبانجي الذي سجله عام 1928 في ألمانيا، ومقام الكرد بصوت الباحث الذي تم تسجيله بعد مرور (49) عامًا على استحداثه من قبل الفنان محمد القبانجي، وذلك في حفلة يوم 13/6/1977 كما مر بنا، وقد غنى الباحث الزهيري أدناه في هذه الحفلة وهو من كلمات السيد محمد السيد خليل:
يازين الأوصاف يلغيرك فلا بخاطــري
مفتون بمحاسنك لا تكسر بخاطـــري
حين النظرتك قلت هذا البرى خاطـري
بذات ليش اطلعت يا صاح شنهــو السبب
ذاتك عليْ حالتك لو واشي صايـــر سبب
منك نفع ما شفت غير الاذى والســـبب
والناس لو قدرتك كلها لجل خاطــري
وبكل تواضع يوضح الباحث، أن هذه التجربة الغنائية لمقام الكرد تبدو رائدة في هذا المجال، وهي بالتالي تعديل وتثبيت علمي من أجل تطابق السلم النظري مع أدائه العملي.
***
الفصل الرابع
الاستنتاجات
- إن الفنان محمد القبانجي فنان عصامي تعلم وطوَّر فنه بالفطرة والتجربة والتطبيق.
- الفنان محمد القبانجي يعتبر المثير الأول للإبداعات المقامية الحديثة في العراق... وأفضل مطرب مبدع عرفه العراق في القرن العشرين.
- كانت تسجيلات محمد القبانجي في بغداد عام 1925 وألمانيا عام 1928 والقاهرة عام 1932 منعطفًا مهمًا في تطور الغناء المقامي في العراق لمضمونها الإبداعي وكان منها مقام الكرد.
- كانت تلك التسجيلات رائدة في التمرد على المحلية الصرفة من خلال مطربها محمد القبانجي الذي ادخل مسارات لحنية جديدة متأثرًا بموسيقى البلدان حوله.
- إن موضوع البحث قد يحتاج إلى دراسة مستفيضة لتثبيت وإقرار صحة هذه المحاولة والتجربة، من قبل أحد مؤتمرات المجمع العربي الموسيقي مثلاً، في تخصيص جلسة خاصة بهذا الموضوع.
- يعتبر القبانجي أحد المبتكرين المهمين في تاريخ المقام العراقي وله مقامات عديدة من ابتكاره ومن ضمنها مقام الكرد.
- من الممكن استمرار البحث في هذه الملاحظة والتجربة العلمية والعملية من قبل الباحث للتوصل إلى تسمية مقنعة تمامًا للسلم الذي يغنى من قبل كل المغنين العرب بوجود الأرباع، هل هو فعلاً سلم مقام المحير..؟
التوصيات
في ضوء ما أسفر عنه البحث من استنتاجات يوصي الباحث بضرورة:
1. جمع كل النتاج الغنائي للفنان محمد القبانجي الموجود في الوطن العربي وعلى الأخص اسطواناته التي سجلتها له الشركات الأجنبية في العراق عام 1925 وفي ألمانيا عام 1928 وفي مصر العربية عام 1932 من خلال أرشيف مؤتمر الموسيقى العربية الأول.
2. كذلك التسجيلات الموجودة في بيت البارون دير لنجي الذي أصبح رسميًا مركز الموسيقى العربية في سيدي بوسعيد بتونس للحفاظ عليها من الاندثار والضياع وينطبق ذات الأمر بالنسبة للمغنين المبدعين الآخرين.
3. إنشاء مكتبة خاصة تضم كل ما يتعلق بالمغنين المقاميين المبدعين من تسجيلات صوتية وصور فوتوغرافية أو برامج إذاعية وتلفزيونية وتدوين حياتهم ومذكراتهم، إضافة إلى كل ما نشر عنهم من كتب ودراسات وبحوث ومقالات لتكون في متناول يد الباحثين والدارسين كونهم يعدون من أبرز المغنين المقاميين على مدى العصور.
*** *** ***
المصادر والمراجع
- د. نداء أبو مراد، مدخل إلى تحليل الارتجال العزفي في التقليد الموسيقي العالم المشرقي العربي، البحث الموسيقي، مجلة المجمع العربي الموسيقي، المجلد الخامس– العدد الأول، شتاء وربيع 2006.
- د. محمود محمود، نظرية تكوين السلالم الموسيقية والنظام الموسيقي العربي، البحث الموسيقي، مجلة المجمع العربي الموسيقي، المجلد الثاني – العدد الأول، خريف 2002 – شتاء 2003.
- د. محمود قطاط، راهن الموسيقى العربية في عصر تكنولوجيا المعلومات، البحث الموسيقي، مجلة المجمع العربي الموسيقي، المجلد الثالث – العدد الأول، صيف وخريف 2004.
- د. محمود قطاط، آليات البحث العلمي في المجال الموسيقي - الواقع العربي، البحث الموسيقي، مجلة المجمع العربي الموسيقي، المجلد الرابع – العدد الأول، شتاء وخريف 2005.
- د. محمود قطاط، الموسيقى في سياقاتها الاجتماعية والحضارية، البحث الموسيقي، مجلة المجمع العربي الموسيقي، المجلد الخامس – العدد الأول، شتاء وربيع 2006.
- علي الضو، الموسيقى التراثية: الوجدان العربي وإيقاع العالم، البحث الموسيقي، مجلة المجمع العربي الموسيقي، المجلد الخامس – العدد الأول، شتاء وربيع 2006.
- كمال لطيف سالم، أعلام المقـام العراقي ورواده، مط. النهضة، بغداد، 1985.
- حمودي الوردي، الأغاني القديمة، بغداد.
- د. فكتور سحاب، مؤتمر الموسيقى العربية الأول في القاهرة 1932.
- ي. قوجمان، الموسيقى الفنية المعاصرة في العراق، اكت للتراجم العربية، لندن، 1978.
- د. صبحي أنور رشيد، الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقي، بغداد، 1989.
- حسين اسماعيل الأعظمي، المقام العراقي إلى أين..؟، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2001.
- حسين اسماعيل الأعظمي، المقام العراقي بأصوات النساء، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2005.
- الحاج هاشم محمد الرجب، المقام العراقي، مط. المثنى، بغداد، طبعتي 1961 و1983.
- ثامر العامري، المقام العراقي، بغداد، 1988.
- شعوبي إبراهيم خليل، المقامات، مط. اسعد، بغداد، 1963.
- عبد الكريم العلاف، الموال البغدادي، مط. المعارف، بغداد، 1964.
- ثامر العامري، محمد القبانجي، دار الشؤون الثـقافية العامة، بغداد، 1987.
- سعدي حميد السعدي، محمد القبانجي، بغداد، 2005.
- حمودي الوردي، مقام المخالف، مط. أسعد، بغداد، 1969.
- الحاج هاشم محمد الرجب، من تراث الموسيقى والغناء العراقي، بغداد، 2002.
- كمال لطيف سالم، ناظم الغزالي، بغداد، 1986.
- كاظم جاسم محمد، يوسف عمر، بغداد، 1987.
***
ملاحق البحث
(أ)
جدول بالأسطوانات المسجلة بصوت محمد القبانجي شركة جرامافون (صوت سيدة) الانكليزية لسنة 1925م (علامة الكلب):
1. مقام حكيمي .. مرافجي حين
2. مقام مخالف .. لواحظ الشوق
3. مقام مدمي .. جارن علينة
4. ابوذية .. يا حادي العيس
5. ابوذية .. تشب ناري
6. مقام اوج .. قدحت في مزجها
7. ابوذية .. روى الزيتون
8. اغنية .. لتظن عيني تنام
9. اغنية .. يا حلو يا بو السدارة
10. ابوذية مثكل .. بسويد القلب
11. ابوذية عنيسي .. بعد متفيد حسراتي
12. مقام عريبون عجم .. كه ريمي كائز
13. مقام مثنوي .. حبذا من لماك
14. عتابة سيكاه .. سقوني من سنة
15. مقام ارواح .. ونسوني بعد ما انسوني
16. اغنية .. ذاتك ليش نفارة
17. اغنية .. انا مغرم بالنظارة
18. اغنية .. روحي سلبها نعمان
19. مقام ابراهيمي .. فجر النوى
20. مقام حليلاوي .. اترك هوى من
21. مقام بهيرزاوي .. ما لوم دهري
22. مقام بيات .. وداع دعاني
23. عتابة .. ابات الليل
24. مقام اورفة .. اهل ودي
(ب)
اسطوانات بيضافون كومبني (علامة الغزالة الحمراء) بغداد عام 1925م
1. مقام بيات .. وداع دعاني
2. مقام ناري .. لما سقمني الهوى
3. مقام الطاهر .. قلب المتيم
4. مقام مخالف .. لواحظ الشوق
5. مقام اوشار ..
6. مقام دشتي ..
7. عتابة مصلاوية .. يهل تشتاق
8. عتابة خابورية .. نحو عني
9. مقام عجم عشيران .. سقانيها معتقة
10. مقام شرقي اصفهان .. تجري عليك
11. مقام راشدي .. يا راكبا في مشاحيف
12. مقام قريباش ..
13. مقام مقابل .. مدامعي لم تزل
14. مقام حليلاوي .. اترك هوى من
15. مقام تفليس ..
16. مقام سيكاه بلبان ..
17. مقام اورفة .. اهل ودي
18. مقام عريبون عرب .. بعدك فقدت الهنا
19. مقام صبا .. خليلي دمع العين
20. مقام رست .. شغفت ببدر
21. مقام منصوري .. صح قلبي
22. اغنية .. روحي سلبها نعمان
23. مقام شرقي دوكاه .. يا زين الاوصاف
24. مقام النوى .. ومهفهف كالريم
25. ابوذية .. يا حادي العيس
26. ابوذية لامي .. نحل جسمي
27. عتابة .. سجوني من سنا
28. مقام مخالف كركوك .. نارك بالف صور
29. مقام ابراهيمي .. يا صاحبي قوم
30. اغنية .. ذاتك ليش نفارة
31. اغنية .. قوموا يا ربعي
(ج)
اسطوانات بيضافون كومبني علامة (الغزالة الحمراء) بغداد 1925م
1. مقام حكيمي .. مرافجي حين
2. اغني .. سودنوني هالنصارى
3. اغني .. لتظن عيني تنام
4. مقام سيكاه .. لاتلم مغرما
5. مقام بنجكاه .. ادرها للمدامة
6. مقام حسيني .. جاد الحبيب
7. مقام حجاز ديوان .. بات ساجي الطرف
8. مقام قوريات ..
9. مقام مثنوي .. حبذا من لماك
10. مقام اوج .. قدحت في مزجها
11. مقام محمودي .. يا من جميع المحاسن
12. مقام جبوري .. حنا بحد العرف
13. مقام بهيرزاوي .. ما لوم دهري
14. مقام حديدي .. ايام زهوة ربيع
15. مقام مدمي .. جارن علينة
16. مقام خنبات .. شربنا على ذكر الحبيب
***
ملحق رقم (2)
شركة بيضافون (على الكهرباء) برلين 1928م (علامة الغزالة الذهبية) بصوت القبانجي
1. مقام دشتي .. كم من وضيع
2. أغنية لامي .. تلفت عيوني
3. شعر وابوذية .. حبيبي لا تظن
4. ابوذية لامي .. علامه الدهر
5. مقام قطر .. نار الغضا
6. مقام اورفة .. كف الملام
7. مقام خنبات .. قالوا شربت الاثم
8. مقام منصوري .. اذا زاد بي وجد
9. مقام رست .. لوصال اليك
10. أغنية .. اصلي واصلك بغدادي
11. أغنية .. يا عنيدة
12. أغنية .. دنهض يخامل
13. مقام اوشار .. لا تبكي ليلى
14. أغنية .. بوية ولك بوية
15. مقام كرد .. جربتهم
16. مقام جمال .. واذكروني
17. أغنية .. نعلة على كل بذات
18. شعر مع ابوذية .. واذا اتتك مذمتي
19. أغنية .. جنهم لكو يا ناس غيري
20. أغنية .. يا صاحبي ليش تخون
21. أغنية .. نار بوجنتك لو نور
22. أغنية .. اكعد ينايم للظهر
23. أغنية .. البنية بنت البيت
24. أغنية .. امك سمتك
25. شغل مولود .. يا فريد الملاح
26. شعر مع ابوذية .. نزلنا دوحة
27. مقام بنجكاه .. الاهل للمتيم
28. ابوذية .. نيران الهجر
29. أغنية .. حبي وحكم
30. أغنية .. سفر القبانجي
31. أغنية .. درب الهوى
32. مقام عشاق (اوج) .. دعيني اركب الخطرا
33. أغنية .. راح ولفي
34. مقام حجاز كار .. ادفن غرامي
35. أغنية .. تسالني انت منين
36. مقام سيكاه .. اعد ذكر من اهوى
37. مقام همايون .. طهر فؤادك
38. أغنية .. هيا بنا
39. مقام نهاوند .. من يوم فركاك
40. أغنية .. عيونك سهم قتالة
41. أغنية .. في هواهم يا عذولي
42. أغنية .. اريد الله
43. أغنية .. دوم دوم
44. أغنية .. هيموني هالشبيبة
45. قصيدة .. ودع برلين
46. أغنية .. خايف ولك
47. أغنية .. روحي تلفت بهواها
48. أغنية .. ذبيت روحي اعلا الجرش
49. أغنية .. جبدي ذاب
50. أغنية .. ون يا قلب
51. أغنية اترك يا مجنون الهوى
52. أغنية .. يالله يا جابر
53. أغنية .. انوب اراوي جروح
54. مقام نوريز .. الا فاسقني خمرا
55. أغنية .. ييزي جميل اتحملك
56. أغنية .. بابا جميل اشبدلك
57. أغنية .. طيح يا بوية
58. أغنية .. فراقهم بكاني
59. مقام بهيرزاوي .. دار الملوك
60. قصيدة .. مررت على المروءة
61. أغنية .. يا بنت يا ام الكصيبة
62. أغنية .. يا دشر يالله
63. أغنية .. كل من تلقاه يشكو
***
ملحق رقم (3)
اسطوانات المؤتمر الموسيقي الأول في القاهرة عام 1932
شركة جرامافون(صوت سيدة) علامة الكلب البريطانية بصوت محمد القبانجي والفرقة الموسيقية
(أ)
1. مقام الرست، شعر يا يوسف الحسن
2. أغنية ما دار حسنه بشمر
3. الويل ويلي
4. لتظن عيني تنام
5. مقام منصوري، شعر كيف يقوى
6. مقام الابراهيمي، شعر راحت ليالي الهنا
7. مقام مخالف، شعر مالي ارى الهم
8. أغنية امسلم
9. شعر مع ابوذية، شعر ارى آثارهم
10. مقام بهيرزاوي، شعر من يوم فركاك
11. مقام مدمي، شعر يا صاح ربعي جفوني
12. مقام بنجكاه، شعر طهر فؤادك
13. مقام شرقي دوكاه، شعر يا ناعس الطرف
14. مقام حسيني، شعر طلت يا ليل
(ب)
شركة بيضافون (على الكهرباء)
1. تقاسيم اوج وطاهر وحديدي وسيكاه وحليلاوي وعريبون واورفة، آلة السنطور، العازف يوسف زعرور.
2. تقاسيم عشاق ومحمودي وراشدي وجبوري واوشار، آلة الجوزة، صالح شميل.
3. تقاسيم لامي، آلة العود، عزوري هارون.
4. تقاسيم بنجكاه، آلة القانون، يوسف زعرور.
5. تسعة أوزان، آلة الدف، العازف ابراهيم صالح.
6. آلة الطبلة، يهودا موشي.
*** *** ***
* بحث مصغـَّر كُتب بمناسبة انعقاد مؤتمر المهرجان الشرقي في دورته الأولى بالعاصمة السورية دمشق ما بين 22/2 و28/2/2009.
[1] غناسيقيا.. غنائيًا وموسيقيًا.
[2] حقبة التحول: الحقبة الزمنية الواقعة في العقود الأولى من القرن العشرين عرفت بتحولاتها في شتى مجالات الحياة.
[3] الأربعة الكبار: هم أبرز مغنين مقاميين إبداعيين بعد أستاذهم محمد القبانجي في القرن العشرين، وهم حسن خيوكة (1912-1962) ويوسف عمر (1918-1986) وناظم الغزالي (1921-1963) وعبد الرحمن العزاوي (1928-1983).
[4] الحاج هاشم محمد الرجب، المقام العراقي، ط. 2، بغداد، 1983، ص 64.
[5] جلال الحنفي، لمحات عن المقام العراقي، منشورات المركز الدولي لدراسات الموسيقى التقليدية، بغداد، 1983، ص 3.
[6] شعوبي ابراهيم، دليل الأنغام لطلاب المقام، وزارة الثقافة والإعلام، ط. 2، بغداد، 1985، ص 7.
[7] عبد الوهاب بلال، النغم المبتكر في الموسيقى العراقية والعربية، مط. اسعد، بغداد، 1969.
[8] أسعد محمد علي، مدخل إلى الموسيقى العراقية، وزارة الإعلام، سلسلة الكتب الحديثة، ط. 1، بغداد، 1974، ص 21.
[9] كمال لطيف سالم، أعلام الغناء العراقي ورواده، ط. 1، بغداد، 1985، ص 5.
[10] ثيمة.. فكرة العمل الرئيسية.
[11] د. صبحي أنور رشيد، الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقي، ط. 1، بغداد، 1989، ص 93.
[12] الأذكار: مفردها ذِكِر يجتمع فيه الصوفيون ويقرعون دفوفًا خاصة وترافق هذه الدفوف آلة ايقاعية تسمى الخليلية ويرددون قصائد نظمت باللغة الدارجة في مدح الرسول الأعظم (ص) وقد تشعب هؤلاء إلى عدة طرق منها الطريقة الرفاعية نسبة إلى السيد احمد الرفاعي والطريقة القادرية نسبة إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني والطريقة السهروردية نسبة إلى الشيخ عمر السهروردي والطريقة البدوية نسبة للسيد احمد البدوي والطريقة النقشبندية ومؤسسها الشيخ محمود النقشبندي وقد اخذها من الطريقتنين السهروردية والسرهندية وأصبحت طريقة واحدة سميت باسمه.
ب. التهاليل: مفردها تهليلة وهي أن يقف الصوفيون على شكل دائرة (حلقة) ويذكرون اسماء الله الحسنى بأصوات منسجمة وأوزان خاصة وينبعث من بينهم مؤدي مقام ينشد قصائد لشعراء صوفيين ويتوسط الحلقة رجل مرتد لباسًا خاصًا وهو لباس المولوية يستدير بمكانه بسرعة وهو واقف ويعمل بيديه حركات متنوعة حيث يفرش في الدوران رداءه العريض وسط هذه الحلقة اما الواقفون فهم يوحدون بلفظه دايم الله حي وبلفظه لا اله الا الله حسب اصول متبعة أما رئيس هذه التهليلة فيسمى شيخ الحلقة أو المرشد.
جـ. المناقب: مفردها منقبة وتتلى فيها المدائح النبوية وتتكون من أربعة فصول ويرتلها رجل يسمى (الملا) يجلس قرب البطانة المكونة من ثمانية أو عشرة أشخاص وهم يرددون الأشغال الملحنة حسب المقام الذي ينشده الملا أو مؤدي المقام (خليل، شعوبي ابراهيم، المقامات، وزارة الإرشاد، مط. اسعد، بغداد، 1963، ص 35-36)
[13] الانطولوجية.. تنوع المكونات ضمن المجتمع والجغرافيا الواحدة، والمقصود في هذا البحث، تنوع انعكاسات مختلف بيئات العراق من شماله حتى جنوبه، في موضوع الموسيقى والغناء الحاوي على الموسيقى المدنية والريفية والبدوية والصحراوية والسهلية والجبلية والحديثة، إضافة إلى موسيقى الأديان والقوميات والأقليات الموجودة في كل محيط العراق.
[14] سعدي حميد السعدي، محمد القبانجي، وزارة الثقافة، بغداد، 2006، بين الصفحات من 119 إلى 136.
[15] حبيب ظاهر العباس، نظريات الموسيقى العربية، ط. 1، بغداد، ص 56.
[16] الزهيري: نوع من أنواع الشعر الشعبي العراقي، يتكون من سبعة أشطر، تنتهي الثلاثة الأولى بكلمة هي بمثابة القافية، تتفق في اللفظ وتختلف في معانيها، والأشطر الثلاثة الأخرى هي أيضًا تنتهي بكلمة جديدة تتفق في اللفظ وتختلف في معانيها، والشطر السابع تعود قافيته إلى كلمة الأشطر الثلاثة الأولى وبمعنى مغاير أيضًا.
[17] سليم الحلو، الموسيقى النظرية، بيروت، 1961، ص 117.
[18] حبيب ظاهر العباس، نظريات الموسيقى العربية، ط. 1، بغداد، ص 56.
[19] المصدر السابق.
[20] المصدر السابق.
[21] يقول سليم الحلو في كتابه الموسيقى النظرية منشورات دار مكتبة الحياة (1961)، بيروت، هامش ص 117: (قال أحد الباحثين الأتراك في سبب اطلاق اسم الحجاز كار كرد على هذا المقام، أن المقامات المركبة تكون غالبًا منقولة من مستقرها الأساسي فتصبح والحالة هذه إما مصورة بذاتها على غير طبقتها الاصلية أو يزاد عليها ويضاف أصوات ومسافات غير مسافاتها الأولى فتكتسب صفات جديدة، والمعلوم أن كلمة تصوير عند الأتراك يقال لها (شدّ) ففي حالة انتقال المقام إلى مستقر اخر يطلق عليه كلمة (شدّ) أي تصوير مثل (شدّ عربان) وبدلاً من اطلاقهم على مقام الكردي المنقول هذا (شدّ كردي) أطلق بعضهم (حجاز كار كردي) نظرًا لاستهلالهم هذا المقام بالحجاز كار الذي لازمه مدة من الزمن، ثم تطرق لهذا المقام تعديلاً وتحويرًا ولكن الاسم ظل على ما اطلقوه عليه من البدء. وقال المرحوم اسكندر شلفون (أن تركيب نغمة الحجاز كاركردي من مستحدثات الأتراك هي من النغمات المركبة، والمعروف أن الأتراك نقلوا فيما نقلوه من النغمات، نغمة الكردي التي تستقر على الدوكاه، أما الحجاز كار كردي أو الكرديلي حجاز كار كما أطلق عليها حديثًا، فهذه النغمة قد نقل مستقرها الأتراك أنفسهم إلى درجة الرست، وبهذا الانتقال اكتسبت شخصية جديدة وطابعًا ذاتيًا واسلوبًا خاصًا في الإنشاد الموسيقي يختلف تمام الاختلاف عن طابع وشخصية واسلوب نغمة الكردي الأصلية التي تستقر على درجة الدوكاه). وفي صفحة رقم 112 من نفس الكتاب يقول سليم الحلو: (معنى حجاز كار – لفظ فارسي تركي، مركب من كلمتين – حجاز – بمعنى مقام الحجاز، و- كار – بمعنى صنعة، وبانضمام الكلمتين يكون المعنى (صناعة الحجاز) وتنسب هذه النغمة، أي – الحجاز – إلى أهل الحجاز، ولها عند العرب والفرس والأتراك اعتبار كبير وصفة ممتازة، وهي من أقدم النغمات الشرقية، وترتكز في الأصل على مستقرها وهو مطلق وتر الدوكاه في آلتي العود والكمان، ولكن الأتراك وربما الفرس قبلهم صوروها على درجة الرست فاكتسبت بذلك لونًا خاصًا واتسعت ناطقتها وأصبح سير العمل فيها يختلف قليلاً عن نغمة الحجاز الأصلية).
[22] مجدي العقيلي، السماع عند العرب، الجزء الرابع، ط. 1، ص 168 و172.